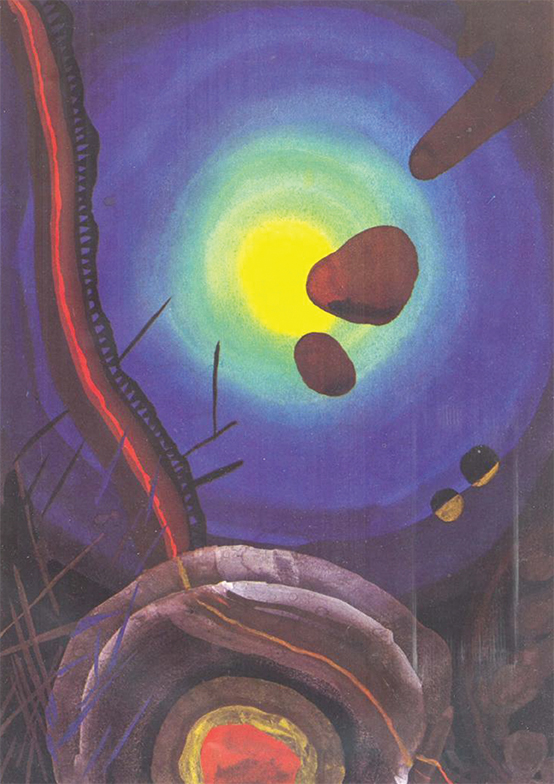تحميل المقال
في عام 1988، فاز الأديب العربيّ الكبير، نجيب محفوظ، بجائزة نوبل للآداب، وكان من بين المشاركين في حفل تسليم الجائزة الكاتب الصيني ليو زايفو (Liu Zaifu)، وهو أوّل كاتب صينيّ تتمّ دعوته لحضور حفل تسليم جائزة نوبل في الأدب، وأعتقد أنه ليس من المناسب أن نتكلّم عن أدب المهجر الصّينيّ المُعاصر دون التطرّق إلى الكاتب ليو زايفو، الّذي يعيش في أمريكا منذ 1998م، ومن البديهي أنّ معظم أعمال هذا الكاتب حاولت تحديد ماهية الوطن؛ فالوطن لديه ليس بُقعة في الخريطة، بل هي بمثابة محيطات الحياة التي لا ضفاف لها، حيث تترعرع كلّ الأفكار، والآراء، والمعتقدات، والمشاعر بحريةٍ مُطلقةٍ، وبكلامٍ آخر، فإنّ الوطن الّذي يتوقُ إليه الكاتب ليو زايفو عبارة عن ملكوت الروح الّذي كان الفيلسوف الصّينيّ تشوانغ تسي (Chuang- ztu)، يُكرس حياته لبلوغهِ، وكان تشوانغ تسي أول فيلسوف صينيّ طرح مسألة “الحرية الرّوحيّة” دون عبوديّة.
في دراستي حول الأدب العربيّ الحديث في أوروبا التي أنهيتها في عام 2020 لاحظتُ أنّ مفهوم الوطن في أدب المهجر العربي الحديث يشبه إلى حدّ كبير مفهوم الوطن عند الكاتب ليو زايفو. وبصرف النظر عن بلد المنشأ للشعراء الذين قمت بدراسة نتاجهم الأدبيّ – من لبنان أم العراق أم سوريّة- فإنّ إشكاليّة الوطن فِي الغربةِ مُتشابهة لديهم في إشكالياتها، فنجد مثلًا الشاعر اللّبنانيّ كرم سرجون يقول في قصيدته المعنونة بـ “غربة الدايم دايم”:
“أريد الموت خارج هذه الأرض، في مكان لستُ ضيفًا عليه [..] لا قبر لي في هذه الأرض، أبني فيه فُلكًا من خشب الهيكل، وآخذ معي من كلّ جنس أنثاه”.
منذ الأزل إلى الأبد، تجري دماء التمرّد في شرايين المثقفين والأدباء المهاجرين، الأمر الذي في غالب الأحيان يجعلهم منشقين أو هرطوقيين مضطرين إلى مغادرة أوطانهم
وهنا نجد أنّ الشّاعر، قد وظفَ -شعريًّا- الرّمز الدّينيّ للنبي نوح فِي “ملحمة الطُّوفان”، فاعتبر نفسه بمثابة الأب المؤسس لعالم جديد يُشكّله وفق خريطته الشعرية ليرسم معالم موطنه الرّوحيّ، الّذي سيعوض -جماليًا- التّشوه الّذي اعترى مَوطنه الواقعيّ المحدد جغرافيًا، والذي تغرَّبَ عنهُ أو غُرِّبَ عنه!
كما نجده كذلك في قصيدته الأخرى “الطّائر الّذي نجا مِن الحرب”، يبيّن لنا مفهومه للوطن على نحو مباشر من خلال قوله:
“هذه الحرب انتهتْ. كلّهم ماتوا. مَدّ طائر عُنقه مِن قفص الكلام وصاح: بلادِي حيث يكون أهلي. لغةً لا حيث تكون أرضٌ”.
منذ الأزل إلى الأبد، تجري دماء التمرّد في شرايين المثقفين والأدباء المهاجرين، الأمر الذي في غالب الأحيان يجعلهم منشقين أو هرطوقيين مضطرين إلى مغادرة أوطانهم. هنا أودّ أن أذكر الشّاعر الصّينيّ “بي داو”، الّذي يُعدّ بمثابة الضمير الشّعريّ للمنشقين الصّينيين في الدّوائر الأدبيّة لأكثر من عشرين عامًا. هذا الشّاعر القادم مِن شمال الصّين يعشق العُزلة عِشقًا جُنونيًا، لذلك اختار لنفسه اِسمًا مُستعارًا أي “بي داو”، والّذي يعني “الجزيرة الشمالية” في اللّغة الصّينيّة. ولا يزال “بي داو” يعيش فِي المنفى، والوطن في رؤيته بمثابة اللغة المحكية لقومه في مسقط رأسه، فيقول في إحدى قصائده: “أنا أتحدّث الصينية في المرآة. الحديقة لها فصل الشتاء الخاص بها. أشغل الموسيقى. لا ذباب في الشتاء. أترك القهوة تغلي على مهل. الذباب لا يفهم ما هو الوطن. أضفتُ القليل من السكر. الوطن هو اللهجة الدارجة. وأنا على الطرف الآخر من خط الهاتف. سمعتُ خوفي”.

فِي تاريخ الشّعر الصّينيّ الحديث هناك شاعر آخر إلى جانب “بي داو”، أولى كذلك اِهتمامًا بالغًا للهجةِ الدّارجةِ فِي مَسقطِ رأسهِ، وهو (Ya Xian)، الشّاعر التّايوانيّ المولود فِي مُقاطعة “خنان” الصّينيّة، عام 1933، وعندما بلغ السّابعة عشر مِن عُمره، لجأ مع الجيش التّابع للحزبِ القوميّ الصّينيّ إلى تايوان لكونهِ عسكريًا ومِن دون أن يعرف أنّ هذا الاِنسحاب العسكريّ هو بمثابة الوداع الأخير لأهله ووطنه. وفي المعسكر في تايوان كان دائمًا يعزف على “إرهو”، وهي آلة موسيقيّة صينيّة تقليديّة ذات خيطين مُقوستين للتغلب ِعلى الحنين إلى الوطن والأهل. وترسّخ صوت إرهو المبحوح في ذاكرة الشّاعر حتّى أطلق على نفسه اسم (Ya Xian) والّذي يعني في الصّينيّة “أوتار مبحوحة”. وحقيقة الأمر، فإنّ “أوتار مبحوحة” خلق لنا أجمل ألحان الغربة، من مثل قوله: “تلك المرأة، وراء ظهرها تهتزّ شوارع فلورنسا، قادمة صوبي مثل تورتريت، إذا قبّلتُ شفتيها، ستلتصق صبغة رافائيل، بشاربي في بلاد الغربة”.
ولو أنك تصفحتَ دواوين الشاعر ستجد بكل سهولة أنّ لغته شعرية فريدة وتستوطن فيها روعة اللهجة الدارجة الخاصة بأهل مقاطعة خنان الصينية.
وعندما يصبح الأدب والثقافة التقليدية وطنًا وهويةً، نجد الشاعر العراقي عدنان صايغ، يقول: “أنا شاعرٌ جوّاب. يدي في جيوبي. ووسادتي الأرصفة. وطني القصيدة. ودموعي تفرس التاريخَ”.
وكذلك نجد الأديب الألماني توماس مان (Thomas Mann)، يزعم: “أنّ ألمانيا هي حيث أقف أنا”. ولا ريب أنّ كلامه هذا كان وما زال يثير صدى في قلوب الكثير من المثقفين في العالم بأسره وبينهم المؤّرخ الصيني الأمريكي الكبير يو ينغشي ( Yu-Ying-shih)، الذي كان يقول: “إنّ الصين هي حيث أقف أنا”. هنا أودّ أن أشير إلى الشّاعر السوري أحمد إسكندر سليمان المقيم في مدينة روستوك، والذي نعت نفسه: “الحبر الضال في أنحاء سوريا”. ونحن نعرف أنه ما زال ينام كل ليلة على شاطئ المتوسط ليستيقظ على شاطئ البلطيق، غير أنّ الوطن عنده، حسب قراءتي المحدودة لأعماله، ليس سورية جغرافيًا بل الثقافة السوريّة القديمة التي أبهرت البشرية كلّها. وتتبلور ملاحظتي هذه في القصيدة التالية: “لأنك فينيقي، لن تجد غير البحار. لن تشعر بغير الهواء، وهو يملأ الأشرعة. بحثًا عن سورية المقدّسة. الوطن الذي لا ظلّ فيه. الوطن الذي لن يصل إليه الرّعاة. وحيث المعنى امتداد، على وجه المياه.”
د. ليو نا
مولودة في مُقاطعة “هوبي” في الصّين عام 1989، وهي أستاذة اللُّغة العربيّة فِي كلية اللُّغات الأجنبيّة في جامعة “صان يات سان” الصّينية. أنهت اللّيسانس في اللّغة الإنجليزيّة في جامعة صان يات سان، واللّغة العربيّة كلغة أجنبيّة ثانية. تابعت دراسة اللّغة العربيّة بجامعة دمشق، وماجستير في اللّغة العربيّة وآدابها في جامعة شنغهاي للدراسات الدوليّة بعنوان “ملامح القوميّة العربيّة فِي شعر نزار قباني”. وعملت أستاذة للغة الصّينية في معهد كونفوشيوس بالدار البيضاء. وحصلتْ على دكتوراة في اللّغة العربيّة وآدابها من جامعة شنغهاي للدراسات الدولية بعنوان “دراسة في أدب المهجر المعاصر في الشّتات: الشّعراء العرب المهاجرون في أوروبا وأعمالهم الشّعريّة أنموذجًا. مُترجمة من العربيّة إلى الصينيّة: ترجمت رواية “ساق البامبو”، وبعض الأعمال الأدبيّة لأمين الرّيحانيّ ونزار قباني مِن اللُّغة العربيّة إلى اللّغة الصّينية بالتعاون مع البروفيسور تساى ويليانغ، رئيس سابق لجمعية دراسة الأدب العربيّ في الصّين، وديوان الشّاعر اللّبناني الألمانيّ سرجون كرم “قصب الصّمت” – تايوان 2020م.