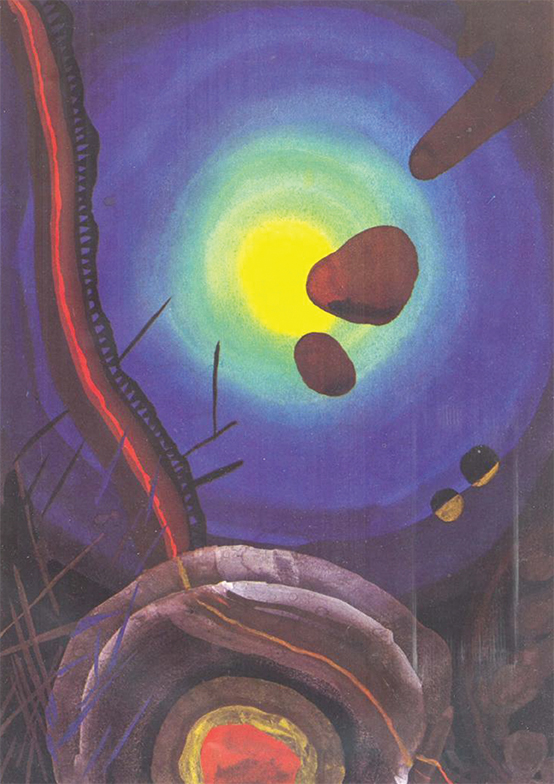مقدّمة: ماذا نفعل في الواقع عندما نقرأ كانط اليوم؟
تحميل المقال
عندما نُعالِجُ فلسفةَ إيمانويل كانط بمناسبةِ حلولِ يوبيل سنويٍّ كعيدِ ميلادِه الثلاثمائة، يتساءلُ المرءُ عمّا إذا كان اهتمامُنا الجوهريُّ تاريخيًّا فلسفيًّا، أو إنْ كنّا معنيِّين باحتياجاتٍ أُخرى، مثل تقويمٍ منهجيٍّ لنتائجَ مُعيَّنةٍ لكانط، أو إعادةِ موضع موقفِه ضمنَ إطارِ تقويمٍ للمخزونِ النّظريِّ الفلسفيِّ ككُلٍّ، مدفوعٍ بدافع ما بعدَ الاستعمار، على سبيلِ المثال. إنّ تاريخَ الفلسفةِ، على حدِّ علمِ فيلهلم فيندلباند، هو دائمًا مزيجٌ من العملِ “التاريخيّ–الفيلولوجيّ” و”الفلسفيّ–النّقديّ” (Windelband 13 وما يليها).
لكن كيف وُزّعت الأثقالُ هنا؟ ألا يكفي ربّما –لا سيما في ضوءِ تنوّعِ عمليّةِ إعادةِ وتفكيكِ الفلسفةِ المتوافِرَيْن – أن يُقصرَ على تحديثِ مواقفَ فلسفيّةٍ معيّنةٍ لكانط؟ ألا يتناسبُ هذا، ولو بشكلٍ جيّد، مع رؤيةِ فيندلباند، طالما أنّه أراد أن يُفهَمَ بالدرجةِ الأولى، تحت عنوانِ “العملِ الفلسفيّ – النّقديّ”، إلى جانبِ العواملِ الشكليّةِ المنطقيّةِ، وقبلَ كلّ شيء، خُصوبة النظريّةِ المستوعَبَة، كما أراد إدراكَ التخلّي عن الأمورِ غيرِ المهمّةِ فلسفيًّا؟ لكن مَن يُحدّدُ ذلك؟ من الواضح أنّ مجرّدَ الإشارةِ إلى العملِ الفيلولوجيّ المتين (أي عمليّة إعادةِ بناءِ النّصّ بشكلٍ مُقنِع) لا يَحلُّ مشكلةَ الاستيعابِ التأويليّ للموضوع، بل يقومُ فقط بتأجيلِها، كما أشار ينس آيسفيلدت بإيجازٍ قبلَ بضعِ سنوات: “إنّ الهدفَ من تحديثِ التحليلِ الفلسفيّ التاريخيّ يحدّده المفسّر الذي يمكن أن تُؤثّرَ مواقِفُهُ الفلسفيّةُ الأساسيّة، عبر تلقٍّ انتقائيّ للتقليدِ الثقافيّ، دون أيّ عائقٍ على نتائجِ الفحصِ التاريخيّ. لذلك لا ينبغي – أو على الأقلّ ليس من السّهل – فَهمُ الأدبيّاتِ الفلسفيّةِ التاريخيّةِ التقليديّةِ باعتبارها مصدرًا تحليليًّا موثوقًا به تاريخيًّا”. (Eisfeldt 2021, 348).
والتأمّلِ به، والإجراءُ الفيلولوجيّ التاريخيّ المتين، لا يُوفّران خلفيّةً موضوعيّةً يمكنُ إسقاطُ التفسيراتِ عليها. بل على العكسِ من ذلك، فهما يُؤدّيان، وبشكلٍ لا مَناصَ منه، إلى تحديثاتٍ مشوبةٍ بالتفسيرِ للمحتوى المُتلقّى، إنْ لم يكونا قد قاما بذلك بالفعل منذ البداية (على سبيلِ المثال، في اختيارِ الوصولِ إلى الموضوع)، إمّا عن وعيٍ أو عن غير وعي. ربّما يكونُ ذلك ابتذالًا، ولكنْ من الأفضلِ أخذُ الأمرِ بعينِ الاعتبارِ مرّةً أخرى. وما سأعرضُه فيما يلي يخضعُ بطبيعةِ الحالِ لهذا التحفّظِ على وجهِ التحديد. لا يَعدو الأمرُ مجرّدَ إشارةٍ صغيرةٍ إلى بعضِ جوانبِ تأمّلاتِ كانط حولَ الحربِ والسلامِ، وموقعِها في نظرتِه إلى التاريخ، بقدرِ ما يجب أن تُفهَم أو تُكتَب فلسفيًّا، بحيثُ يَنصبّ التركيزُ بالطبع على الفكرةِ الضامنةِ التي تصوغها الإضافةُ الأولى.
ولعلّه من الصعبِ عليّ اليوم، وهنا بالتحديد، تجنّبُ تكرارِ البدهيّات، ولكن آملُ أن أتمكّنَ من تعويضِ ذلك عليكم من خلالِ المناقشةِ التي سأُقدّمها في النهاية.
فلسفة التَّاريخ
إنّ تاريخَ العالمِ هو تقدُّمٌ في وعيِ الحُرّيّة، تقدُّمٌ يجب أن نُدرِكه في ضرورته. “هذه هي مقولةُ هيغل في مقدّمة فلسفة التاريخ (MM 12, 32). كما يقول أوتفريد هوفه (Höffe, KA 46, IX)، فإنّ كانط لم يقم “بنقد العقلِ التاريخيّ”، لكنّ تفكيره التاريخيّ الفلسفيّ هو أيضًا تفكيرٌ في “تاريخِ التقدُّمِ للحريّة” (المرجع نفسه 16) .فعندما يتعلّق الأمرُ بتوضيحِ علاقةِ التاريخِ والحربِ والسلامِ بالطبيعة، فيجبُ إلقاءُ نظرةٍ على الجزءِ الأوّل من فكرةِ التاريخِ العامّ بنيّةِ المواطنةِ العالميّة، قبل الانتقالِ إلى الجزء الأوّل من ملحق مخطوطة السلام. لذا فإنّ الجملتينِ الأُوليَينِ الأساسيّتَينِ من الفكرة تضُمّان فعلًا أفقًا مفتوحًا على التاريخِ باعتباره غائيّةَ الطبيعة، أي مبدأً تنظيميًّا (تطوّر الميولِ الفرديّةِ والجنسيّةِ للإنسان) بعد ذلك، يُقال إنّ الطبيعةَ أرادت أن يُخرِجَ الإنسانُ “من ذاته” كلَّ ما يُميّزُه ككائنٍ غيرِ محدّدٍ وغيرِ مختلف، بحيثُ تتحقّقُ السعادةُ والكمال، إذا ما وصَل إليهما، “بواسطةِ عقلِه الخاصّ” (AA VIII, 19).ولا يعودُ هذا الأمرُ إلى موقفٍ أساسيٍّ خيريّ، بل إنّ تناحُرَ البشرِ في المجتمع (الجمعيّة غير الاجتماعيّة، راجع: نفسه 20) هو الذي يدفعُه إلى ذلك. إنّ “الألفةَ الأخلاقيّة (Jane Kneller KA 46,61) الواجبَ تحقيقُها في “المجتمعِ المدنيّ الذي يُديرُ القانونَ بشكلٍ عام”، ليست نهايةَ كلِّ شيء، بل تُشير فقط إلى التناحرِ بين الدول، الموصوفِ بغيرِ الاجتماعيّ والمتناقضِ داخليًّا، ومن ثم فإنّ تحقيقَها يعتمدُ على تنظيمِ هذا التناقض، وهو ما يفتحُ المجالَ الذي تغلغلت فيه مخطوطةُ السلام بعد ذلك.
مخطوطةُ السلام، الإضافةُ الأولى: الطبيعة، الحرب، السلام. ما الضمانة؟ ولأي شيء؟
تبدأ الإضافةُ الأولى بمقطعٍ طويل، مُرفَقٍ بملاحظةٍ أطول، تهدفُ إلى توضيحِ أنّ “الفنّانةَ العظيمةَ الطبيعة (ZeF 72) تخلقُ لدى البشر الائتلافَ من الشقاق، وهذا ما يُسمّى بالقدرِ أو العنايةِ الربّانيّة (انظر: المصدر السابق نفسه)، ولكنّه في الواقع يُصوّرُ نوعًا من الحكمةِ لا نُدركها أو نستنتجُها، ولكن “يمكنُنا ويجبُ علينا” (المرجع السابق) التأمّلُ فيها في “مؤسّساتِ الطبيعةِ الفنيّة (ZeF 73) .
من خلالِ متابعةِ مصالحِهم الذاتيّةِ الأنانيّة، يُحقّقُ البشرُ ضبطًا لتلك العلاقات التي تُمكّنهم من تجنّبِ العواقبِ الكارثيّةِ لتلك الصراعاتِ المصلحيّة، أو الهربِ منها (سواء أكانت داخليّةً، أم داخلَ المجتمعات، أو فيما بينها). إنّ المسألةَ ليست فقط عن إمكانيّةِ السلامِ الدائم، بل عن واقعِه الموضوعيّ، وهي مسألةٌ محوريّةٌ بالنسبةِ لكانط، لدرجة أنّه خصّص لها الإضافةَ الأولى من أجلِ إعطاءِ مساحةٍ مناسبةٍ لفكرةِ الضمانةِ للسلامِ الدائم: “من خلالِ الآليّةِ في الميولِ البشريّةِ نفسها”، كما يقول كانط، ينبغي ضمانُ ما لا يمكنُ التنبّؤُ به من الناحيةِ النظريّة، ولكنّه قابلٌ للتحقيقِ من الناحيةِ العمليّة – وينبغي إظهارُ أنّه من واجبِنا “العمل من أجلِ هذا الهدف” (ZeF 81).
أمّا عن مدى تحقيقِ ذلك فيمكن أن يكونَ ذلك سؤالنا هنا أيضًا. يُميّز بيير لابيرج، في تعليقه على الإضافةِ الأولى، بين الضمانةِ بمعناها الأوسعِ وبمعناها الدقيقِ جدًّا؛ فهو يُفرّقُ بين ما تضمنُه الطبيعة، وبين كيفيّةِ حدوثِ ذلك. في النهاية يتعلّق الأمر بـ (ماذا): بوصفِ شروطِ تطبيقِ العدالة – السَّكنِ على كاملِ سطحِ الأرض (المحدود)، والانتشارِ نتيجةَ الصراعاتِ العسكريّة، والحاجةِ إلى تنظيمِ الصراعاتِ الأساسيّة التي يُنظَر فيها تحتَ خانةِ القانونِ الدستوريّ، والقانونِ الدوليّ العامّ، وقانونِ المواطنةِ العالميّة. يحاولُ لابيرج جعلَ هدف الطبيعةِ في انتشارِ البشرِ على كاملِ الكرةِ الأرضيّة أمرًا معقولًا وصحيحًا، إذ يُشيرُ إلى أنّه في حالةِ عدمِ وجودِ هذا الافتراض، يبقى الاحتمالُ قائمًا فيما يتعلّقُ بتجنّبِ المواجهة، ومن ثم تجنّب العَداءِ على جميعِ المستويات، وهو الأمرُ الذي يجعلُ التقدُّمَ نحو السلامِ الدائم في النهايةِ مستحيلًا (Laberge, KA 1, 109–113). إنّ مسألةَ ما إذا كان، أو إلى أيِّ مدى، يمكن أن يكونَ حديثُ كانط عن أنّ الحربَ نفسها “لا تحتاجُ إلى دافعٍ خاص” (ZeF 77)، لأنّ “الطبيعةَ البشريّةَ مُطعَّمةٌ بها” (المصدر نفسه)، تبقى بالطبع أمرًا مفتوحًا بالنسبةِ لنا خارجَ وظيفتِها في السياقِ المدروسِ هنا.
وبالمعنى الدقيق للكلمة “كيف” تحدثُ ضمانةُ الطبيعة، وفقًا للابيرج، من خلال استخدامها وسائلَ عدّة، نابعة كلها من تنوّعِ الوجودِ البشريّ، وتسعى إلى تحقيقِ ثلاثةِ أهدافٍ رئيسة:
1. ينبغي أن تُؤدّي إلى إنشاءِ دستورٍ جمهوريّ (قانون دستوريّ).
2. واتحادٍ فيدراليٍّ من الدول الحرّة (قانون دوليّ).
3. وأخيرًا إلى قانون مواطنةٍ عالميّ. الوسيلةُ الأولى –ومن غيرِ المستغرَب – هي الحرب، سواء أكانت داخليّةً أم خارجيّة. يكفي (بالنسبةِ للهدفِ الأوّل) افتراضُ وجودِ دافعٍ عقلانيٍّ أنانيٍّ لإنشاءِ مجتمعٍ جمهوريّ، من أجلِ حمايةِ الداخل، وحماية نفسه من الدولِ الأخرى (حجّة شعبٍ من الشياطين؛ انظر ZeF 78 وما بعدها). من ثمّ يُعدّد كانط (بالنسبةِ للهدفِ الثاني) “تنوّعَ اللغاتِ والأديان” (المرجع نفسه 80 وما بعدها) الذي يحمل في طيّاته إلى جانب “الكراهيةِ المتبادلةِ وذريعةِ الحرب” (المرجع نفسه)، وبـ”زيادةٍ للثقافة” والتقارُبِ المستمرِّ بين البشر، إمكانيةَ “توافُقٍ أكبر في المبادئ، للتفاهمِ في سلام” (المرجع نفسه، 81)، لا يكون استبداديًّا. وأخيرًا (بالنسبةِ للهدف الثالث)، تُعزِّز روحُ التجارة المصالحَ الفرديّةَ المتباينة من جهة، غير أنّها من جهةٍ أخرى “لا يمكن أن تتعايشَ مع الحرب” (المرجع نفسه، 83).
ولأنّ الإضافة الأولى هنا لا تقول الكثير، يقوم لابيرج فيما يلي ببذل بعض الجهود، من خلال الرجوع إلى كتابات كانط الأخرى في فلسفة التاريخ، لتوضيح كيف تُعزّز الحربُ الخارجيّةُ جعلَ الدولة جمهوريّةً، وبأيّ ثمن يكون ذلك. ويبدو لي مهمًّا هنا أنّ لابيرج يشير إلى أسئلة مفتوحة من المفترض أن تثير اهتمامنا في يومنا هذا: كيف يمكن فهم إشارة كانط إلى تنوّع اللغات والأديان في سِياق وظيفتها (إذا جاز التعبير) خلال عمليّة التقدّم في تحقيق الحرية؟ ما هي السياقات المطلوبة؟ يُشير لابيرج هنا إلى تأمّلات روسو حول أصل تنوّع اللُّغات لفهم هذا الخطاب في بُعدَيهِ (الكراهيّة والحرب/ التقارب والتناغم في المبادئ)؟ وكذلك، بالبقاء مع روسو، هل يمكن طرح السؤال بشكل متواصل: ما إذا كانت اعتبارات فلسفيّة تاريخيّة أو اجتماعيّة مفيدة أيضًا لموضوع “روح التجارة” و”سلطة المال” (انظر81) التي ستساعد في إقامة علاقة بالتنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة للبشرية، كما نجد ذلك في مقالة “الاقتصاد السياسيّ”؟
كذلك يفعل أوتفريد هوفيه في ختام مقالته عن الإضافة الأولى تحت عنوان “الوضع المعرفيّ”، إذ يتناول مسألة مدى متانة (وأودّ أن أضيف، مدى الاستدامة المستقبليّة) تأمّلات كانط في ما يتعلّق بضمان السلام الدائم (انظر KA 46, 172f). وفي ذلك يشير هوفيه بحقّ إلى أنّ “آليّة الميول البشريّة” التي وصفها كانط لا ينبغي أن يُساء فهمها على أنّها علاقة سببيّة صعبة. لقد طرحت في البداية السؤال حول ما تعنيه الإشارة إلى أنّ الأمر كافٍ عمليًّا للعمل بشكل مشروع نحو هدف السلام الدائم، غير أنّه ذو قيمة (أي قابل للحمل والانتقال، بدلًا من الاعتماد على مرجعيّة واعدة بالأمان).
وهنا تشير إجابة هوفيه الموجّهة نحو حلّ المشاكل إلى وجود توتّر دائم بين الإنسان كموضوع للتاريخ (أي كونه ينتمي إلى مملكة الحريّة) وبين كونه موضوعًا له، طالما أنه، باعتباره كائنًا طبيعيًّا يظلّ خاضعًا لميوله الأنانيّة: وهذا الأمر هو الافتراض الأساسيّ الذي دفعنا دفعًا إلى السلام الدائم عبر التناحريّة والحرب في التاريخ، وألزمنا على التصرّف المناسب (انظر المرجع نفسه).
حتى وإن لم يكن هذا الأمر مقنعًا تمامًا في النهاية، وحتّى وإن لم يكن “التفسير” والوظيفة التي ينسبهما كانط إلى الحرب كافيتين بالنسبة لنا اليوم (كما هو حال عديد من الأمور المصوغة فلسفيًّا عن التاريخ)، وإن بدا تفاؤله الفلسفيّ التاريخيّ (إذا جاز التعبير) أكثر هشاشة في بداية القرن الحادي والعشرين مقارنة بنهاية القرن الثامن عشر، يبقى محتملًا أنّ الأمر بالكاد سينجح من دون الفائض الفلسفيّ التاريخيّ الذي يؤطّر التحليلات السياسيّة والتاريخيّة للصراعات العالمية مع بعضها وبعضها ضدّ بعض، ولا يعبّر عن شيء أكثر من مجرّد “أمل” فقط، سواء أكانت تأمّلات كانط تساعدنا في ذلك أم لا.
خاتمة: ما الذي نفعله في الواقع اليوم عندما نقرأ كانط؟
ربما يمكن القول في الختام، بشكل عام: إنّنا نتطلّع، وبدراية تاريخيّة فلسفيّة، إلى إسهامات محتملة في مسائل ومناقشات حاليّة، والجيد في الأمر أن كميّة الأعمال التاريخية الفلسفية وتنوّعها، حول جميع أجزاء نظرية كانط، تُمكّننا من القيام بتفسيراتنا على أساس آمن. لقد أوردتُ فقط قراءتين مختلفتين للضمانة ردًّا على سؤالي الصغير، يُفهم كلّ منهما على طريقته، الحجّة الكانطية على أنّها إما إشكاليّة ولكن قابلة للدعم (هكذا أقرأ لابيرج)، أو غير متعارضة (قراءة هوفيه)، ومن ثم تبقى قيد العمل والتنفيذ، وهذا هو بالضبط في رأيي ما يجب أن يكون الأمر عليه اليوم عندما نعتمد على المواقف التاريخيّة للفلسفة، ليس من أجل التطبيق البسيط أو النقل إلى أوضاعنا العالميّة أو النقاشيّة، بل (حسب معنى فيندلباند) لتحديد ممّ تتكوّن الخصوبة الفكرية للنظريّة المتلقّاة، وما يجب رفضه منها. يجب أن يكون واضحًا لنا دائمًا أنّ هذا التوضيح هو مسألة اهتمامنا المختلف (من جميع النواحي الممكنة)، ومن ثم فهو تعبير عن مناهجنا ومخارج تفاهماتنا المتنوّعة والمختلفة، وذلك لكي نتمكّن في النهاية من توضيح أمر ما يجب تلقّيه وما يجب رفضه في التفسير. ويتعيّن علينا أن نكون مستعدين في النهاية للتفاهم حول ما نراه مثمرًا فكريًّا، وعلينا الدفاع عن هذه الرؤية التي نأمل أن نكون قد توصّلنا إليها.
الدكتور أولريش فوجل
مواليد عام 1963م، درس الفلسفة والعلوم السياسية وعلم الاجتماع في ماربورغ. في عام 1992 حصل على درجة الدكتوراه بأطروحة حول فلسفة شيلينج المبكرة. حتى عام 2004 كان محررًا مشاركًا لطبعة ثنائية اللغة (الألمانية- الروسية) لكتابات مختارة لإيمانويل كانط. منذ عام 2004 كان مسؤولًا عن تصور وتنفيذ المكونات التعليمية لمواد تدريس الأخلاق والفلسفة في برنامج درجة التدريس في المدارس الثانوية. ونشر الدكتور فوجل منشورات عن كانط والمثالية الألمانية، إضافة إلى الأسئلة التعليمية، خاصة فيما يتعلق بالتفاعل بين موضوعات الأخلاق والفلسفة والدين.