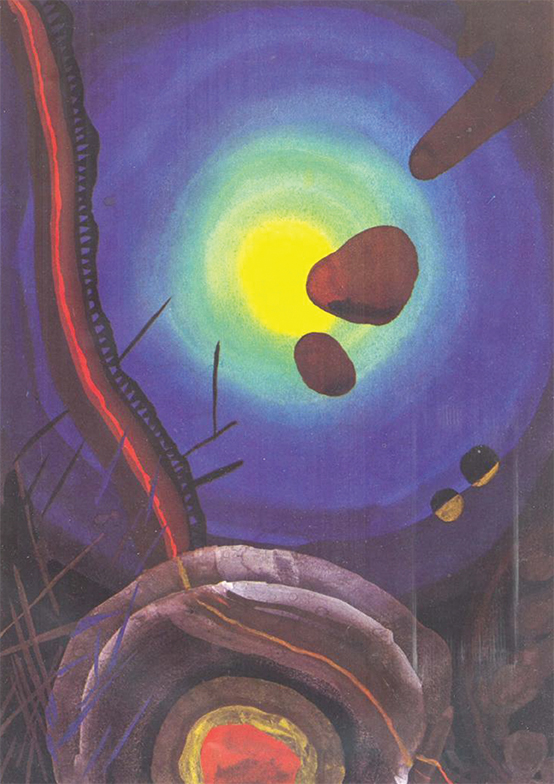ما الذي يدفع اليوم المشتغل بالفلسفة والعلوم الإنسانية في العالم العربي إلى الاهتمام بفيلسوف ألمانيّ من القرن الثامن عشر؟ ما الذي يدعونا إلى قراءة الأسئلة المُلحّة لمجتمعاتنا العربية انطلاقًا من الفلسفة العمليّة الكانطية ومن خلالها؟ أو باختصار: ما الذي يجعل كانط راهنًا اليوم، وذلك ليس فقط في سياق أوروبيّ تنتشر فيه الشعبوية والعنصرية، ويتهدد مصيره اليمين المتطرّف، ولكن أيضًا بالنسبة لسياق عربي حكمته وتحكمه أيديولوجيات معادية للحداثة والكوسموبوليتية، وقيم التنوير؟ إن هذه الأسئلة تفترض قراءةً معيّنة للإرث الفلسفي الكانطي، تربطه بسؤال الراهن. وهي قراءة لها ما يبرّرها لدى كانط نفسه، كما يشرح ذلك ميشيل فوكو في قراءته لنص كانط الشهير: “جواب على السؤال: ما التّنوير؟”.
يكتب فوكو بأنّ السؤال الذي يظهر لأوّل مرة في نص كانط، هو سؤال الحاضر1. طبعًا يمكننا أن نعترض على فوكو بسهولة، ونحن نوضح مع الكثير من شُرّاح كانط بأن الهمّ العملي كان حاضرًا لدى كانط حتى في فلسفته النظرية، وأن العقل العملي يمتلك الأولوية في فلسفته. بل إن كانط، وكما يؤكد أوتفريد هوفه، “يهب نقد العقل قيمةً تتجاوز المجال الأكاديميّ، إنها قيمة عمومية”2، وقد لا نبالغ إذا قرأنا فلسفة كانط باعتبارها كتابًا في التربية، ولا سيما إذا استحضرنا تأثير روسو عليه، وحتى نستعمل عبارة هيدغرية، باعتبارها “تربية على التفكير”.
يُعبّر كانط عن ذلك بشكل أوضح في مقالته عن التنوير، وأعني بذلك الانتماء الفلسفي إلى الحاضر، أو ضرورة ربط التفكير بالحاضر، أو فهم الفلسفة باعتبارها “أشكلة للراهن”3 وما يمثله ذلك، في لغة فوكو، من “تساؤل جديد حول الحداثة” ومن ممارسة جديدة للفلسفة، هي تلك التي تتساءل فيها الفلسفة عن راهنها ويؤرخ فوكو لولادتها بنهايات القرن الثامن عشر، وستعبّر عن نفسها منذ هيغل، وحتى مدرسة فرانكفورت، مرورًا بنيتشه وماكس فيبر، ولا أعرف لماذا ينسى فوكو ذكر ماركس في هذا السياق، وهو الاتجاه الذي يربط به فوكو فلسفته أيضًا.
يرى فوكو بأن كانط قد أسّس للتقليدين النقديين الكبيرين اللذين يُحدّدان الممارسة الفلسفية في القرن العشرين. التقليدُ الأول يبحث شروط إمكان المعرفة الحقة، وهو ما يصطلح عليه فوكو “تحليل الحقيقة” Analytique de la verité، أما التقليد الثاني أو “النموذج الثاني للتساؤل” الذي يؤسّسُ له كانط حسب فوكو في نصه حول التنوير، فهو ذلك الذي يرتبط بالراهن، أو ما يسميه فوكو بـ “أنطولوجيا الحاضر”4 Ontologie du présent. إن النصّ الذي أقدّمه هنا يندرج في سياق التقليد الثاني، وهو يرتبط بحاضرٍ محدد: العالمُ العربي اليوم، ولا يعود إلى كانط إلا من خلال هذا الحاضر، ومن داخل أسئلته، لأن سؤال التنوير الذي اعتقدنا، لزمن بأنه سؤال يرتبط بالقرن الثامن عشر، يظهر لنا اليوم، بأنه سؤال يطرح نفسه داخل الحداثة، في أيّ مرة يتم التراجعُ فيها عن القيم الحديثة، سواءٌ من خلال “نوستالجيا ما قبل حديثة”، كما هو الحال في السياق العربي – الإسلامي، أو “تشكُّكيّة ما بعد حداثية” كما نعرفها من خلال السياق الغربي5.
إن التربية الكوسموبوليتية تتناقض مع التربية السلطية التي تنتج و تعيد إنتاج البُنى والعلاقات الاجتماعية و السياسية السائدة.
الأطروحة الأولى:
إن أزمة عالمنا المعاصر هي أزمة تربوية. تُؤكّد العلوم الاجتماعية العربية، وبمختلف مناهجها وتخصصاتها، بأن المجتمعات العربية المعاصرة تعاني من أزمة تربوية كبرى، وتجد هذه الأزمة تعبيرات مختلفة عنها، وفي كل المجالات، ويعبر عنها المؤرخ والمفكر عبد الله العروي بمفهوم التأخّر الثقافي. إنه -كما يكتب- تأخّرٌ عن الالتحاق “بالعصر الليبرالي كما تطور في النصف الثاني من القرن الثامن عشر وازدهر في القرن التاسع عشر”6، مُعتبرًا بأن الثقافة العربية تتعارض نقطةً بنقطة تقريبًا مع الثقافة الليبرالية.
يُلخّص العروي المشكلة العربية فيما يسميه “الازدواجية” التي تمثل في رأيه “واقعًا” و“سياسة”. حتى إنه يتحدث عن “سياسة تربوية” تتمثل في “تعميق الازدواجية” باستمرار، لأهدافٍ سياسية. وهي تهدفُ إلى الحفاظ على النظام السياسي ونخبته.7 أما الأنثروبولجيا السياسية لعبد الله حمودي، فإنها توضح كيف أن خُطاطة “الشيخ والمريد”، كشكلٍ صوفيّ للتربية والتلقين، ستمتد إلى ما وراء البنى الصوفية، وتظل أسلوبَ عملٍ لعلاقات السلطة والمؤسسات السياسية في السياق العربي.
إن السؤال الرئيس في عمله الأنثروبولوجي هو: “كيف يمكننا تفسير انتشار النظم السياسية الاستبدادية في مجتمعاتنا، من المحيط إلى الخليج”8. لقد فشلت الأعمال المختلفة لعلماء السياسة الذين حاولوا تفسير استمرار الاستبداد في العالم العربي من ناحية سياسية محضة. فالتطورات التي أعقبت ما سُمي بالربيع العربي دليلٌ صارخٌ على أن اختزال الاستبداد في بعده السياسي يفسر أعراضه، وليس أسبابه، وهي أسباب ذات طبيعة دينية – ثقافية أيضًا، كما أشار حمودي قبل عقود. ولهذا السبب فإن نقد السياسة السائدة يجب أن يكون نقدًا للثقافة السائدة أو النموذج الثقافي السائد ومنظومة القيم التي تُشكّل هذه السياسة وتخدمها وتشرعنها، وتعيد إنتاجها.
يكتب كانط: و من مبادئ فن التربية التي يجب أن يأخذها بعين الاعتبار أولئك الرجال الذين يضعون خطط التربية والتعليم بوجه خاص: لا يجب تربية الأطفال وفقًا للوضع الحالي للنوع البشريّ، ولكن في توافق مع الوضع الممكن في المستقبل, و هو ما يعني تربيتهم على فكرة الإنسانية, و في انسجم مع غايتها الكاملة. هذا المبدأ ذو أهمية كبيرة, فالآباء و الأمهات لا يربّون أولارهم عموماً إلا بطريقة تتناسب مع العالم الحاضر, مهما كان فاسداً, في حين أنه ينبغي تربيتهم بطريقة أفضل, حتى ينبثق من خلال خلك وضعٌ أفضل في المستقبلز
يتعلق الأمر، في لغة حمودي، “بنوع من القواعد التي تحكم التفاعل اليومي، وتضمن إعادة إنتاج السلطة القائمة وعلاقات القوة “9. في هذا النظام المغلق لا تكون المشاركة السياسية ممكنة إلا في إطار الطاعة. ويقدّم هشام شرابي تفسيرًا مقنعًا لواقع المجتمعات العربية المعاصرة، وبُناها والعلاقات التي تسودها، من خلال مفهومه: “الأبوية المستحدثة”. ويتحدث هذا المفهوم عن نظام اجتماعي يزاوج بين الحداثة والأبوية، مما يؤدّي إلى مجتمعٍ تسيطر عليه جماعات مثل الجماعات الطائفية أو القبلية أو العرقيّة أو الحركات الدينية.10 وفي هذا النظام الاجتماعي تُستغلّ الحداثة ومنجزاتها التقنية من أجل إعادة إنتاج البُنى والتّراتبيات السائدة. أو بلغة أدقّ: إننا أمام نظامٍ مجتمعيّ يعيش تحديثًا بلا حداثة، مُنفصلًا عن قيمها المعرفية والسياسيّة والحقوقيّة.
توضح هذه المساهمات، بما لا يدع مجالًا للشكّ، وكثيرٌ غيرها، مثل تلك التي قدّمتها النسوية العربية، أن أزمة المجتمعات العربية اليوم هي أزمة تربوية، وأن هذه الأزمة تُفصح عن نفسها بالأساس، إذا أردنا التعبير عنها بلغة كانط، في التربية التي يقدمها “الآباء” التي يقدمها “الأمراء”.11 إنها تربية تحكمها الأنانية وضيق النظر من جهة الآباء، لأن هدفها يرتبط بالحاضر وليس بالمستقبل، وهي تربية أداتية من جهة الأمراء، تُحوّل المواطنين إلى مجرد أدوات بيد الدولة، أي تقف حجر عثرة أمام تطورهم الكوسموبوليتي، أو أمام انتمائهم إلى العالم.
:الأطروحة الثانية
يقدم التصور الكانطي عن تربية كوسموبوليتية مدخلًا أساسيًّا لقراءة أزمة المجتمعات العربية المعاصرة ونُظُمها التربوية، وليس التربوية فقط. فالتربية الكوسموبوليتية كما يفهمها كانط، تتناقض في أدق تفاصيلها مع التربية السلطوية التي تنتج وتعيد إنتاج البُنى والعلاقات الاجتماعية والسياسية السائدة، وهي تتناقض معها أولًا، لأنها تتحدث عن مواطن عالمي، أو عن انتماء إلى العالم، يتجاوز الانتماءات القومية والدينية والطائفية الضيقة التي تقوم على الهيمنة وتقف حجر عثرة أمام الحرية الفردية، وهو انتماء يتحقق كتربية على الإنسانية وليس مثل تلك التربية الأداتية التي تسود الأسرة والمجتمع في نظام الأبوية المستحدثة. كما أنها، ثانيًا، تتناقض معها، لأنها تربية على المستقبل.
إن اتهام التربية الكوسموبوليتية بأنها من طبيعة مجردة، أو أنها تغفل الخصوصيات الثقافية للأفراد، هو الاتهام نفسه الذي سيرفع في وجه حقوق الإنسان الكونية من أجل الدفاع عن السياسات السلطوية. إن مثل هذا التفكير الأيديولوجي، يحرم الثقافات المحلية من حقها في التطور، ويربطها بنموذج نهائي ومغلق. إن الانتماء إلى قيم كوسموبوليتية من شأنه أن يخدم المجتمعات المحلية، ويشجعها، ليس فقط على اللحاق بالقانون الكوسموبوليتي الدولي، ولكن سيساعدها أيضًا على دمقرطة مؤسساتها بشكل يتوافق مع ذلك القانون.
إذ كما يكتب كانط: “ومن مبادئ فن التربية التي يجب أن يأخذها بعين الاعتبار أولئك الرجال الذين يضعون خطط التربية والتعليم بوجه خاص: لا يجب تربية الأطفال وفقًا للوضع الحالي للنوع البشريّ، ولكن في توافق مع الوضع الممكن في المستقبل، وهو ما يعني تربيتهم على فكرة الإنسانية، وفي انسجام مع غايتها الكاملة. هذا المبدأ ذو أهمية كبيرة، فالآباء والأمهات لا يربّون أولادهم عمومًا إلا بطريقة تتناسب مع العالم الحاضر، مهما كان فاسدًا، في حين أنه ينبغي تربيتهم بطريقة أفضل، حتى ينبثق من خلال ذلك وضعٌ أفضل في المستقبل”12. إن الأمر لا يتعلق بتربية سلفية، تهدف إلى استعادة نموذج ماضوي Imitatio Muhammadi 13، ولا هي تربية متصالحة مع الوضع الراهن. كما أنها ثالثًا تربية تهدف إلى النضج، فهي لا تريد أن تصنع رعايا، ولكن أن تصنع مواطنين يتمتعون بالاستقلال الذاتي. إن دور الدولة يكمن، وفقًا لكانط، في حماية حق الناس في الحرية “إنّ أي تدخل من قبل الدولة يهدف إلى تعزيز رفاهية أو أخلاق مواطنيها على حساب حريتهم – على افتراض أنهم في حالة من عدم النضج، فتتولى حمايتهم دون وجه حق – هو تدخل باطل قانونًا بالنسبة لكانط”14، وهو الموقف نفسه الذي سيستقيه جون ستيوارت ميل من كانط، وهو يفهم الأبوية كشكل من أشكال الاستبداد، معتبرًا أنّ: “الحرية الوحيدة التي تستحق اسمها، هي حرية السعي وراء خيرنا بطريقتنا الخاصة، طالما أننا لا نحاول حرمان الآخرين من خيرهم، أو إعاقة جهودهم للحصول عليه”15. إنّ ما يطبع الدولة الثيوقراطية في السياق العربي، وحتى في نماذجها الأكثر تنورّا، هو أن أبويتها تسود كلّ مجالات الحياة الفردية والعامة، وتتدخل في كل صغيرة وكبيرة، وهذا ما يؤجّل، ليس فقط نُضج الأبناء، ولكن أيضّاً نضج الآباء والأمراء.
الأطروحة الثالثة:
إن اتهام التربية الكوسموبوليتية بأنها من طبيعة مجردة، أو أنها تغفل الخصوصيات الثقافية للأفراد، هو الاتهام نفسه الذي سيرفع في وجه حقوق الإنسان الكونية من أجل الدفاع عن السياسات السلطوية. إن مثل هذا التفكير الأيديولوجي، يحرم الثقافات المحلية من حقها في التطور، ويربطها بنموذج نهائي ومغلق. إن الانتماء إلى قيم كوسموبوليتية من شأنه أن يخدم المجتمعات المحلية، ويشجعها، ليس فقط على اللحاق بالقانون الكوسموبوليتي الدولي، ولكن سيساعدها أيضًا على دمقرطة مؤسساتها بشكل يتوافق مع ذلك القانون. إن تربية الفرد على الكوسموبوليتية، يشجعه على اجتراح علاقات جديدة بثقافته ومجتمعه، لا تقوم على الامتثال والخضوع، أو على الفخار القومي الضيق، أو حتى على العنصرية تجاه الثقافات الأخرى.
إن التربية الكوسموبوليتية تهرف إلى النضج, فهي لا تريد أن تصنع رعايا, ولكن أن تصنع مواطنين يتمتعون بالاستقلال الخاتيز.
إن العلاقة بالآخر تشكل الذات، وتحدد هويتها الأخلاقية. ومن هنا فإن التربية الكوسموبوليتية ستقف على النقيض من الاستغراب، والاستغراب الجديد المتمثل في الديكولونيالية. أجل، قد يعترض بعضهم، ولكن الكوسموبوليتية لا تعرف التضامن. إنها تعبير عن انتماء مجرد، لا تجري في عروقه دماء. ولكن العكس هو الصحيح. فلا يمكن للتضامن أن يكون حقيقيًّا إلا إذا كان كوسموبوليتيًّا، وتجاوز المنطق المغلق للعرق، أو الدين، أو الثقافة. إن الحكم الذي أصدره هابرماس على الثقافة الألمانية، يسري في الواقع على جميع الثقافات المنخرطة في الحداثة ومنطقها، فلم يعد لها من هوية سياسية ممكنة خارج المبادئ الكونية للديمقراطية وحقوق الإنسان، ولا يمكنها التعامل مع تقاليدها القومية إلا في صيغة النقد والنقد الذاتي.16إن منطق الانتماء غير المشروط يتعارض مع العقل النقدي، وهو شبيه بموقف العقل الدوغمائي داخل الميتافيزيقا. إن العقل، في التصور الكانطي، لا يشعر بالحنين لغير المستقبل، ولكنه مستقبل يصنعه العقل نفسه، وليس ذلك المستقبل الماضي للسلفيين والدوغمائيين. إن دور التربية أن تعوض نقص الطبيعة، لكن في ظل الوضع العربي المعاصر، يجب عليها أن تُعوّض نقصًا مزدوجًا، وهو ما اعتبره كانط نقصًا طبيعيًّا، ولكن أيضًا ما يمكن اعتباره نقصًا حضاريًّا وهو استمرار لصراع خاسر بين الثقافة والحضارة في السياق العربي. وبتعبير آخر: “إن البيداغوجيا الكوسموبوليتية لكانط تهدف إلى التنوير”17، وهنا تطرح المسألة الدينية نفسها بشكلٍ كبير، وهي المسألة التي شغلت كانط وعصره أيضًا، وقدّم كانط تأملات بشأنها، تستحق أن نتوقف أمامها ونتعلم منها، وخصوصًا انطلاقًا من تصوره عن العقل باعتباره صانعًا للسلام.
الأطروحة الرابعة:
إن غاية العقل والتفكير العقلاني عند كانط هي السلام. يتم التأريخ، عادة، للتفكير في المواطنة العالمية، الضيافة الكونية، الكوسموبوليتية، بكانط وفكرته عن السلام الأبدي، حتى وإن فضّل بعضهم أحيانًا العودة إلى الفلسفة الرواقية. ولكن ما يجب الانتباه إليه، بدءًا في هذا السياق هو المهمة التي يربط بها كانط العقل أو نقد العقل التي تتمثل، برأيه، في تحقيق السلام. يفهم كانط العقل الذي يُحّدده النقد والنقد الذاتي، بالمعنى الميتافيزيقي والسّياسي، كضامن للسلام الأبدي. إن هذا ما يُعبّر عنه في دقّة وحماس في كتابه “نقد العقل المحض”. وحين يتحدث كانط عن هذه المهمّة “الدبلوماسية” للعقل، فإنه يربطه في الآن نفسه، بشرطين أساسيين وهما “النقد” و“الحرية”. إذ لا يمكن للعقل أن يقوم بمهمته على أكمل وجه إلا إذا خضع للنقد، ولا يمكن للنقد أن يتحقّق إلا في ظل الحرية، لأن الحرية تعني قابلية أيّ فكرة وسلطة للنقد. يكتب كانط: “إن وجود العقل نفسه يقوم على هذه الحرية، ذلك أنه ليس للعقل سلطة ديكتاتورية، بل إن مقولته في كل وقت ليست سوى اتفاق بين مواطنين أحرار، كل منهم بإمكانه أن يعبّر عن شكوكه، بل عن اعتراضه، من دون منع”18. يتحدث كانط عن ذلك في إطار نقده للموقف الدوغمائي، وهو يتحدث عن العقل باعتباره محكمة، وهي محكمة لا تؤدي دورها بشكل عقلاني إلا في سياق تحكمه الحرية، ولا تتدخل في عمله “أياد غريبة” لتدفع به إلى “خارج مسيرته الطبيعية باتجاه مقاصد مفروضة عليه كرهًا”19. وفي تعبير آخر لم يفقد شيئًا من راهنيته، يكتب كانط: “دعوا إذن خصمكم يقول العقل، وحاربوه بسلاح العقل فقط”20. وما سلاحُ العقل لدى كانط سوى النقد، وليس المعاظلة في الكلام Großsprecherei. وكما يكتب كانط: “وبدونه يرتدّ العقل إلى حالة الطبيعة، ولا يمكنه أن يثبت تأكيداته وادعاءاته أو يؤمّن عليها، إلا من خلال الحرب. في حين يهبنا العقل الذي يستمد قراراته كلها من قواعد أساسية يتحقق من خلالها، وليس بمكنة أحد الشك فيها، طمأنينة وضع شرعي، لا نقوم فيه بحلّ خلافاتنا إلا عبر عملية التقاضي. إن ما سيضع حدًّا للخلاف في الحالة الأولى هو نصر يتباهى بتحقيقه الطرفان، ولا يعقبه في مُعظم الأحوال إلا سلامٌ غيرُ مضمون، يتحقق على يد سلطة قاهرة، لكن في الحالة الثانية فالحكم الذي يصدر عن محكمة العقل الذي يمس مصدر الخلافات نفسه، هو من سيضمن لا ريب سلامًا دائمًا”.21
إن الانتماء إلى قيم كوسموبوليتية من شأنه أن يخدم المجتمعات المحلية، ويشجعها، و يشجعها على دمقرطة مؤسساتها.
يلخص كانط مسار فلسفة العقل في التاريخ في ثلاثة مصطلحات مركزية: الدوغمائية، والشك، وأخيرًا النقد أو النقدانية. يُقصد بالدوغمائية الثقة المفرطة للعقل في نفسه، وتعني الاعتقاد بأن العقل الفلسفي قادرٌ على التعرف على الأشياء بشكل قبلي. أما الشك فيقوم بالنسبة لكانط، على الفكرة التي تقول باستحالة كُلّ ميتافيزيقا، أما اللحظة الثالثة، وهي اللحظة الكانطية، فهي لحظة نقد العقل المحض، أو لحظة النقد الذاتي للعقل التي ستضع حدًّا للنزاع الدائم في الميتافيزيقا، وتمهد الطريق للسلام داخلها. ولهذا السبب أيضًا تشكل اللحظة الثالثة نوعًا من المحكمة، في لغة كانط. وهي محكمة أو محاكمة يجب أن تضمن، في نهاية المطاف، السلام الأبدي. إن حلّ هذا الخلاف الذي يشترط النقد والنقد الذاتي، هو سمةٌ مركزية للفلسفة الكانطية بأكملها، وليس فقط ميتافيزيقا. بل إن النقد أهم من السلام ذاته، كما يوضح هانز سانر: “إن الطريق إلى السلام، سواء كان ذلك في الميتافيزيقا أو في السياسة، أهم عند كانط من السلام نفسه. والواقع أن هذا السلام لا معنى له إلا بقدر ما يفتح الطريق ويُعبّدها، أي ما دام لم يتحقق بعد. إنها مفارقة. ومن ثم فإن السلام ليس غاية في حد ذاته. لا يسعى كانط إلى الوحدة دون قيد أو شرط، ومن ثم فإن ما هو مرغوب فيه ليس أي طريق إلى هذا السلام، بل هو طريق محدد ومتميز: طريق التنوير”22. إنه سلام يقوم على مبدأ العقل النقدي، وعلى المستويين النظري والعملي، وكُلّ سلام لا يربط مصيره بالعقل، يظل سلامًا زائفًا، وكُلّ سلام لا يتحقق في ظل الحرية والصدق يظل سلامًا زائفًا، داخل الميتافيزيقا وخارجها. وكما يكتب سانر: “يبدأ السلامُ السياسي بتسمية الأشياء بمُسمّياتها. إن مبدأ الكذب هو مبدأ الحرب. إن هذا هو الرفض الجذري للدبلوماسية السرية، والدهاء كآخر رهان لعقل الدولة، باختصار: لسياسة الكذب”23. ولهذا السبب أيضًا يدافع كانط عن حكم القانون داخل الدولة الواحدة وخارجها، بين الدول المختلفة.
إن السلام هو الخيرُ الأسمى، وإن العقل النقدي هو وحده القادر على تحقيق السلام نظريًّا وعمليًّا. يكتب هانز ميشائيل بومغارتن: “إن فلسفة كانط ككل هي محاولة للتوسط وتحقيق السلام انطلاقًا من تجربة الصراع. صراع الفلسفات وكذلك الأفراد والدول”.24 فقط مع كانط سيغدو السلامُ مفهومًا أساسيًّا في الفلسفة. يمثل أوغسطين استثناءً في فلسفة ما قبل الحداثة، لكن سلامه يظل محفوظًا لـ “ما بعد”، أما عند كانط فيجب أن يتحقق السلام في هذا العالم، في توافق مع فكرة الحق، وليس مجرد تكتيك سياسي، أو فترة نقاهة تسترجع فيها الأطراف المتحاربة أنفاسها استعدادًا لحرب جديدة.
الأطروحة الخامسة:
إن التنوير الكانطيّ ليس مُعاديًا للدّين، ولكنه معادٍ لدين الوصاية. طبعًا، لن يكون هذا دومًا موضع اتفاق بين شُرّاح كانط، فهاينريش هاينه سيقارن كتاب كانط “نقد العقل المحض” وأهميته بالثورة الفرنسية. يكتب: “سنشهد على ضفتي نهر الرّاين القطيعة نفسها مع الماضي، فكُلّ تقديس للتقاليد سيتم إبطاله؛ وكما هنا في فرنسا، أيُّ حق يجب أن يُبرّر نفسه، كذلك هناك في ألمانيا الحال مع كل فكرة.
يدافع كانط عن تصور أخلاقي ــــــ ديمقراطي عن التنوير، يشمل جميع البشر. يؤكد أوتفريد هوفه بأن التنوير عند كانط يمتلك بُعدًا أخلاقيًّا، وهو ما يعني بأن التنوير لديه لا يرتبط بمراكمة المعارف، ولكنه يتعلق بواجب أخلاقي، هو ليس أقل من “ثورة داخلية في الموقف من الحياة والعالم”25 إن وضع اللارشد الذي يتحدث عنه كانط في مقالته حول التنوير وفي كتابه “الأنثروبولجيا من وجهة نظر براغماتية”، هو لا رشد أخلاقي، ولكنه يمتلك أيضًا بُعدًا سياسيًّا. ومن جهة أخرى، ففي تأكيد كانط على أن التنوير لا يُختزل في مراكمة المعارف، هو يرفض التصور الأرستقراطي عن التنوير كما تطور مع الموسوعيين الفرنسيين دالامبير وديدرو. إنّ الأمر يتعلق لدى كانط، كما يوضح هوفه، برفض “لكل ارستقراطية عقلية، لصالح ديمقراطية تشمل الأمور العقلية أيضًا”26 ، وبلغة أخرى، إنّ كلّ إنسان قادرٌ ومؤهلٌ للتنوير أو للخروج من الوصاية، بغض النظر عن ثقافته ودينه، وطبقته الاجتماعية، إلخ.. ومن هنا البُعد الكوسموبوليتي للتنوير الذي يصطدم مع كثير من الكتابات الفلسفية الغربية التي مازالت، إلى يومنا هذا تحتكر لنفسها الحق في مفاهيم مثل المعنى، والثورة، والتحرر وكثير غيرها.27
:الأطروحة السادسة
إن التربية عند كانط تهدف إلى تحقيق فكرة الإنسانية في الانسان، وهو ما لم تنجح فيه الأديان والمعتقدات الدنيوية. لا يبالغ أوتفريد هوفه وهو يكتب بأن كانط “الفيلسوف الوحيد في الحداثة الذي يُفكّر كُليًّا بشكل كوسموبوليتي”28. يؤكد هوفه بأن كانط كان “غريبًا على الغطرسة الأورو ـــــ مركزية”29 وحين يتحدث عن أوروبا لا يتحدث عن مشتركات، ولكن عن غنى التنوع، وعوضًا عن “الغطرسة الأورو ـــــ مركزية سيتميز تفكير كانط بكومسموبوليتيته الكونية”، وعلاوة على الكوسموبوليتية الإبستمية التي يعبر عنها في “نقد العقل المحض” من خلال أسسه القبلية ــــ التوليفية المفارقة للثقافة والتاريخ”30 وعلى كوسموبوليته الأخلاقية التي يُعبّر عنها الأمر الأخلاقي الذي يسري على مجموع البشر، نقف على تربيته الكوسموبوليتية التي تطلب تحقيق فكرة الإنسانية في الإنسان، أو كما يكتب كانط: “يجب على الخطة التربوية أن تكون كوسموبوليتية”31، وهو ما لن يعثر عليه كانط في التربية التي يقدمها الآباء أو الأمراء، وهو يرى هدف التربية الكوسموبوليتية في سعيها إلى تحقيق “الأفضل في العالم والكمال”. لقد رأى كانط في عصره بأن التربية تتحقق كترويض وتثقيف وتحضير.
إن دين العقل الذي يدافع عنه كانط غايته التحسين الداخلي للإنسان؛ ولهذا سيعيش دينُ العقل صراعًا مستمرًّا مع الاعتقاد الكنسي، هذا الاعتقاد الذي في تغييبه للعقل، يُرغم دين العقل على الدخول في الصراع، ولهذا يرى كانط بأن تاريخ الإيمان هو ليس أكثر من قصة الصراع المستمر بين دين الطاعات والدين الأخلاقي.
إنها تقوم على تربية الأطفال بشكل يسمح لهم بالاندماج بعصرهم ومجتمعهم، ولكن التربية الأخلاقية هي وحدها الكفيلة بربطهم بالمستقبل والإنسانية. إنّ الأمر لا يتعلق لدى كانط بتربية قومية، كما سيطورها فيشته في “الخطب إلى الأمة الألمانية”، هذا الكتاب الذي سيكون له كبيرُ أثرٍ على الفكر الأيديولوجي العربي منذ ساطع الحصري الذي يمكن تتبع تأثيره حتى حسن حنفي وتصوره عن الاستغراب، بل إنها تربية، كما سيكتب هوفه: “لا تتوجه إلى ثقافة أو حقبة معينة، ولكن إلى الإنسانية.32 إنها تربية تريد الأفضل في العالم، حتى لو كان ذلك على حساب الوطن الأم. ولهذا السبب أيضًا يرى ماركوس فيلاشيك أن “مفهوم كانط عن المواطنة العالمية يتجاوز الكوسموبوليتية القانونية (القانون الكوني) والكوسموبوليتية السياسية (نظام السلام العالمي). فمنذ كتابه “أسس ميتافيزيقا الأخلاق” الصادر عام 1785، سيصف كانط الإنسان الفرد كجزء من جماعة الكائنات العاقلة، كمواطن في “مملكة الغايات”. في الأعمال اللاحقة، يطوّر كانط فكرة الكوسموبوليتية الأخلاقية انطلاقًا من ذلك التي بموجبها يجب على المرء أن يرى نفسه جزءًا من جماعة عالمية تشمل جميع البشر. هذا “الموقف الكوسموبوليتي” تصحيح ضروري للنزوع البشري نحو الأنانية الأخلاقية والتعصب الديني، فهو يعد جميع الناس أعضاء متساوين في جماعة عالمية…”33.
:الأطروحة السابعة
لتنوير عند كانط يمتلك بُعدًا أخلاقيًّا، وهو ما يعني بأن التنوير لديه لا يرتبط بمراكمة المعارف، ولكنه يتعلق بواجب أخلاقي. (أوتفريد هوفه)
إن التنوير الكانطيّ ليس مُعاديًا للدّين، ولكنه معادٍ لدين الوصاية. طبعًا، لن يكون هذا دومًا موضع اتفاق بين شُرّاح كانط، فهاينريش هاينه سيقارن كتاب كانط “نقد العقل المحض” وأهميته بالثورة الفرنسية. يكتب: “سنشهد على ضفتي نهر الرّاين القطيعة نفسها مع الماضي، فكُلّ تقديس للتقاليد سيتم إبطاله؛ وكما هنا في فرنسا، أيُّ حق يجب أن يُبرّر نفسه، كذلك هناك في ألمانيا الحال مع كل فكرة، وكما ثم هنا إسقاط الملكية التي هي حجر الزاوية في النظام الاجتماعي القديم، كذلك هناك تسقط الربوبية التي تمثل حجر زاوية النظام الروحي القديم”34. بل أكثر من ذلك، فإن هاينه يخاطب الفرنسيين بالقول، بأنهم يبالغون في تمجيد ثورتهم وزعيمهم روبسبيير، وأنهم لم يقتلوا سوى ملكٍ، في حين أن كانط سيقتل في رأيه جماع النظام القديم، وأنه يستحق من التقدير أكثر مما يستحقه روبسبيير، أو أنه في “إرهابه يتجاوز نظيره عند روبسبيير”35. لكن حتى وإن كان هذا الرأي سيستمر حتى اليوم عند بعض الشُراح 36، إلا أن أغلبهم سيمضي في اتجاه آخر.37إن هذا ما يؤكده جان هار، واصفًا القراءات التي تقول إن الأخلاق الكانطية تنفصل بشكل مطلق عن الألوهية Theism بالاختزالية، لأنها لم تقرأ كل نصوص كانط حول هذه القضية ومنها النص الذي يؤكد فيه فيلسوف كونيغسبيرغ بأن: “حالة المُلحد المتشكك هي حالة غير مستقرة، يتدهور فيها المرء دائمًا من الأمل إلى الشك وفقدان الثقة“38. ويتابع هار مُعلّقًا: “لم يكن كانط يريد إزاحة الله من العرش. إن نظامه يتطلب وجود شخص إلهي، له إرادة وعقل، يستطيع أن يعطينا الأوامر ويتدخل ليُحققّق بداخلنا ثورة إرادتنا، ويستطيع أن ينسق غايات جميع الكائنات العاقلة بهدف تكوين مملكة الغايات. لهذا السبب، يقول كانط مرارًا وتكرارًا، بأن علينا أن نعترف بواجباتنا كأوامر إلهية“39. إن تأكيد أن الأخلاق الكانطية ليست معاديةً للدين، أمرٌ في غاية الأهمية، وخصوصًا في سياق مثل السياق العربي. فهو سياقٌ يتكلم لغة دينية، ولا يمكن أن نخاطبه من خارج هذه اللغة. لقد حاولت ذلك تيارات مختلفة، ليبرالية، ماركسية، علمانية إلخ. ولكنها فشلت في أن تجد لها صدى في المجتمع. ظلت هذه التيارات بعيدة، ومنفصلة عن قدَر الناس، بل ستتحول في أحيان كثيرة إلى ظهير للاستبداد. إن تبنّي تأويلات غير متضامنة للكانطية، مثل تلك التي يقدّمها هاينريش هاينه، لا تحرمنا فقط من “الأمل في الخير الأسمى”، بل أيضاً من أي علاقة بالواقع وبالآخرين. إن كانط نفسه من سيلاحظ بأن معاصريه عرفوا طريقهم إلى القانون الأخلاقي من خلال المسيحية، وأن من شأن “الإلحاد، في شكله الدوغمائي، إذا ما أصبح منتشرًا ودمّر هذه الوسيلة – أي المسيحية – أن يُمثّل خطرًا، وذلك ليس فقط على الأفراد، وليس فقط على الدولة، بل على الجنس البشري بأكمله”40. يقدم لنا إرنست كاسيرر في كتابه الكلاسيكي: “فلسفة التنوير”، برأيي، تصحيحًا للتاريخ اليعقوبي للتنوير، كما وصلنا في السياق العربي من خلال الأدبيات الفرنسية. إذ يرى أنها قراءة أحاديةُ البعد، تلك التي ستفهم التنوير باعتباره رفضًا للدين. قد يكون هذا صحيحًا بالنسبة إلى التنوير الفرنسي، ولكن ليس بالنسبة إلى التنوير الألماني والإنجليزي.41ويؤكدُ، في الآن نفسه، بأن “أقوى الدوافع الفكرية للتنوير وقوته الروحية الفعلية، لا تتأسس في نبذها للدين، بل في المثل الأعلى الجديد للإيمان الذي تطرحه، وفي الشكل الجديد للدين الذي تُجسّده في ذاتها”42. وفي هذا السياق، لا يقدم الإيمان على أنه عدوُّ المعرفة، بل عدوٌّ لتلك المعرفة الدينية التي تُزيّف المعرفة ومعها الإيمان.
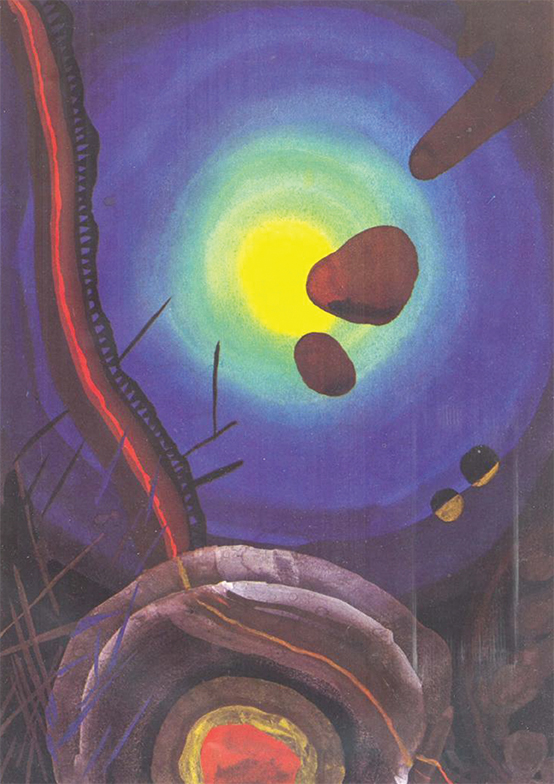
”إن المعارضة الجذرية الحقيقية للإيمان ليست الكفر، بل الخرافة“43، يكتب كاسيرر ويضيف: ”إن التغيير الحاسم يحدث عندما يحلّ محلّ الروح الدينية التي حرّكت القرون السابقة، قرون الصراع الديني، روح دينية خالصة”44. ويقصد كاسيرر بهذه الروح الدينية الجديدة: حرية الإنسان في تشكيل ديني، بمعنى أن يعيش دينه في حرية وليس كـ “قوة غريبة”Fremde Kraft، تهيمن عليه وتقرر حياته45.
:الأطروحة الثامنة
إن كونية القانون الأخلاقي تسمو به فوق الخصوصيات، وتنزع من أنا الإنسان، أولًا وقبل كل شيء، فرديته. إنها لا ترى سوى الإنسان المجرد، ولكنها لا ترى الإنسان المُتألّم، أو الإنسان في لحمه ودمه، ومن هنا حاجتها إلى الدين الذي
عبره يتحقق المثال الأخلاقي في الواقع.
إن دين العقل الذي يدافع عنه كانط غايته التحسين الداخلي للإنسان؛ ولهذا سيعيش دينُ العقل صراعًا مستمرًّا مع الاعتقاد الكنسي، هذا الاعتقاد الذي في تغييبه للعقل، يُرغم دين العقل على الدخول في الصراع، ولهذا يرى كانط بأن تاريخ الإيمان هو ليس أكثر من قصة الصراع المستمر بين دين الطاعات والدين الأخلاقي. ويرى سانر في قراءته للعقل بأن دين الطاعات يحارب في دين العقل، العقل نفسه46، فدينُ الطاعات يطلب تدمير الاعتقاد الحر، ودينُ العقل يطلب تحرير الإيمان من سلطة الإكراه والإقصاء. ولكن كما يوضح سانر، لا يجب أن نعتقد بأن كانط يرفض الدين الذي يقوم على الوحي، بل قد يراه ضروريًّا كلما استجاب لمتطلبات التطور وكلما اقترب من العقل. ويؤكد سانر بأن هذا التناقض يقوم بين شكلين للدين، دين الطاعات من جهة، ودين العقل أو الحرية من جهة ثانية، هو تعبير عن نوعين من الصراع، صراع تعدمه الشرعية، لأنه لا يقوم على العقل ولا ينشد العقل، ولأنه صراع يطلب تدمير الخصم، الوحي الآخر أو الدين الآخر مثل الحروب الدينية التي عرفتها أوروبا أو الحروب المذهبية في السياق العربي والإسلامي التي لا يتحقق فيها السلام إلا على جثث الآخرين، ولكن هناك شكل آخر للصراع هو ما يسميه بالشرعي وهو الصراع الذي يطلب تحقيق السلام ولكن في ظل الحرية. كلا الصراعين يطلب الوحدة أو يطلب السلام، ولكن هناك سلام يمثل نصرًا للعقل وآخرُ نصر للعنف؛ ولهذا يرفض كانط وحدةً لا تقوم على الحرية، وينشد وحدةً تشترط العقل والحرية.47
يكتب كوهين مُوضحًا موقفه: “هناك مثال تاريخي رئيس على ضرورة تكملة الأخلاق بالدين، وهذا ما تقدمه الرواقية في علاقتها بالمعاناة الإنسانية. فهي تعلنها كشيءٍ غير ذي أهمية، ومن ثم تستبعدها من عالم الأخلاق. هذه النتيجة المترتبة على الثنائية الرواقية التي تتأرجح بين الروحانية والمادية في كل الأمور، هي خطأ مزدوج.
نفضل اليوم الحديث عن التدين وليس عن الدين. واليوم نعي أكثر بأن الإصلاح الديني لا يجب أن يمر فقط مما يسميه نيتشه بـ “الحمّام الكانطي البارد”، أو من نقد غير مشروط، ولكنه إصلاح يرتبط بشروط اجتماعية وسياسية، ولا يتحقق إلا إذا اتسق مع نهضة علمية واقتصادية ودمقرطة للمؤسسات السياسية وغيرها الخ.. ولكن نقد كانط لدين عصره يقدم لنا نموذجًا للنقد الديني الذي لا يطلب على طريقة التنوير الفرنسي إخراج الدين، وبشكل متطرف، من الحياة الإنسانية أو من الفضاء العام، أي تحقيق السلام من خلال الإكراه والعنف، وهو ما يمثل علمنة للعنف الديني نفسه، ولكن تحويله من الداخل كما طلب تحقيق ذلك التنوير الألماني والأنجلوساكسوني. إن الطريق إلى الأخلاق وإلى الدين الأخلاقي يتحقق في ظل العقل والحرية، وكُلّ حرب على العقل من طرف الدين، كما يُوضّح كانط في تصدير كتابه: “الدين في حدود مجرد العقل”، هي حربٌ خاسرة.
:الأطروحة التاسعة
يمكن للتنوير أن يكون إسلاميًّا، ولكن نوره لا يكتمل إلا بالعقل. يكتب المؤرخ المغربي عبد الله العروي الآتي: “إن التاريخانية تجعل من كل حوار عبر الأزمنة، أمرًا إشكاليًّا”48. وهو هنا يحذرنا من تلك المحاولات الواهية التي تُغفل مبدأ التاريخية، وهي تبحث عن جذور للتنوير في حقبة سابقة على الحداثة. لكن ما يطبع مثل هذه المحاولات، في سياق عربي ــــ إسلامي هو انطلاقها من مفهوم جوهراني للإسلام، يعتقد بأنه دين ثابت واحد مُنزهٌ عن التاريخ وتحولاته. إنها محاولات تُعيد إنتاج موقف الاستشراق الغربي الذي في رأيي لم يستطع، في شططه اليعقوبي، أن يقف على التعدد الذي يطبع الإسلام. ألم يكتب أحدُ كبار المستشرقين الألمان بأن الإسلام دينُ قانون وأنه يحشر نفسه في أدقّ تفاصيل الحياة الإنسانية، وأنه لا يُفرّق بين الديني والدنيوي، لينتهي إلى نتيجة تقول بأنه دين “توتاليتاري”49؟ ألا يتحدث هنا عن دينٍ فوق التاريخ، دينٍ لا يصيبه التغير، دينٍ لا يقبل التطور؟ هل يمكننا أن نلتقي مثل هذا الدين خارج أحكامنا المسبقة؟ ويؤكد هذه الأحكام المسبقة الزعمُ بأن الإسلام لا يعرف الضمير باعتباره سُلطةً مُستقلة، وأن “المسلم لا يسلك وفقًا لضميره، ولكن نزولًا عند إرادة الله”50، وبتعبيرٍ آخر، إن المسلم لا يعيش دينه إيتيقيًا، ولكن يعيشه كسلطة خارجية. لا غروَ أن ذلك ما يصنع الإسلام المعاصر، إسلام الحداثة الذي يتحقق كدين فقير وبلا ثقافة، لكن الإسلام الذي لا يمكن فهمه إلا بصيغة الجمع، كما يُعلّمنا محمد أركون، لا يمكن اختزاله في هذا الإسلام المعاصر. إن القيام بذلك يندرج في سياق الشعبوية المعرفية التي تصنعُ صورة الإسلام والمسلمين في الإعلام الغربي اليوم. لا غرو أنه بالنسبة إلى الأديان التوحيدية اليوم يظل الطريق البروتستانتي وحده مفتوحًا، وأعني بذلك: ترجمة الحدوس الدينية إلى لغة الإيتيقا المعاصرة، أو ما أسماه كانط بدين العقل، ولكن يجب في نهاية المطاف ألا نختزل الإسلام في قراءة أرثوذكسية.
إن العلاقة بين الدين والأخلاق، وفقًا للتصور الذي يقدمه هرمان كوهين، لا تقوم على صراع شرعيات، بل هي علاقة تكاملية. إن كونية القانون الأخلاقي تسمو به فوق الخصوصيات، و”تنزع من أنا الإنسان، أولًا وقبل كل شيء، فرديته. إنها لا ترى سوى الإنسان المجرد، ولكنها لا ترى الإنسان المُتألّم، أو الإنسان في لحمه ودمه، ومن هنا حاجتها إلى الدين الذي عبره يتحقق المثال الأخلاقي في الواقع.
أنطلق هنا من الإسلام كما يُعبّر عن نفسه اليوم في الحداثة. إنه دون شك في تمظهراته، تعبيرٌ عن تناقضاتها الأكثر تطرفًا، أو بلغة بيير بورديو الذي لا تتورع اليوم الهيدرا الرجعية في فرنسا عن وصم سوسيولوجيته بالإرهاب، “إن لاعقلانيات الأطراف هي امتداد لعنف العقل في المركز”.51 لكن هل يمكن للاستشراق أن يفكر من داخل المجتمع والتاريخ؟ أم أن الثقافات الأخرى لا تستحق جهد التاريخ؟ ومع ذلك لا يمكننا أن نُنكر ما يسجله فان إس من أن المسيحيين اليوم يعتقدون في صمت، ويعيشون علاقتهم بالإله بشكل شخصي52، أو يعيشونها كعلاقة وليس كسلطة، في حين يعتقد المسلمون في الإسلامية المعاصرة، لا ريب بصوت مرتفع ويزعجون القريب قبل البعيد. لكنه اعتقاد لا يمثل الاسلام في تعدديته، ولا ينحصر في إسلام اليوم فقط، بقدر ما يُعبّر عن فشل المشروع العلماني التحرري، كما سيقرأ ذلك مايكل والزر في ثلاث تجارب من القرن العشرين: الجزائر والهند وإسرائيل،53غير أننا تعودنا في السياق الغربي ألا ننتقد سوى الإسلام.
:الأطروحة العاشرة
إن أخلاقًا بلا دين لا جسد لها، وإن دينًا بلا أخلاق لا روح له. على الرغم من كل الانتقادات الموجهة إلى “الأخلاق الكانطية” في الفلسفة الحديثة، بدءًا من هيغل التي لم ترَ في هذه الأخلاق سوى صورانية فارغة، فإن كانط كان واعيًا، وكما عبّر عن ذلك في “ميتافيزيقا الأخلاق”، استنادًا إلى الرواقيين، بأن الفضيلة، بدون ممارسة، لا يمكن تعليمها، لذلك لا يمكن أن يكون التصور الحقيقي للقانون الأخلاقي ممكنًا إلا في الحياة وفي ارتباطه بالحياة. غير أن كانط لا يقول شيئًا عن أشكال الممارسة التي يمكن أن تتحقق عبرها هذه الأخلاق، كما يلاحظ رولف إلبيرفيلد الذي يصف هذه الأخلاق، محقًا، بأنها أخلاق ”من فوق“54 von oben، أو هي أخلاق لا تتجاوز مستوى “التفكير”. يرى إلبيرفيلد، في مقاربته البيثقافية، في البوذية نوعًا من الأخلاق من “تحت” von unten، لأن البوذية، حسب رأيه، ”تحاول في المقابل من “تحت”، انطلاقًا من الوضع الحسي للبُنى المنتجة للألم الإنساني في مشاعره، ودوافعه، ونوازعه الأنانيّة، وما إلى ذلك، أن تجعل من بُنى التبعيّة التي ترتبط بها ذاته، شفافة في ذاته ومع الآخرين، وذلك عبر تمارين للعناية Achtsamkeit تشمل كل مستويات الوجود الإنساني”55.
روح التوراة تتمثل في واقع أن العلاقة بالإله، تمُرّ من خلال العلاقة بالناس، وتتطابق مع العدالة الاجتماعية. فموسى والأنبياء لم يهتموا بخلود الروح، بل بالأرملة والفقير واليتيم والغريب. وهذه العلاقة المُحايثة بالإله التي تتحقق من خلال المسؤولية تجاه الإنسان الآخر، وهي من نحتاج اليوم لإعادة اكتشافها، لكن ذلك لن يتحقق دون انتماء غير مشروط إلى التنوير، طريقُنا إلى “دين الراشدين” كما يسميه ليفيناس.
ويضيف: ”في البوذية، لا يكفي تحقيق البصيرة العقلانية في التفكير، بل يجب أن تمتد هذه البصيرة أيضًا إلى جميع مستويات الشعور والإدراك والجسد56“. إن ما يقوله إلبيرفيلد يعني بأنّ الأخلاق الكانطية ليست مكتفيةً بذاتها، ولكنها تجد تحققها في المغامرة البيثقافية، كما في حوار مع البوذية. ولكن ما يمكن أن نستنتجه أيضًا من هذا الحوار بين الكانطية والبوذية، وما لم يقله إلبيرفيلد، لأن حجاجه يرتبط حصرًا بالدفاع عن الفلسفة البيثقافية، وضرورة تجاوز المركزية الفلسفية الأوروبية، هو أن الأخلاق الكانطية لا تكتمل إلا في انفتاحها على الدين. إن هذا ما سينتبه له فيلسوف من بدايات القرن العشرين هو هرمان كوهين.
إن مساهمة كوهين تمتلك أهمية حاسمة بالنسبة لهذا السياق، فهي لا تقوم فقط على الفكرة التنويرية التي تقول بضرورة أن يقوم الدين على الأخلاق، ولكنها تُؤكّد، علاوةً على ذلك، حاجة الأخلاق إلى الدين، إذا ما أرادت هذه الأخلاق أن تنزل إلى واقع الناس وتتحقق فيه. “لأن الدين لا يهتمّ فقط بـ ”أنا الإنسانية“، بل أيضًا، وقبل كل شيء، بالأرملة، واليتيم، والمعوز، والغريب، لا بالإنسان، بل بهذا الإنسان، هؤلاء البشر، العالقين في أوضاع خاصة، تعكس أوضاعًا من المعاناة”57. إن هذا الفهم للدور الذي يمكن أن يقوم به الدين وعلاقته بالايتيقا، لا يعيد تعريف الايتيقا فقط، ولكن الدين أيضًا. فليس الدين سلسلة من المعتقدات الميتافيزيقة المغتربة عن واقع الناس، ولكنه علاقةٌ بالآخر وبالألم الاجتماعي. وبتعبير آخر، فليس الدين “أفيونًا للشعب”، بل دعوةٌ إلى المسؤولية. إن العلاقة بين الدين والأخلاق، وفقًا للتصور الذي يقدمه هرمان كوهين، لا تقوم على صراع شرعيات، بل هي علاقة تكاملية. إن كونية القانون الأخلاقي تسمو به فوق الخصوصيات، و”تنزع من أنا الإنسان، أولًا وقبل كل شيء، فرديته”58. إنها لا ترى سوى الإنسان المجرد، ولكنها لا ترى الإنسان المُتألّم، أو الإنسان في لحمه ودمه، ومن هنا حاجتها إلى الدين الذي عبره يتحقق المثال الأخلاقي في الواقع.
إن روح التوراة تتمثل في واقع أن العلاقة بالإله، تمُرّ من خلال العلاقة بالناس، وتتطابق مع العدالة الاجتماعية.
يكتب كوهين مُوضحًا موقفه: “هناك مثال تاريخي رئيس على ضرورة تكملة الأخلاق بالدين، وهذا ما تقدمه الرواقية في علاقتها بالمعاناة الإنسانية. فهي تعلنها كشيءٍ غير ذي أهمية، ومن ثم تستبعدها من عالم الأخلاق. هذه النتيجة المترتبة على الثنائية الرواقية التي تتأرجح بين الروحانية والمادية في كل الأمور، هي خطأ مزدوج. أولًا، إنّ المعاناة ليست، بأي حال من الأحوال، لحظة مجردة من الأهمية بالنسبة لـ”الأنا”. ذلك أنه لا يحق للوعي الذاتي، ولربما أيضًا بسبب مطلبه الأخلاقي، أن يلاحظ، في لامبالاة، الألم الفيزيقي. ثانيًا، يجب ألا تبقى هذه الملاحظة غير مبالية بالآخر. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: أليس من خلال ملاحظة المعاناة في الآخر بالتحديد، من يجعل هذا الآخر يتحول مِن “هو” إلى أنت؟ وإذا كانت الإجابة على هذا السؤال بالإيجاب، فإن خصوصية الدين تدخل حيز التنفيذ، دون المساس بانتمائه إلى المنهج الأخلاقي”59. وإذا ما عرّجنا الآن على الإسلام، فسنقف على أنّ الإيمان، في النصوص الدينية الإسلامية، مُرادفٌ للشكر، وأن هذا الشكر يتضمن خروجًا من الذات، فهو يتحقق كمسؤولية تجاه الآخرين. “من لا يشكر الناس، لا يشكر الله”، (حديث نبوي)، ولربما لن نجد كلمات أدقّ وأصدق من كلمات ليفيناس في حق التوراة، لنقولها في حقّ القرآن: “إن روح التوراة تتمثل في واقع أن العلاقة بالإله، تمُرّ من خلال العلاقة بالناس، وتتطابق مع العدالة الاجتماعية. فموسى والأنبياء لم يهتموا بخلود الروح، بل بالأرملة والفقير واليتيم والغريب”60. وهذه العلاقة المُحايثة بالإله التي تتحقق من خلال المسؤولية تجاه الإنسان الآخر، وهي من نحتاج اليوم لإعادة اكتشافها، لكن ذلك لن يتحقق دون انتماء غير مشروط إلى التنوير، طريقُنا إلى “دين الراشدين” كما يسميه ليفيناس.
Quellen:
1. Michel Foucault, Qu’est-ce que les lumières ? in : Dits et écrits II, Paris : Gallimard 2017, p.1499.
2. Otfried Hoeffe, Eine republikanische Vernunft. Zur Kritik des Solipsismus-Vorwurfs, in: Kant in der Diskussion der Moderne, (Hg.) Gerhard Schoenrich und Yasuschi Kato, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1997, p. 398.
3. Michel Foucault, Ibid., p. 1500.
4. Ibid., p. 1506.
5. Susan Neiman, Why Grow up? Subversive Thoughts for an Infantile Age, London: Penguin Books, 2016, p.51.
6. Abdallah Laroui, La crise des intellectuels arabes. Traditionalisme ou historicisme ? Casablanca : Centre culturel du livre 2021, p. 8.
7. Ibid., pp. 188-89.
8. Abdellah Hammoudi, Master and Disciple. The cultural foundations of Moroccan authoritarianism, Chicago & London: Chicago Press 1997, p. 1.
9. Ibid., p. 5.
10. Hisham Sharabi, Neopatriarchy. A Theory of Distorted Change in Arab Society, New York- Oxford: Oxford University Press, 1988, pp. 28-29.
11. Immanuel Kant, Ueber die Erziehung, Muenchen: dtv 1997, p. 17.
12. Ibid., Seiten. 16-17.
13. Rachid Boutayeb, Orgasmus und Gewalt. Schrift, Körpermord und die Verdrängung des Weiblichen. Lettre International, 104, 2014.
14. Daniela Tafani. Das Recht auf unsinnige Entscheidungen: Kant gegen die neuen Paternalismen, in: Zeitschrift fuer Rechtsphilosophie, 1, 2017, S. 63.
15. Ibid., S. 66.
16. Habermas, J. Die Nachholende Revolution, Kleine politische Schriften VII. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1990, S. 219.
17. Otfried Hoeffe, Kants Kritik der praktischen Vernunft. Eine Philosophie der Freiheit. Muenchen: C.H. Beck 2012, S. 410.
18. Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, Hamburg: Felix Meiner Verlag 1998, p. 785.
19. Ibid., S. 789.
20. Ibid., S. 789.
21. Ibid., S. 795.
22. Hans Saner, Kants Weg vom Krieg zum Frieden, I. Muenchen: Piper,1967, S. 258.
23. Ibid., S. 264.
24. Hans Michael Baumgartner, Der friedenstiftende Funktion der Vernunft. Eine Skizze, in: Kant in der Diskussion der Moderne, (Hg.) Gerhard Schoenrich und Yasuschi Kato, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1997, S.54.
25. Otfried Hoeffe, Kants Kritik der praktischen Vernunft. Eine Philosophie der Freiheit. Muenchen: C.H. Beck 2012, S. 16.
26. Ibid., S. 19.
27. أكتفي في هذا السياق ببعض ما يُتحفنا به السياق الفلسفي الألماني بين الحين والآخر. مؤخرًا سيربط كريستوف منكه نموذج ومشروع الثقافة الغربية بالتصور اليوناني عن الحرية كتحرر. Christoph Menke, Theorie der Befreiung, 2022, pp. 30-31,. إن مينكه يعمد بذلك إلى اختزال فكرة التحرر في الحضارة اليونانية والأوروبية، ليظل وفيًّا لهيغل، فيلسوف المركزية الجرمانية الذي طرد معظم الحضارات الإنسانية من تاريخه الكوني. وما يقوله الفيلسوف الغربي عن التحرر، يقوله أيضًا عن الثورة. فإذا كان الفيلسوف الغربي يجد النص الأصلي (architext) للتحرر في الثقافة اليونانية القديمة، أو للمعنى في التراجيديا اليونانية، ومن بعدها في المسيحية الغربية مع كارين غلوي في كتابها: Zwischen Glück und Tragik, 2013، فإنه سيجد النص الأصلي للثورة في خروج اليهود من مصر إلى أرض كنعان،. Gunnar Hindrichs, Philosophie der Revolution 2017، كما لو أننا لم نعرف ثورات مشابهة في الحضارات الأخرى، وكما لو أن الله، وحتى نرد عليه بلغة هرمان كوهين: “قد خلق بشريتين وليس بشرية واحدة”! إن ربط المفاهيم الكبرى للحداثة بالتاريخ والثقافة الغربيين يتضمن الكثير من العنف الإبستيمولجي ويبرر للكثير من العنف المادي أيضًا اتجاه الثقافات والشعوب الأخرى.
28. Otfried Hoeffe, 2012, S. 47.
29. Ibid., S. 48.
30. Ibid., S. 58.
31. Kant, Ueber die Erziehung, S. 17.
32. Otfried Hoeffe, der Weltbuerger aus Koenigsberg. Immanuel Kant heute. Person und Werk, 2023, S. 322.
33. Marcus Willaschek, Kant. Die Revolution des Denkens. Muenchen: C.H. Beck 2023, S. 182.
34. Heinrich Heine, Ueber die Philosophie Immanuel Kants, in: Freidenker, Band 41, Heft 7, 1958, S. 212
35. Heinrich Heine, Seiten 215-216.
36. Manfred Kuehn, Kant, A Biography, Cambridge: Cambridge University Press 2002.
37. Kant’s Philosophy of religion reconsidered, Bloomington: Indiana University Press 1991.
38. John Hare, Kant on the Rational Instability of Atheism, in: God and the Ethics of Belief: New Essays in the Philosophy of Religion, edited by Andrew Dole and Andrew Chignell, Cambridge: Cambridge University Press 2005, p. 203.
39. Ibid.,
40. Ibid., p.209
41. Cassirer, S. 178.
42. Ibid., S. 180.
43. Ibid., S. 215.
44. Ibid., S. 219.
45. Ibid.,
46. Hans Saner, Kants Weg vom Krieg zum Frieden, I. Muenchen: Piper,1967, S. 299.
47. Ibid., S. 300.
48. Abdallah Laroui, Islam et Modernité, Paris : La découverte 1987, p. 127.
49. Hans Kueng, Josef Van Ess, Christentum und Weltreligionen. Islam, Guetersloher Verlagshaus, 1991, S.67
50. Ibid., S. 76
51. Pierre Bourdieu, Les abus de pouvoir qui s’arment ou s’autorisent de la raison, in : Pierre Bourdieu, Contre–feux : Propos pour servir à la résistance contre l’invasion néo–libérale. Paris : Raisons d’agir, 1998, pp. 25–26
52. Hans Kueng, Josef Van Ess, Ibid., S. 76
53. Michael Walser, The Paradox of Liberation: Secular Revolutions and Religious Counterrevolutions. New Haven: Yale University Press, 2015
54. Rolf Elberfeld, Kants Tugendlehre und buddhistische Uebung. Auf dem Weg zu einer kulturoffenen und kritischen Kultivierungspraxis, in: Dimensionen der Selbstkultivierung. Beitraege des Forums fuer Asiatische Philosophie, Marcus Schmuecker, Fabias Heubel (Hg.), Freiburg: Alber 2013, S. 40.
55. Ibid., S. 47.
56. Ibid.,
57. Sophie Nordmann, De l’éthique a la religion de la raison : Hermann Cohen lecteur de Kant, in : Haskala et Aufklaerung. Philosophes juifs des Lumières Allemandes, Revue Germanique internationale, 9- 2009, p. 192.
58. Hermann Cohen, Die Religion der Vernunft aus dem Quellen des Judentums, Leipzig: Gustav Fock 1919, S. 15.
59. Ibid., S. 19.
60. Emmanuel Levinas, “Une religion d’adultes”, in Difficile liberté : essais sur le judaïsme, Paris : libre de Poche, 1984, p. 36.
رشيد بوطيب
أكاديمي وكاتب مغربي معروف، بروفيسور في قسم الفلسفة بمعهد الدوحة للدراسات العليا بقطر. درس الفلسفة وعلم الاجتماع والعلوم السياسية بجامعة ماربورغ، وأنجز دكتوراه في الفلسفة، حول الفيلسوف إيمانويل ليفيناس، بجامعة غوتة- فرانكفورت. آخر إصداراته باللغة الألمانية: “فلسفة صغيرة للجوار” (2022)”.