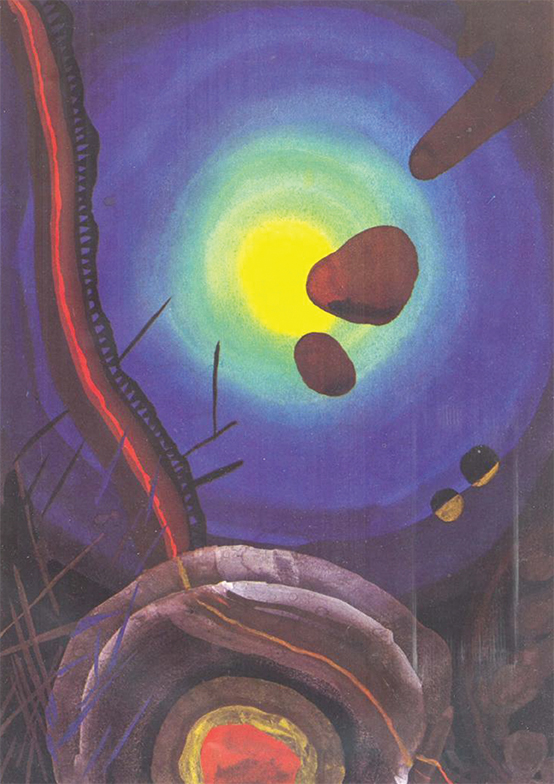أولًا: في تلقي الفكر العربيّ للفلسفة النَّقديّة الكانطيّة1
ليس الغرض مِن هذه الورقة البحثيّة تحليل كتاب كانط: “تأمُّلات في التَّربية”، وإنَّما الوقوف، من جهة، عند كيفية تلقيه في الفكر العربيّ المُعاصر، باعتباره جزءًا من الفلسفة النّقديّة الكانطيّة الّتي انفتح عليها الفكر العربي منذ بداية القرن العشرين، ولا يزال يُقبل عليها، وذلك سواء من حيث التعليم والتدريس في الجامعات والثانويات العامة والخاصة، ولا سيما في أقسام الفلسفة أو من حيث التأليف أو ترجمة نصوصها من الفرنسية والإنجليزية والألمانية، أو التوظيف والتأويل والاستعمال، أو النشر في الكتب أو المجلات أو الصحف، أو الندوات والملتقيات الثقافية والفكرية، ومنها على وجه خاص ما نظمته بعض الجمعيات الفلسفية في البلدان العربية.
تحميل المقال
وأما من جهة ثانية فهو مُسَاءلَةُ طريقة تعامل هذه القراءات مع القضايا الأساسية التي طرحتها هذه التأملات، ولا سيما تلك القضايا التي تتسم بالراهنية، ومنها على وجه التحديد قضية علاقة التربية بالانضباط والحرية، والإكراه أو القسر والطاعة، والعلاقة بين التربية الأخلاقية والدينية والجنسية والمواطنة، أو بعبارة موجزة علاقة التربية بالتنوير. وإذا كنا نعلم اليوم أن حركة انتقال الأفكار بين الثقافات، تحكمها آليات وقواعد مختلفة، ومنها تلك المتعلقة بسياق إنتاجها، وظروف تلقيها، ودور الذات القارئة، فإنَّها تؤكد في مجملها على أن البحث عن التطابق، أو محاولة رسم معالم لما كان يسميه المنهج التاريخي الكلاسيكي بعمليات التأثر والتأثير، قد أصبح بحثًا غير مجد2.
يتكوَّن الحاضر على أساس الماضي، بل طبقًا لمخطط المستقبل أي على ضوء (المشروع) تصميمًا وتنفيذًا .. وما (المشروع) إلا رؤية لحالة مستقبلة ممكنة وممتازة.
وعليه يمكننا القول إنَّه إذا كانت بداية ظهور الاهتمام الرسمي بفلسفة كانط قد بدأت مع افتتاح قسم الفلسفة في مصر في بداية القرن العشرين3، فإنَّ هذا الاهتمام ستعرفه مختلف البلدان العربية مع نهاية الحرب العالمية الثانية، وإن كان ذلك بدرجات مختلفة، تتوافق مع استقلال البلدان العربية، وتأسيسها لمنظومات تربوية، تشتمل على تدريس الفلسفة، وتسعى إلى تحقيق بعض القيم الأساسية في فلسفة التربية، سواء تعلق الأمر بتعليم الطفل، أو تعليم الفلسفة ذاتها. وفي هذا السياق، يمكن الإشارة على سبيل المثال لا الحصر، إلى ما تضمنه برنامج تعليم الفلسفة في الجزائر في عام 1968، من عرضٍ ومناقشة لنظرية كانط في الأخلاق4. وهذا يعني أنَّه إذا كان من الصعب الحديث عن بداية أولية لاهتمام الفكر الفلسفي العربي المعاصر بفلسفة كانط، فإنَّ المؤكد أنَّه بدأ مع بداية تعليم الفلسفة في البلدان العربية، ولا سيما ضمن مبحثي المعرفة والأخلاق، ثمَّ لاحقًا ضمن مبحثي السياسة والتربية، وإن هذا الاهتمام لا يزال يعرف تناميًا على مختلف المستويات البحثية، وتشهد بعض الدراسات الأكاديمية والترجمات المتلاحقة على هذا المعطى5. وأنَّه إذا كان النصف الأول من القرن العشرين قد عرف بعض الإسهامات المحدودة، فإنَّ النصف الثاني منه، ولا سيما منذ نهايته وإلى يومنا هذا، قد عرف اهتمامًا متزايدًا، سواء من حيث التأليف أو الترجمة، ولا سيما من اللُّغة الألمانية، بحيث يمتلك القارئ العربي اليوم مدونة كانطية معتبرة6، فكيف تلقى الفكر الفلسفي العربي المعاصر آراء كانط في التربية؟
ثانيًا: منزلة التّربية في التّلقي العربيّ لفلسفة كانط
لا يمكن فصل كتاب كانط “تأملات في التربية” عن بقية أعماله التي تُرجمت إلى اللّغة العربيّة التي تَعرّف عليها القارئ العربيّ منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وذلك عندما ترجمها بتصرف أستاذ بالجامعة المصرية عن اللّغة الإنجليزية7، كما نقرأ عنها تعليقًا قيِّمًا في نهاية الستينيات8، وشرحًا مفصَّلًا لأفكارها في نهاية السبعينيات9، ثمّ تعزَّزت بترجمتين للنصّ الأصليّ في بداية القرن الواحد والعشرين10، رافقتها مجموعة هامة من الدّراسات العربيّة الّتي تراوحت بين العرض والتّقديم، والتّحليل والنّقد، وذلك منذ عام 1979 إلى غاية اليوم11.
وإنَّ الوقوف عند طريقة قراءة “تأملات في التربية”، وأهم الأفكار المستخلصة، وعلاقتها بجملة من المسائل النظرية على رأسها مسالة التنوير أو ما يمكن وصفه بالممارسات الخطابية، يُمكِّننا من تعيين دورها في الفكر العربي المعاصر من الناحية النظرية، وأما ما تعلق بعلاقة تلك الأفكار بالمؤسسات التربوية العربية، أو ما يمكن وصفه بالممارسات غير الخطابية، فإن ذلك يتطلب النظر في قضية التربية الأخلاقية على وجه التحديد، مع ضرورة إجراء دراسات ميدانية بحسب المنظومات التربوية العربية المختلفة، لأنه في تقديرنا لا يستقيم الحديث عن التربية الكانطية، أو التربية على الطريقة الكانطية، وكيفية تلقيها ضمن الفلسفة النقدية الكانطية، إلَّا ضمن سياق أوسع، وعملية معقدة وطويلة شرع فيها الفكر الفلسفي العربي في تلقي الفكر الغربي منذ نهاية القرن الثامن عشر، وتحديدًا منذ الحملة الفرنسية على مصر، ولا سيما أنَّ موضوع التربية ليس موضوعًا نظريًّا بحتًا، وإنَّما هو موضوع يتصل بجوانب عمليات كثيرة، أهمها تلك المحاولات العديدة في إقامة منظومات تربوية عربيّة عصريّة، تستند إلى أُسس أخلاقيّة وفلسفيّة دقيقة12.
ففي التربية يكمن السر الأعظم لكمال الطبيعة البشرية
وفي هذا السّياق يمكننا القول إنَّ النّظريّة الأخلاقيّة الكانطيّة قد عرفت طريقها إلى الفكر العربي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وتعد الأطروحة التي قدمها محمّد عبد الله دراز عام 1947 في جامعة السّوربون -وتُرجمت إلى العربية عام 1973- رائدة في هذا المجال، ولا سيما أنَّها لم تكتف بالدراسة والتحليل، وإنما طرحت إشكالية العلاقة بين الأخلاق النظرية الكانطية، ونظرية الواجب تحديدًا، وما اصطلح عليه المؤلف بـ (دستور الأخلاق في القرآن). وعلى الرغم من الطابع النقدي الذي قدمه المؤلف فإنَّه لم يتردد في القول: “فأداء المرء لواجبه، لأنَّه واجب، دون أن يبالي بالخير الأخلاقي الذي يستهدفه، هو تعريف للإرادة المخلصة بإطلاق. ولسوف نبين أن ذلك هو المثل الأعلى للأخلاقية القرآنية”.13 ويدرك القارئ لكتاب تأمّلات في التربية14 بيسر حضور البعد الأخلاقي، ومبدأ الواجب تحديدًا في النَّصّ الذي يتكون من أربعة أنواع من التربية هي: التربية الجسمية، والعقلية، والأخلاقية (الثقافية)، والتربية العملية15. ولقد حظيت تأملات كانط في التربية بقدر كبير من العرض والتحليل في معظم الدراسات العربية، ولا سيما أنها تمثل: “رحيق خبرته كأستاذ جامعي، ومربٍّ قدير، شغلته مشكلة التربية في عصره، كما شغلته مشكلات المعرفة والأخلاق والسياسة على حد سواء”16. وتتسم بطابع نقدي يظهر في مستويات كثيرة، منها تلك المتعلقة بنقد لآراء باسدوف وتجربته التربوية في معهد داسو، ولا سيما من حيث إن المعهد يركز على القدرات البدينة، في حين أن مشروع كانط يهدف إلى تنمية الجانب الذهني، والأخلاقي، والعملي. كما تشهد هذه الخواطر والتأملات عن علاقة كانط بالمجتمع، وتقدمه، وبالإنسان وازدهاره.
وحاولت مختلف القراءات استخلاص ما اسماه أحد الباحثين بـ(ميتافيزيقا التربية)17، أو جملة المبادئ الموجهة للتربية، ومنها الانضباط والعمل، والانضباط والحرية سواء من حيث تكاملها أو تناقضها، بحيث يظهر التكامل في شخصية المواطن، “الصالح على المستوى الاجتماعي القومي، والإنسان المبدع على صعيد الانتماء إلى الإنسانية قاطبة”.18 إن الانضباط هو الدعامة الأولى في التربية، ويلزم عنها الطاعة؛ طاعة التلميذ بالإرادة أو بالقسر: “كونه مواطنًا صالحًا، حتّى وإن لم ترُق له”19. والسّؤال الذي يطرح هو: كيف نوفق بين قسر مشروع، وبين ممارسة الحرية؟ لا يعول كانط كثيرًا على التهذيب، لأنه “لا يعدو كونه طلاء مظهريًّا للشخصية، لا يحقق الهدف المقصود من التربية”20. لذا بدلًا مِن التَّهذيب، يجب الإقرار بالعمل.
الإنسان إذ يعدل العالم، يعدل ذاته، وإذ يستثمر العالم فهو يستثمر طاقته وقدراته سواء بسواء
يقول كانط: “الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي يجب أن يعمل”21، وهو ما يعني أن كانط ينتقد فكرة تفضيل روسو وباسدوف للعب. ففي العمل تحويل للمادة، وإنجاز للوظيفة، ثمّ لأن العمل “يمثل الذاتية والحرية في الآن نفسه”22. وفي العمل: “تتحد الحرية مع الخضوع والطاعة اِتحادًا تأليفيًّا”23. وبهذا المعنى يكون كانط سابقًا لفختهِ وهيغل وماركس، لأنه يرى: أن “الإنسان إذ يعدل العالم، يعدل ذاته، وإذ يستثمر العالم فهو يستثمر طاقته وقدراته سواء بسواء”24. وهو ما يعني أن العمل هو التركيب بين الحرية والحتمية، وبين الحاضر والمستقبل الذي تنشده كل تربية جديرة بهذا الاسم، وسنده في ذلك أطروحة أساسية تقول: “لا يتكوَّن الحاضر على أساس الماضي، بل طبقًا لمخطط المستقبل أي على ضوء (المشروع) تصميمًا وتنفيذًا .. وما (المشروع) إلا رؤية لحالة مستقبلة ممكنة وممتازة”. (ص119 من الترجمة الفرنسية).
وإذا كان معلومًا أن أسئلة كانط الثلاثة مقرونة بالسؤال الرابع: ما الإنسان؟ فإن كتاب التأمّلات في التّربية، تُسهم في الإجابة عليه، لأن معرفة الإنسان ليست كمعرفة أي شيء من الأشياء، بل تتمثل في تشكيل شخصيته ليؤدي مهمته على المستويين الوطني والعالمي. ولا غرو “ففي التربية يكمن السر الأعظم لكمال الطبيعة البشرية”. (74 الترجمة الفرنسية)، ولكن لتحقيق ذلك يجب نقد التربية التقليدية الّتي تُضحي بالفهم والخيال من أجل الذاكرة، لا يجب فرض استظهار النصوص عند الطفل. يقول: “التذكر أمر ضروري، ولكن لا يناسب الطّفل أن نجعل منه تمرينًا دائمًا بحيث يحفظ خُطبًا بأسرها، وقصائد بطولها عن ظهر قلب” (112 الترجمة الفرنسية). وأن تفضيل الذّاكرة إخلال بالتوازن بين المَلكات، لأنها نشاط سلبي يقوم على التكرار والترديد. يقول: “ينبغي اِستثمار الذاكرة منذ نعومة الأظفار، ولكن ينبغي كذلك، وفي الآن نفسه اِستثمار الفهم، ولا يخفى أن ركون المرء إلى الذاكرة يميل به إلى السهل، وينزع به– رغم ظاهر الأمر- إلى الاِهمال والاتكال، وقد يفضي الإفراط في الاعتماد عليها إلى “عشق الآلية”، و”طمس القُدرات الإبداعيّة” (112 من التّرجمة الفرنسيّة). والتحرر من الذاكرة، يعني التَّحرر مِن أغلال اللَّفظيّة. الذاكرة هي وسيلة لتحديد الواقع. ولا تزال تربيتنا في العالم العربي تهتم بالذاكرة على حساب الفهم والخيال. والتربية الفكرية يتحتم أن تكون في المَقام الأول مُمارسة الذكاء، وليس ثمّة ملكة أخرى تقوم مقامه. الفهم ضروري للإنسان ليحيط بكلّ ما يتعلمه وما يقوله، ولكي يردده دون دراية” (117). ما العلاقة بين القاعدة المجردة وممارستها؟ القاعدة والممارسة معًا. ما مفهوم الممارسة عند كانط؟ على الطفل أن يبني أفكاره بنفسه، على الطريقة السّقراطية، بدلًا من أن يتقبّلها جاهزة من الخارج، وهو ما ينطبق بشكل خاص على الفلسفة كما سأبين لاحقًا.
أنْ يُفكِّر المرء بنفسه يعني أنَّه يبحث عَن المَحك الأسمى للحقيقة في ذاتهِ، أي في عقله هو. والقاعدة القائلة بأن يفكِّر المرء بنفسه إنَّما هي الأنوار
يُهيَّأ الطّفل تربويًّا بالعمل، أو لعلّ الأفضل بالممارسة “بانخراط الطفل في العمل، يخضع للإكراه والقسر، ويمتثل لانضباط المدرسة”. ومع النشاط الذاتي يتحوّل القسر الخارجي إلى قسر داخلي. وتتحول الطاعة من طاعة الغير إلى طاعة الذات، وعندها يكتشف الحرية، ويحقق استقلاله الذاتي لإرادته. وتعمل التربية الأخلاقية من أجل صياغة الخُلق، أي أن يُنجز الفعل بإدراكه للأسباب: “الطفل يجب أن يسلك طبقًا لقواعد يدرك بنفسه ما تنطوي عليه من عدالة”. (124 من الترجمة الفرنسية). على المربّي أن يتجنب قدر الإمكان، فكرة ربط معاملة الطفل وفقًا لقاعدة الثواب والعقاب. ثمّ إنه بعد إدراك الأسباب والعدل، فإن القيمة الثالثة هي الصّدق، يستند ذلك إلى الكتاب المُقدس، الشر لم يدخل إلى العالم بواسطة الجريمة، وإنما بواسطة الكذب؛ الكذب هو المدخل إلى كلّ الشّرور. وعليه فالصّدق هو السّمة البارزة في الخلق. والسمة الثالثة في التربية الأخلاقيّة هي الرُّوح الجماعيّة. إذًا ثلاث فضائل تكوّن الخُلق: الطّاعة، والصّدق، وروح الجماعة. أي: أن يضع الإنسان نفسه موضع الآخرين. والتنشئة الاجتماعية لا تقوم على التَّعاطف فقط، وإنما على احترام حقوق الآخرين. والاهتمام بكرامة الطّفل يقتضي أن نحفظ كبرياءه، وألا نفسده بالدلال المُسرف (كما هو حال التربية في بعض البلدان العربيّة).
وإذا كانت قراءة فتحي الشّنيطيّ تعتمد مُقاربة ميتافيزيقية، أي: باستخلاص المبادئ العامة، فإن كثيرًا مِن الدِّراسات العربيّة، فضّلت العرض والتّحليل والشرح، ولعلّ أهمها دراسة عبد الرحمن بدوي،25 الّتي تُعد شرحًا مُفصلًا لآراء كانط في التربية معززًا بترجمة نصوص من الألمانيّة والفرنسيّة، وبمقدمة تاريخيّة تناولت جهود كانط في التربية، وعلاقته بآراء باسدوف وروسو التربوية، وأوضاع التربية في ألمانيا في القرن الثامن عشر، وظروف نشر كتاب تأمّلات في التّربية الّتي هي عبارة عن ملاحظاته أثناء تدرّيسه لمادة التربية في جامعة كينسبورغ لمدة أربعة فصول26. وعلى ما يبدو فإن نشر هذه التَّأمّلات ناتجٌ عن النقد الذي وجهه هردر وهامان لكانط، وقد تولى تلميذه رانك نشرها في عام 1803، أيّ قبل سنة من وفاته27. كما أنها كانت نِتاجًا لما هو مَطروح في زمانه، ولا سيما ما يعرف بتجربة باسدوف التربوية. يقول كانط: “والمدرسة التجريبية الوحيدة التي على نحوٍ ما بدأت شقّ الطّريق، هي معهد دساو. ويجب علينا أن نُسلّم له بهذا المجد، على الرغم من الأخطاء العديدة التي يمكن أن يُلام عليها، وهي أخطاء تعثر عليها في كلّ التَّفكيرات الّتي تتم ابتداء من التَّجربة والمحاولة، ومَردها إلى أنّه لا بدّ مِن القيام بتجارب جديدة. وعلى نحوٍ ما، يمكن أن يُقال إنه كان المدرسة الوحيدة التي كان للمعلمين فيها حرية العمل تبعًا لطرقهم الخاصة وخططهم الخاصة، وكانوا متّحدين فيها فيما بينهم، ومع كلّ علماء ألمانيا”. (ص85، ترجمة فليننكو).
أجرى عبد الرّحمن بدوي مُقارنةً أوليّة بين آراء باسدوف وكانط، خلص فيها إلى أنّ: “الجزء الأهم والمشترك بينهما هو التّربية الأخلاقيّة” (ص10، المَرجع السَّابق). لكن في الوقت الّذي يُعطي فيه باسدوف الأوليّة للدّين، يرى كانط أنَّ الأولوية للواجب الأخلاقيّ، مُقِدمًا بذلك التَّربية الأخلاقيّة على التّربية الدّينيّة.
يقول كانط: “يجب أن تقوم التّربية الأخلاقيّة على قواعد (Maximen) أخلاقيّة، لا على الانضباط (Disciplin)؛لأنَّ الانضباط يمنع النقائص، أما التّربية الأخلاقيّة فتربيّ طريقة التّفكير. ويجب أن نعمل على تعويد الطَّفل أن يفعل وفقًا لقواعد أخلاقيّة، لا بحسب دوافع (Treibfedern) معينة. إنه لا يبقى من الانضباط غير عادة تنمحي على مر السنين. ويجب على الطّفل أن يتعلّم أن يفعل وفقًا لقواعد أخلاقيّة يُدرك بنفسه أنّها عادلة، ومن البيّن بغيرِ عناء أنَّ هذا الأمر مِن العسير الحصول عليه عند الطِّفل، وتبعًا لذلك فإنَّ التربية الأخلاقيّة تفترضُ كثيرًا مِن التنور من جانب الآباء والمعلمين” (بدوي، ص144، الترجمة الفرنسيّة 124). كيف العمل بالعقوبات والثّواب؟ مُتأثرًا بروسو الّذي يقول “لا عقاب بعد الآن”، يرى كانط أنّه إذا أثبتنا الفعل لفعل الخير، فإنّه سيرى في الخير مُجرد وسيلة، من أجل المكُافاة، لا من أجل الخير ذاته. إنَّ العقاب والثّواب يجب أن يكون أخلاقيًّا، لأنه في الحياة الاجتماعيّة، ليس ثمّة علاقة مباشرة بين فعل الخير والثّواب، أو فعل الشَّر والعقاب، لذا فإنَّ الأفضل هو الثّواب والعقاب الأخلاقيّ، ففي حالة الكذب يكفي نظرةُ الاحتقار، أو رفضُ رغبة الطَّفل. عرض لأهم الأفكار الّتي قدمها كانط، مع ترجمة لنصوصه، والخاتمة خارجةٌ عن الموضوع، تتحدث عن علاقة ما بعد الكانطيّة، والكانطيّة الجديدة، وتفضيل موقف هايدغر. لا علاقة للخاتمة لا بالدين ولا بالتربيّة. والكتاب لا مقدمة له، مجرد عرض لا غير. وتنفرد دراسةُ علي وطفة في تناولها: “الفكر التّربويّ الأخلاقيّ عند كانط”، بطريقة مَنهجيّة نقديّة، وقد وجدنا- كما يقول- أنّه مِن الضَّروريّ العمل على فهم العقليّة الكانطيّة ضِمن تصوُّر نقديّ تحليليّ يمكن أن يستكشف الأبعاد الأخلاقيّة والتّنويريّة في فكر هذا الفيلسوف في سياق رؤيّة تكامليّة تفكيكيّة، نُحاول فيها أن نَستكشف الأبعاد الحقيقية للبيداغوجيا التّربويّة الأخلاقيّة عنده. وإذا كانت هذه الدّراسة تستعيد مُختلف أفكار كانط في التّربية، فإنَّها توّسعت كثيرًا في دراسة سيرة الفيلسوف، ومراحل فلسفته، ومشروعه التّربويّ المُتمثل في مفهوم الطّبيعة الإنسانيّة، ودور التّربية الأخلاقيّة، وموقف كانط مِن التّربية في عصره، وتحليل المَعالم التّربوية عنده، وصلة التّربية بالتنوير والسّلام، والجنس. ولعلّ ما تجدر الإشارة إليه، ولا سيما في موضوع التّربية الجنسيّة، هو كونه يدعونا إلى مُناقشة هذه القضية، لأنه: “بالصّمت لا نزيد الشر إلا تفاقمًا، وهذا ما تدلّ عليه تربية الأجيال السابقة، وفي التربية في عصرنا الحاضر، يُقرّ عن حقّ بضرورة التّكلم عن هذه الأمور مع الفتى المُراهق، دون لف ولا دوران، وبوضوح ودقة. ومن الواضح أنَّ هذه نُقطة دقيقة، لأنَّ الناس لا يرضون بالكلام فيها عن طيب خاطر في مُحادثة علنيّة، لكن كلّ شيء سيكون حسنًا إذا كان الكلام في هذه الأمور يتم بطريقة لائقة وجادة”28. ومما لا شك فيه أن موضوع التربية الجنسيّة يُشكّل إحدى المواضيع المُعقدة المطروحة على التَّربية في العالم العربيّ، وإنَّ موقف كانط يتسم بالواقعيّة والمعقوليّة: “في مسألة مكاشفة المراهقين بالقضايا الجنسيّة، والتَّصريح بأهمية الكشف التَّدريجيّ لِمختلف إشكاليات هذه المسالة وتعقيداتها. وكان متوافقًا مع التَّربية الحديثة اليوم الّتي ترى أنَّ الإبقاء على حالة الجهل لدى المراهقين من أكبر الأخطاء الّتي يرتكبها الآباء والمعلمون”29.
التربية الفكرية يتحتم أن تكون في المَقام الأول مُمارسة الذكاء، وليس ثمّة ملكة أخرى تقوم مقامه. الفهم ضروري للإنسان ليحيط بكلّ ما يتعلمه وما يقوله، ولكي يردده دون دراية.
وتميَّزت بالطرح النَّقديّ لأفكار كانط التَّربويّة، ولم تتردد في طرح مسألة العُنصريّة العرقيّة في الفلسفة الكانطيّة التي تظهر، بحسبه: “في تصنيف الأجناس البشريّة بحسب المَعايير العرقيّة، وفق سلّم سيكولوجيّ فيزيائيّ يحتل فيه أصحاب البشرة البيضاء المكانة العليا في مراتب التَّفوق والذّكاء، مُشيرًا إلى أنَّهم أكثر الأنواع البشريّة ذكاء وفاعلية ومقدرة على بناء الحضارات، ثمَّ يأتي أصحاب اللون الأصفر في الدَّرجة الثَّانية، ويأتي أصحاب البشرة السَّوداء في الدَّرجة الثَّالثة، وفِي الأسفل الهنود الحُمر30… . وتظهر هذه العُنصريّة في كتابهِ: الإحساس بالجميل والجليل”، يقول فيه: “زنوج القارة الإفريقيّة، بطبيعتهم، لا يملكون إحساسًا يدفعهم للارتقاء فوق التّفاهة والوضاعة. يتحدّى السّيّد هُيوم أن يأتي أحد بمثال واحد على زنجي أظهر أدنى قدرٍ من الموهبة. وبالرّغم من أن كثيرًا من البيض كانوا من طبقات فقيرة، فإنّهم استطاعوا بمواهبهم الفذة نيل مكانة مُحترمة في العَالم”31.
وبهذا المَعنى يصح القول إنَّ فلسفة كانط العمليّة “مثل العُملة ذات الوجهين، تُقدّم الجانب الأبيض، المُكتسب بشكلٍ طبيعيّ مِن خلال التَّقدم في تاريخ البشريّة، وجانب الإنّسانيّة الوحيدة المُنجزة حقًّا، والجانب المُظلم الّذي تشغله أعراق أُخرى هدفها إما أنّ تكون عديمة الفائدة أو تكون أدوات لتاريخ الإنسانيّة البيضاء”32. وثمَّة مَقاطع في كتابيه: “الجغرافيا الفيزيائية”، والأنثربولوجيا مِن وجهة النّظر البراغماتيّة تؤكّد هذا التّوجه33، وتتعارض كليًّا مع مفهومهِ للأخلاق، والكونيّة، وللتربية، ولا سيما التَّربية المُستندة إلى الطَّبيعة. ومع ذلك، فإنَّ المؤلف يصبغ على موقف كانط طابعًا نسبيًّا مسوغًا إيّاه بالسياق التَّاريخيّ. يقول: “مع أهميّة ما أدرجناه من تحليل نَقديّ للموقف العُنصريّ الكانطيّ إلا أنَّه لا يمكننا أن نتجاهل تأثير السّياق التَّاريخيّ في إضفاء الطَّابع العُنصريّ على التفكير الكانطيّ، ومثل هذا الإقرار بأهمية السّياق التَّاريخيّ للعُنصريّة في أوروبا، يُعطينا فرصةً مُهمة في تفسير التَّعارض المُشار إليه بين سموّ كانط الأخلاقيّ وانحطاطه العُنصريّ، ويساعد في حلّ الإشكال، أو على الأقل التَّخفيف من حدّته، كما يُمكِّن من المُساعدة على قراءة فكر هذا الفيلسوف بطريقةٍ لا تُفقد فلسفته الأخلاقيّة وميضها وألقها المعهود”34.
ثالثًا: بين التّربية والتَّنوير
يقول كانط:
“أنْ يُفكِّر المرء بنفسه يعني أنَّه يبحث عَن المَحك الأسمى للحقيقة في ذاتهِ، أي في عقله هو. والقاعدة القائلة بأن يفكِّر المرء بنفسه إنَّما هي الأنوار. وهي في سبيل ذلك لا تتطلَّب من الجهد قدر ما يتخيله الذين يرون الأنوار في المعارف، لأنّ الأنوار هي بالأحرى مبدأ سالب في اِستعمال قدرتنا على المعرفة. والشَّخص الغزير المَعارف يكون في العَادة هو الأقل استنارة في استخدامها. فاستعمال المرء لعقلهِ هو لا يعني سوى أن يتساءل هو بالذات وفي كلّ شيء ما الذي ينبغي قبوله: هل مِن المُناسب أن نجعل مِن الأساس الّذي بمقتضاه نقبل شيئًا ما، أو مِن القاعدة المترتبة على ما نقبله، مبدأ كليًّا في استعمالنا للعقل إنَّ إرساء التَّنوير لدى بعض الذَّوات هو إذن أمر سهل، يكفي أن نُعوِّد الشُّبان في وقت مبكِّر على هذا النَّوع مِن التَّفكير. ولكن أن يستنير جيل بأكمله فهذه مسألة طويلة ومُضنية، فهناك عوائق خارجية تستطيع أن تمنع جزئيًّا هذا النَّوع مِن التَّربية أو أن تجعلها أكثر صُعوبة”35.
لا أُجانب الصَّواب إذا قلت إنَّ نصَّ كانط: جواب عَلى السُّؤال: ما الأنوار؟ قد لقي اِهتمامًا خاصًّا في الفكر العربيّ، ويكفي الإشارة إلى عدد ترجماته الّتي بلغت، في حدود بحثي، 12 ترجمة، وازدادت أهميته أكثر عندما علَّق عليه ميشيل فوكو في بداية الثمانينيات مِن القرن العشرين، وبلغت ترجمته هو أيضًا 7 ترجمات. كما يؤكد هذه الأهمية ما نقرأه في الترجمتين العربيتين لكتاب تأمّلات في التَّربية اللتين كانتا متبوعتين بنصّ: ما الأنوار36؟
والحق إنَّه إذا كان نصّ التَّأملات يطرح جملة من القضايا الراهنة على الفكر العربي المعاصر، وعلى الفكر العالميّ، ولكن بدرجات متفاوتة، ولا سيما تلك المُتعلّقة بعلاقة التربية بالانضباط والطّاعة والإكراه والقسر، ومسألة التربية الجنسية، ومنزلة كلّ مِن التربية الأخلاقية والدّينية، فإنَّه مِن الضَّروريّ الإشارة إلى أنَّ هذه القضايا لا تزال موضوع مُناقشة في الفكر العربيّ المُعاصر على وجه العموم. و”مما لا شك فيه أنَّ اِستحضار الفلسفة الكانطيّة في التّربية الأخلاقيّة العربيّة يُمثّل مُنطلقًا حيويًّا لاستكشاف ما تنطوي عليه هذه الفلسفة النّقديّة مِن قدرة على إثارة الوعي بقضايا الأخلاق، وبما تحمله في ذاتها مِن قُدرة على توليد الفكر التّربويّ الأخلاقيّ، وتطوير الوضعيّة النّقديّة للعقل التَّربويّ العربيّ في تناوله لِمظاهر الحياة التّربويّة في مُختلف المَجالات التّربويّة المُعاصرة”37. وتعكس القراءات العربيّة لِكتاب التَّأملات هذا التَّوجه العام، وتُشير في الوقت نفسه إلى مجموعة مِن السِّمات، منها:
إن الانضباط هو الدعامة الأولى في التربية، ويلزم عنها الطاعة؛ طاعة التلميذ بالإرادة أو بالقسر: كونه مواطنًا صالحًا، حتّى وإن لم ترُق له. والسّؤال الذي يطرح هو: كيف نوفق بين قسر مشروع، وبين ممارسة الحرية؟ لا يعول كانط كثيرًا على التهذيب، لأنه “لا يعدو كونه طلاء مظهريًّا للشخصية، لا يحقق الهدف المقصود من التربية. لذا بدلًا مِن التَّهذيب، يجب الإقرار بالعمل. يقول كانط: “الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي يجب أن يعمل، وهو ما يعني أن كانط ينتقد فكرة تفضيل روسو وباسدوف للعب.
(1)- يمكن القول إنَّ التَّيار الوجوديّ والمِثالي في الفكر العربيّ المُعاصر، مُمثلًا بزكريّا إبراهيم وعبد الرّحمن بدوي، وعثمان أمين، من الرّواد في دراسة كانط، وترجمة بعض أعماله إما ترجمة مباشرة أو غير مباشرة، كاملة أو مختصرة. وكانت الغاية الأوليّة من دراساتهم هو محاولة تجاوز فكرة أن فلسفة كانط فلسفة صعبة ومُعقدة، ولا يمكن عرضها عرضًا سهلًا ومبسطًا، وهو ما ذهب إليه زكي نجيب محمود في كتابه الصَّادر عام 1936، بعنوان: قصّة الفلسفة الحديثة. يقول فيه: “فإن أردت أن تقرأ كانط، فآخر ما يجب أن تقرأه هو كانط نفسه، لأنه لم يعمد إلى السُّهولة والوضوح…”38. وفي رده على هذا الطَّرح يقول زكريا إبراهيم: “نجد في الكثير من مؤلفاته نَصَاعة فكريّة قلما نَعثر على نظير لها لدى غيره مِن فلاسفة العصر الحديث”39. ومن هنا الدّعوة إلى العودة إلى نصوصه: “من أجل الوقوف على الطريقة المنهجية التي اصطنعها في تفكيره…”40. والكشف عن: “الجوانب الحيّة من تفكير هذا العملاق الضّخم”41. وأنَّ مَنهجه يقتضي: “من ناحية ربط الفلسفة الكانطيّة بما عداها مِن فلسفات حديثة تقدمت عليها، كما يستلزم من ناحية أخرى تبين العناصر الجديدة في الثورة الكبرنيقية الكانتية على نحو ما عبر عنها صاحبها حين أراد للكون كله أن يدور حول الإنسان”42. وعزز هذا التّوجه الأكاديميّ كلّ مِن عُثمان أمين ومَحمود زيدان وعبد الرَّحمن بدوي وغيرهم كثير43.
(2)- يمكن التَّأريخ لتلقي كانط في الفكر العربيّ المُعاصر بالعقد الثّاني مِن القرن العشرين، ثمّ تَعزز حضوره في الوسط الأكاديميّ بعد الحرب العالميّة الثّانية، عندما تأسست الأقسام الفلسفيّة في كثير مِن البلدان العربيّة، وتدريس الفلسفة في المراحل الأخيرة من التَّعليم الثَّانويّ، وتكثّف هذا الحضور مَع تراجع الهيمنة الأيديولوجيّة على المُناقشات الفكريّة والفلسفيّة في نهاية السَّبعينيات وبداية الثّمانينيات، بحيث يمكننا القول الآن إنَّ ثمة انبعاثًا في الدَّراسات الكانطيّة العربيّة سواء مِن حيث الدِّراسة، أو التّرجمة، أو التّوظيف، ولا سيما في قضايا الأخلاق، و الحرية، والمواطنة، والكونية، والنَّقد، أو قضايا التّنوير عَلى وجه العموم.
(3)- مما لا شك فيه أنَّ قراءة الفكر العربيّ المُعاصر لفلسفة كانط تعكس الحاجة الفلسفيّة إلى هذه الفلسفة، وأنّ هذه الحاجة قد تنوّعت واختلفت باختلاف أسئلة النِّصف الثَّاني مِن القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين، فإذا كانت هذه الحاجة يغلب عليها الطَّابع الأكاديميّ والمعرفيّ والأخلاقيّ إلى غاية نهاية سبعينيات القرن العشرين، فإنَّه مُنذ الثَّمانينيات قد ظهرت الحاجة السّياسيّة، مَع إرادة واضحة في المعرفة الدّقيقة بنصوص الفلسفة النّقديّة. ولقد توسع أفق القراءة العربيّة لكانط، عندما حاولت تجاوز قراءة ما بعد الكانطيين، ولا سيما هيغل الذي عرفه الفكر العربيّ مُلازمًا للفكر الماركسيّ الذي شكّل تيارًا فلسفيًّا وإيديولوجيًّا مهيمنًا منذ الخمسينيات وإلى غاية سبعينيات القرن العشرين، والتفت إلى فلاسفة الكانطيّة الجديدة، بالمعنى الواسع للكانطيّة الجديدة الّتي تشتمل على مجموعة من الأسماء الفلسفيّة المُعاصرة، على رأسهم: أرنست كاسيرر، ويورغن هابرماس، وجون رولز، وميشيل فوكو، وقبلهم الفكر البنيويّ الذي شكل تيارًا نقديًّا في الفكر العربيّ المُعاصر.
(4)- إذا كانت القراءات العربيّة يغلب عليها العرض والتّحليل والتَّقديم والتّكرار، فإنَّ ثمّة دراسة قد انفردت بنقد بعض جوانب فكر كانط التربوية، وركَّزت في نقدها على ما عرفته النَّظريات التَّربويّة مِن تطور منذ القرن الثَّامن عشر إلى يومنا هذا، وكذلك مُختلف الآراء النَّقديّة التي وجهت لنظرية الواجب باعتبارها أساس التربيّة الأخلاقيّة عند كانط، مستندة في ذلك على آراء الفلاسفة والدارسين الغربين الّتي وصفت التَّأملات الكانطيّة في التّربية بالتزمت الأخلاقيّ، ولا سيما في نظريات علم النَّفس التّربويّ التي تؤكد: “بصفة مبدئية إن كلّ أشكال الضَّغط والإكراه والتّسلط الّتي يعانيها الطّفل في السَّنوات الخمس الأولى من حياته ستؤثر سلبًا في ذكائه وتكامل شخصيته وسعادته”44. ثمّ إن التربية الحديثة: “تقوم على مُراعاة حرية الطّفل ورغباته وميوله، وتراها ضرورة حيوية في تحقيق التوازن الأخلاقيّ والإبداعي عند الأطفال”.45ويظهر الطّابع المتزمت للتربيّة عند كانط في موقفه مِن اللّعب : “إذ وجه نقدًا شديدًا وسخريةً لاذعةً ضد التربويين الذين رأوا أنّ تعلّيم الأطفال يمكن أن يتم من خلال اللّعب”46. ولكن مهما كانت درجة حضور التّأملات التربويّة في الفكر العربيّ المُعاصر، فإنَّه لا يقارن بحضور فلاسفة التربية، ومنهم بشكل خاص جان جاك روسو، وجون ديوي، وجان بياجيه على سبيل المثال لا الحصر، وأمَّا معاينة حضوره في مجال المؤسسات التربوية فيحتاج إلى دراسة ميدانية، باستثناء التربية الأخلاقيّة، ومفهوم الواجب.
(5)- تُعد قضية التّنوير قضية مركزيّة في الفكر العربيّ المُعاصر، ولا تزال موضوع صراع في الثقافة العربية الحديثة والمعاصرة، يتنازعها على الأقل ثلاثة تيارات هي التّيار التّقليديّ المُحافظ، والتّيار الدّينيّ السّلفيّ الذي يغلب عليه التّشدد في كلّ مَا يتعلق بالتجديد والحداثة، والتيار التّنويريّ الذي يتسم بالهشاشة البنيويّة، ويحاول أن يجد سندًا نظريًّا في الفلسفة النّقديّة الكانطيّة سواء على المستوى المعرفيّ أو السّياسيّ أو التّربويّ، وذلك لمناقشة القضايا الرّاهنة، ومنها المَسألة الأخلاقيّة، ونظريّة الواجب الّتي بُني عليها مفهوم التّربوية عند كانط. وتعدُّ المَسألة الأخلاقيّة، مَسألة مِحوريّة في الفكر العربيّ المُعاصر، وذلك بالنظر إلى عَلاقتها بالدين الإسلاميّ. وفِي تقديريّ أنَّ مُحاولة محمّد عبد الله دراز التّوفيقيّة بين نظريّة الواجب أو الإلزام الكانطيّة وبين أخلاق القرآن الكريم، تُعدّ مُحاولة أوليّة في عملية التَّوظيف، وتستحق المُناقشة، ولا سيما مِن جهة اِعتباره أنَّ الإلزام هو: “الأساس الجوهريّ والمحوريّ الّذي يدور حوله النّظام الأخلاقي”47. وتشديده على أن يكون مَصدر الإلزام هو العقل حتّى يُصبح الإنسان مُشرِّعًا. والحق أنّه سواء اتفقنا مَع هذه المحاولة الأولويّة أو اختلفنا مَعها، فإنّها تُعد المَدخل المُناسب لتحويل فلسفة كانط إلى تيار فاعل في الفكر الفلسفيّ العربيّ المُعاصر، ولا سيما إذا اِستعان بما تُقدّمه القراءات الكانطيّة الجديدة مِن أدوات مَنهجيّة جديدة.
المصادر:
1. يمكننا اعتماد كتاب زكريا إبراهيم كبداية للكتابة العربية في فلسفة كانط، ينظر: كانت أو الفلسفة النقدية، مكتبة مصر، 1963. وترجمة عثمان أمين لكتاب إميل بوترر، كبداية لترجمة الدراسات عن فلسفة كانط، ينظر: إميل بوترو، فلسفة كانط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة- مصر، 1972، سبقتها ترجمات لبعض نصوص كانط، منها: تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، ترجمة عبد الغفار مكاوي، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة-مصر، 1965. نقد العقل المجرد، ترجمة أحمد الشيباني، دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والطبع، بيروت- لبنان، 1965. نقد العقل العملي، ترجمة أحمد الشيباني، دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والطبع، بيروت- لبنان، 1966.
2. حول التلقي يمكن العودة إلى دراستنا: في تلقي الفلسفة اليونانية في الحضارة الإسلامية، موقف عبد الرحمن بدوي (1917-2002)، في الترجمة وإشكالات المثاقفة، تحرير وتقديم عبد الحكيم شباط، منتدى العلاقات العربية والدولية، الدوحة- قطر، 2019، ص703-675. وكذلك إلى ما يراه بورديو من أن الأفكار تخضع في عملية انتقالها إلى ما يسميه بعوامل بنيوية تؤدي إلى سوء الفهم وعدم التواصل، وأهم هذه العوامل في نظره هو أن النُّصوص تنتقل دون سياقها، وتخضع النصوص المترجمة إلى عملية انتقاء مباشر وغير مباشر. يُنظر: Pierre Bourdieu, Les conditions sociales de la circulation internationale des idées, in Actes de la recherches en sciences sociales, no145, 2002, p.3-8. ويذهب إدوارد سعيد إلى انعدام القراءة: “الحيادية أو البريئة”، لأنَّ كل قارئ هو إلى: “حد ما، نتاج وجهة نظرية ما، مهما كانت وجهة النظر هذه متضمنة أو لا واعية. [وأنَّه من المهم] أن نميز النظرية عن الوعي النقدي، والقول بأن هذا الأخير نوع من ملكة القياس من أجل تعيين موقع النظرية، أو تحديد مكانها. والوعي النقدي إدراك للفوارق بين الأوضاع، وكذلك إدراك للحقيقة القائلة إنه ما من نظرية تغطي الوضع الذي نشأت فيه أو الذي تنقل إليه. وفوق كل شيء، فإ%e2%80%8cنَّ الوعي النقدي هو إدراك لنظرية المقاومات، وردود الفعل نحوها أو التفسيرات الملموسة التي تتنازع معها”. واستنتج من هذه القواعد العامة مجموعة من السمات التي تميز هذا الانتقال، وأهمها: (1)- نقطة المنشأ أو مجموع الظروف الأولية التي أبصرت فيه الفكرة أو النظرية النور، وأصبحت موضوعا للمناقشة. (2)- المسافة التي تقطعها من نقطة المنشأ إلى نقطة الوصول مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار للأشكال الضغط التي تمارسها عليها القرائن. (3)- شروط القبول في نقطة الوصول، ولا سيما أشكال المقاومة التي تواجها الفكرة أو النظرية القادمة. (4)- عمليات التحويل الجزئي أو الكلي التي ستجرى للفكرة أو النظرية من خلال استعمالاتها الجديدة. يُنظر: إدوارد سعيد، انتقال النظريات، ترجمة أسعد زروق، في: الإسلام والغرب، مقالات
3. يبدو أنَّ المستشرق الإسباني الكونت دو غلارزا كان أول أستاذ قام بتدريس كانط في الجامعة المصرية في العشرية الثانية من القرن العشرين. وحول هذا الموضوع، يُنظر ما كتبه: (1)- صلاح حسن رشيد، تدريس الفلسفة في مصر، في حال تدريس الفلسفة في مصر، مجموعة من الباحثين، إشراف عفيف عثمان، بيبلوس، 2015، ص522-485. (2)- أحمد عبد الحليم عطية، كانط في Fاضلة، تحرير سعيد البرغوثي، تقديم فيصل دراج، (دمشق: دار كنعان، 2014)، ص119-81. الفكر العربي المعاصر، في: كانط وأنطولوجيا العصر، دار الفارابي، بيروت، 2010، ص17. الدراسة الأخيرة عرض انتقائي لبعض الكتابات المصرية والعربية المخصصة لكانط، ولا تخلص إلى نتائج يمكن أن تجيب عن سؤال كيفية التلقي والقراءة والتوظيف.
4. يُنظر، محمود يعقوبي، الوجيز في الفلسفة، المعهد التربوي الوطني، الجزائر، 1968، ص96-90. وكذلك الزواوي بغورة، الخطاب الفلسفي في الجزائر: الممارسات والإشكاليات، تشخيص أولي في: الفلسفة في الوطن العربي في مائة عام ضمن أعمال الندوة الفلسفية الثانية عشرة التي نظمتها الجمعية الفلسفية المصرية بجامعة القاهرة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت -لبنان، 2002، ص409-377.
5. يُنظر على سبيل المثال لا الحصر: (1)- عبد الحق منصف، كانط ورهانات التفكر الفلسفي، من نقد الفلسفة إلى فلسفة النقد، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2007. (2)- عبد الحق منصف، الأخلاق والسياسة، كانط في مواجهة الحداثة، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2010. (3)- جيل دلوز، فلسفة كانط النقدية، ترجمة أسامة الحاج، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت- لبنان، 2008. (4)- إيمانويل كانط، الأنثروبولوجيا من وجهة نظر براغماتية، ترجمة فتحي انقزو، دار صوفيا، الكويت، 2021. (5)- مقالات في التاريخ والسياسة، ترجمة تحي انقزو، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الظعاين- قطر، 2022. (6)- إيمانويل كانط، نزاع الكليات، ترجمة فتحي انقزو، دار صوفيا، الكويت، 2023.
6. ليس غرضنا في هذه الورقة البحثية أن نحصي الكتب والمقالات المؤلفة أو المترجمة، ولكنه من الضروري الإشارة إلى بعضها على الأقل، وفق التسلسل التاريخي لصدورها ونشرها: أولًا- التأليف: (1)- زكريا إبراهيم، كانط أو الفلسفة النقدية، مكتبة مصر، 1963. (2)- زكريا إبراهيم، المشكلة الخلقية، مكتبة مصر، 1966، نظرية الواجب، 184-163. (3)- محمود زيدان، كانط وفلسفته النظرية، دار المعارف، القاهرة- مصر، ط3، 1979. (4)- عبد الرحمن بدوي، كانط، وكالة المطبوعات، الكويت، 1977. وغيرها من كتبه حول كانط. ثانيًا- الترجمة:
7. إيمانويل كانط، التربية للحكيم الألماني كانط، ترجمة طنطاوي جوهري، المطبعة السلفية، القاهرة- مصر، 1936. (تُرجم هذا النص بتصرف من نسخة إنجليزية قامت بها أنات شرتون). يُنظر: Kant on Education (Heber Padagogik), tran. Annette Churton, D.C.Heath &CO., Publishers, Boston, U.S.A, 1900.
8. محمد فتحي الشنيطي، خواطر كانط في التربية، في: دراسات فلسفية مهداة إلى روح عثمان أمين، تصدير إبراهيم مدكور، دار الثقافة، القاهرة-مصر، 1979، ص290-275.
9. عبد الرحمن بدوي، فلسفة الدين والتربية عند كانط، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت- لبنان، 1980، ص169-103.
10. يُنظر: (1)- إيمانويل كانط، ثلاثة نصوص، تأملات في التربية، وما هي الأنوار؟ ما التوجه في التفكير؟ ترجمة محمود بن جماعة، دار محمد علي للنشر، تونس، 2005. (2)- إيمانويل كانط، في التربية، وإجابة عن سؤال: ما التنوير؟ ترجمة وتقديم وتعليق جوزيف معلوف، دار الرافدين، العراق، 2022.
11. إضافة إلى الدراستين السابقتين، يمكن الإشارة إلى الدراسات الآتية: (1)- محمد الأصمعي محروس، بعض الجوانب التربوية في الفكر الفلسفي الألماني، في مجلة: دراسات تربوية، مج. 10، ج77، 1995، ص266-201. (2)- خضر حمايدي وأسماء بن الشيخ، كانط من التربية إلى السلام، في مجلة أنسنة للبحوث والدراسات، العدد الأول، جوان 2010، ص78-65. (3)- صابر جيدوري، المثالية الكانتية وأبعادها التربوية (دراسة في فلسفة التربية)، مجلة جامعة دمشق، المجلد 27، العدد الأول والثاني، 2011، ص487-445. (4)- محمد بومانة، مكانة التربية في فلسفة كانط، في التربية والأبستمولوجيا، المجلد1، العدد1، 2011، ص30-6. (5)- زهير الخويلدي، النظرية التربوية الكانطية والتأسيس البيداغوجي، في الحوار المتمدن، تاريخ النشر (25-9-2015). (6)- مالك محمد المكانين، أنثروبولوجيا التربية والتنوير في فلسفة كانط، (بحث في مفارقة الحكم للمسؤولية الأخلاقية)، في مجلة الجمعية الفلسفية المصرية، السنة 28، العدد82، ص343-313. (7)- علي يطو، التربية في المثالية الألمانية من كانط إلى هيغل، إصدار خاص بمركز نقد وتنوير للدراسات الإنسانية، رقم 9416، أفريل 2016. (54 صفحة). (9)- نسرين خليل حسين، التربية الأخلاقية عند إيمانويل كانط، في مجلة إكليل، السنة الأولى، كانون الأول، العدد 4، 2020، ص530-513. (10)- علي أسعد وطفة، التربية الأخلاقية في الفلسفة الكانطية، مكاشفات نقدية معاصرة، لجنة التاليف والتعريب والنشر، جامعة الكويت، الكويت، 2022. (509 صفحة).
12. ألبرت حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة 1798-1939، ترجمة كريم عزقول، دار نوفل، بيروت- لبنان، 2001، ص61-60. ورئيف خوري، الفكر العربي الحديث، أثر الثورة الفرنسية في توجيهه السياسي والاجتماعي، دار الساقي، ط3، بيروت- لبنان، 2013، ص64 وما بعدها.
13. محمد عبد الله دراز، دستور الأخلاق في القرآن، دراسة مقارنة للأخلاق النظرية في القرآن، تعريب عبد الصبور شاهين، مؤسسة الرسالة ودار البحوث العلمية، القاهرة- مصر، 1973، ص111.
14. في حدود اطلاعنا، ثمّة ثلاث ترجمات لكتاب تأملات في التربية: 1- كتاب التربية للحكيم الألماني كانط، ترجمة طنطاوي جوهري، المطبعة السلفية، 1935. 2- ثلاثة نصوص، تأملات في التربية، وما هي الأنوار؟ ما التوجه في التفكير؟ ترجمة محمود بن جماعة، دار محمد علي للنشر، تونس، 2005. 3- في التربية، وإجابة عن سؤال: ما التنوير؟ ترجمة وتقديم وتعليق جوزيف معلوف، دار الرافدين، 2022. الأولى مترجمة عن الإنجليزية بتصرف، والثانية والثالثة عن الفرنسية مترجمة من قبل المختص في الفلسفة الكانطية الكسي فيلولنكو، 1996، وهو ما يبين تأخر صدور النص في العربية، مع أن ترجمة بعض نصوص كانط سابقة لهذا التاريخ، وعمليًا يمكننا القول أن كانط عرف في الفكر العربي من خلال الفرنسية، والإنجليزية، ولاحقًا من الألمانية.
15. هنالك اختلاف في توزيع المواضيع بين الترجمتين العربيتين المشار إليهما، وكذلك في المصطلح بشكل واضح، تشير الأولى إلى التربية الجسمية وتقسمها إلى ثلاثة عناصر: تربية الجسم، التربية العقلية، التربية الثقافية، وثانيًا: التربية العملية، إما الترجمة الثانية فتقسم النّصّ إلى ستة فصول: في التربية، التنشئة الجسدية، التنشئة الفكرية، التنشئة الأخلاقية، التربية العملية. وإذا كانت الترجمة الأولى تتبع النص الفرنسي، فإن الثانية تمزج بين النص الألماني والفرنسي.
16. محمد فتحي الشنيطي، خواطر “كانط” في التربية، ص275. اصطلح هذا الباحث على قراءته “ميتافيزيقا التربية”، لأنها تعتمد مفهوم كانط في الميتافيزيقا وهي: “الضوابط العقلية العامة لدراسة من الدراسات، سواء في الجانب العادي الخالي من الإرادة أو في المجال الإنساني المستند إلى الإرادة”. ص275.
17. المرجع السابق، ص278.
18. المرجع السابق، ص278.
19. المرجع السابق، ص278.
20. المرجع السابق، ص279.
21. المرجع السابق، ص279.
22. المرجع السابق، ص280.
23. المرجع السابق، ص280.
24. المرجع السابق، ص281.
25. عبد الرحمن بدوي (1917-2002)، له أكثر من كتاب عن كانط: 1- إمانويل كانط، وكالة المطبوعات، الكويت، ط2, 1977. 2- الأخلاق عند كانط، وكالة المطبوعات، الكويت، 1979. 3- فلسفة القانون والسياسة، وكالة المطبوعات، الكويت، 1979.
26. عبد الرحمن بدوي، فلسفة الدين والتربية عند كنت، ص103. هردر، ما بعد النقد؟
27. العنوان الأصلي لهذه التَّأملات هو: في التربية. يتكون من ثلاثة أقسام: ملاحظات تمهيدية، بحث، ملاحظات ختامية. القسم الثاني يتناول نظرية التربية، ويناقش الإنسان بوصفه كائنًا طبيعيًّا حرًّا في التربية الفيزيائية والعملية. في تدريسه اعتمد على كتاب: بازدوف(Basedow)، أسس في مدينة دساو معهدًا تجريبيًّا للتربية، يضم معهدًا لتكوين المعلمين، ومدرسة لتعليم التلاميذ، في عام 1774 نشر كتابه الموسوم: المتن الأولي في التربية ويتكون من أربعة أجزاء (وملحق به صور تُعين التلاميذ على معرفة الأشياء في الوقت نفسه) وينادي بازدوف بالطريقية العيانية (intuitive)، وتتكون من: 1- استخدام الصور والبيانات كل ما أمكن ذلك. 2- الاهتمام بالصحة. 3- تجريد التربية الدينية من كل صبغة مذهبية. 4- التقليل من استخدام الذاكرة. (عبد الرحمن بدوي، ص107). كما استُخدم اللعب، واستمر المعهد نحو عقدين من الزمان (1774-1793). وكان لهذه التجربة أثر كبير في أوروبا. وتعتمد هذه النظرية التربوية بحسب بعض الدّارسين (بنلوش) على ثلاثة مبادئ كبرى: 1- إعطاء الأولوية للجانب الوطني مقارنة بالجانب الديني، أو في استقلال عن الدين. 2- الاعتماد على المنفعة. 3- الطريقة الحسية العيانية.
28. عبد الرحمن بدوي، فلسفة الدين والتربية عند كانط، مرجع سابق، ص161.
29. علي أسعد وطفة، التَّربية الأخلاقيّة في الفلسفة الكانطيّة، مرجع سابق ص317.
30. نقلًا عن حسن العاصي، علي أسعد وطفة، التَّربية الأخلاقيّة في الفلسفة الكانطيّة، مرجع سابق ص411. (عنُصريّة الفلسفة…).
31. نقلًا عن كانط، علي أسعد وطفة، في التّربية الأخلاقيّة في الفلسفة الكانطيّة، مرجع سابق ص413. يُنظر أيضًا: Kant, Observations sur le sentiment du beau et du sublime, in Œuvres philosophiques, op. cit., Vol. I, p.505. Kant, Physische Geographie, Op. cit., p.316.
32. Kant et l’Afrique : deux rendez-vous manqués ? Une approche psychologique développementale Kant and Africa: Two missed encounters? A Psychological Developmental Approach Lukas K. SOSOE*1 Université du Luxembourg.
33. يُنظر أيضًا الشّواهد التَّالية: “يمكن القول إن العرق الأسود هو النقيض التام للهنود الأمريكيين؛ إنهم في غاية التأثر والانفعال، وحيويون جدًّا، وثرثارون، وكسالى. يمكن تعليمهم، ولكن فقط بوصفهم عبيدًا. مما يعني أنهم يسمحون لأنفسهم بالتدريب، ويخافون الضرب، ويفعلون أشياء كثيرة من منطلق الشعور بالشرف”. Kant Physische Geographie, AA, Vol. IX, deuxième partie, p.316. “الإنسانيّة في أعظم كمالها موجودة في العرق الأبيض. يتمتع العرق الأصفر الهندي بالفعل بموهبة أقل قليلًا، والسُّود أقل بكثير. ويجد جزء من شعوب هنود أمريكا أنفسهم في أدنى مستوياتهم”. و”السُّود متعجرفون جدًّا، ولكن على الطريقة الزِّنجيّة، وثرثارون جدًّا لدرجة أنه يجب تفريقهم بالعصي”. Kant, Œuvres philosophiques, Op. cit., Vol. I, p.505-506.
34. علي أسعد وطفة، التَّربية الأخلاقيّة في الفَلسفة الكانطيّة، مرجع سابق ص422. تعد هذه المقاربة مقاربة تحليلية شاملة، مع ملاحظات نقديّة أساسيّة، وذلك مُقارنة بِمختلف الدّراسات العربيَّة الّتي اهتمت بالتربيّة عند كانط، ويمكن القول: على الرّغم مِن اِصطلاح الباحث على مقاربته بالسوسيولوجيا، إلا أنه مِن جهة يُشير إلى التفكيك والتحليل، ولا وجود للمعطى الاجتماعي، فالنظام التّربويّ الألمانيّ، أو المجتمع العربيّ، أو المَنظومة التّربويّة لا تحضر في هذه الدّراسة الّتي يَغلب عليها الجانب النّظريّ.
35. كانط، ما التوجه في التفكير؟ في إيمانويل كانط، ثلاثة نصوص، ترجمة محمود بن جماعة ص114.
36. ترجم نص إيمانويل كانط: إجابة عن سؤال ما التنوير؟ من قبل: (1). مُصطفى فهمي، ما التَّنوير؟ في صفحات خالدة من الأدب الألمانيّ، دار صادر، 1970. (2). يوسف الصّديق بعنوان: ما هو عصر التنوير؟ في مجلة: الكرمل، مجلة فصلية ثقافية، تصدر عن مؤسسة الكرمل الثقافية، رام الله، فلسطين، العدد 12، 1984. (3). عبد الغفار مكاوي بعنوان: الإجابة على سؤال ما التَّنوير؟ في كتاب: زكي نجيب محمود، فيلسوفًا وأديبًا ومُعلمًا، كتاب تذكاري، جامعة الكويت، 1987. (4)- عُثمان أمين، ما “التنوير”؟ (1784)، في رواد المثالية في الفلسفة الغربية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة- مصر، 1989، ص227-225. ملاحظة: [لقد اكتفى المترجم بترجمة الفقرات الخمس الأولى من النص، وهو ما يعني أنَّها ترجمة ناقصة، الترجمة عن الفرنسية والإنجليزية]. (5)- حسين حرب، جواب عن السّؤال ما هي الأنوار؟ في مجلة الفكر العربيّ، 1987. (6)- إسماعيل المصدق بعنوان: إجابة عن السؤال: ما التنوير، في مجلة: فكر نقد، عدد 4، سنة 1997. (7)- مصطفى لعريسة بعنوان: ما التنوير؟ في مجلة: مُقدّمات، المَجلة المَغاربيّة للكتاب، المغرب، عدد 31، 2004. (8)- مُحمّد الهلاليّ، بعنوان: ما الأنوار، في الأزمنة الحديثة، مجلة فلسفية فصلية تُعنى بشؤون الفكر والثَّقافة، عدد 1 أبريل 2008. (9)- فتحي انقزو، جواب عن سؤال ما هو التنوير؟ (1784)، في مقالات في التَّاريخ والسّياسة، ترجمة المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السَّياسات، الظعاين، قطر، 2022، ص128-121. (10)- شربل داغر، كانط- فوكو، ما هي الأنوار؟ دار الأنوار للطباعة والنَّشر، 1999. وكذلك: ما هي الأنوار؟ لميشيل فوكو، في جريدة الحياة اللّندنيّة، 3 أيار- مايو، 1993. (11)- محمود بن جماعة، ثلاثة نصوص، تأمّلات في التَّربية، وما هي الأنوار؟ ما التّوجه في التَّفكير؟ دار مُحمّد علي للنشر، تونس، 2005. (12)- جوزيف معلوف، في التّربية، وإجابة عن سؤال: ما التّنوير؟ دار الرّافدين، العراق، 2022. وترجم أيضًا نصّ ميشيل فوكو: 1- حميد طاس بعنوان: ما هي الأنوار؟ في مجلة: فكر ونقد، مجلة ثقافية شهرية، المغرب، العدد5، 1997. 2- رشيد بوطيب بعنوان: ما الأنوار؟ في مجلة: البحرين الثقافية، وزارة الثقافة البحرينية، مملكة البحرين، العدد37، 2003. 3- مصطفى لعريصة بعنوان: بين كانط وبودلير: الحداثة كموقف، في مجلة: مقدمات، المجلة المغاربية للكتاب، المغرب، عدد31، 2004. (4)- الزواوي بغورة، التنوير والثورة، في ميشيل فوكو، ما التنوير؟ دار آفاق للنشر، ط2، 2016، ص103-74. (5)- أحمد الطريبق، ما هي الأنوار؟ قراءة ميشيل فوكو لمقال كانط حول الأنوار، في: الحوار المتمدن، رقم 4275، 2015. (6)- كريم الجاف، ما التنوير؟ في مجلة الفلسفة، 2019، صفحة 264-249. وكذلك: التنوير، الثورة والحداثة، منشورات دار شهريار، 2020. (7)- زهير الخالديّ، ما هي الأنوار؟ الحوار المتمدن، العدد 6696، 2020.
37. علي أسعد وطفة، التربية الأخلاقيّة في الفلسفة الكانطيّة، مرجع سابق ص12.
38. نقلًا عن زكريا إبراهيم، كانت أو الفلسفة النقدية، مكتبة مصر، ص11. وكذلك، زكي نجيب محمود، قصّة الفلسفة الحديثة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة – مصر، 1936، ص249.
39. زكريا إبراهيم، كانت أو الفلسفة النقدية، مكتبة مصر، ص11.
40. زكريا إبراهيم، كانت أو الفلسفة النقدية، مكتبة مصر، ص12.
41. زكريا إبراهيم، كانت أو الفلسفة النقدية، مكتبة مصر، ص13.
42. زكريا إبراهيم، كانت أو الفلسفة النقدية، مكتبة مصر، ص8. يشير زكريا إلى كتاب علم التربية ولا يحيل إليه. (ص263).
43. محاولة عثمان أمين بسيطة، مختصرة، لا ترقى لمحاولة زكريا إبراهيم التحليلية والنقدية، وعبد الرحمن بدوي في سلسلته عن كانط، يعد المترجم الشارح، فقرة مترجمة مع الشرح. وتتكون من: إمانويل كنت، 1977، الأخلاق عند كنت، 1979، فلسفة القانون والسياسة، 1979، فلسفة الدين والتربية، 1980.
44. علي أسعد وطفة، التّربية الأخلاقيّة في الفلسفة الكانطيّة، مرجع سابق ص454.
45. المرجع السابق، الصفحة نفسها.
46. المرجع السابق ص458.
47. محمد عبد الله دراز، دستور الأخلاق في القرآن، دار الدعوة، القاهرة- مصر، 1996، ص8.
د. الزواويّ بغورة
مفكر وكاتب جزائري، أستاذ الفلسفة المعاصرة، ورئيس قسم الفلسفة في جامعة الكويت. له العديد من المؤلفات والأبحاث في مجال الفلسفة الاجتماعية والسياسية، عالجت أبحاثه قضايا الهوية، والحداثة، واللُغة والمنهج، والسُّلطة والحرية. وترجم من الإنجليزية والفرنسية أكثر من عشرة كتب، معظمها في مجال الدراسات الفلسفية البنيوية، ولا سيما أعمال ميشيل فوكو.