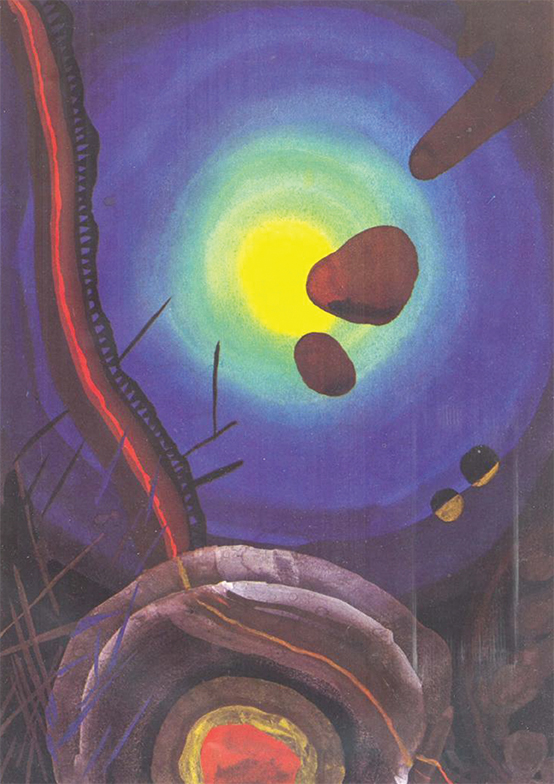اسمحوا لي أن أبدأ باقتباس من عمل يتمنّى أغلبنا لو أنّ كانط لم يؤلّفه قطّ، بل لم يؤلّفه بالفعل: تستند الأنثروبولوجيا على ما خطّه طلابه أثناء المحاضرات. غير أنّ بين سطور الملاحظات المحرجة، بل المثيرة للاشمئزاز، نجد أحيانًا جواهر مخبّأة، كالواردة أدناه:
تحميل المقال
“إنّها عادة غريبة موجودة في قدرتنا على الانتباه، وهي أنّنا نركّز بكلّ دقّة وتأنّ على العيب لدى الآخرين: ونفعل ذلك من دون قصد، كالتركيز على الزرّ المفقود في معطف الشخص الآخر، أو على الفجوة بين أسنانه، أو على عيب مُكتسب فِي النُّطقِّ، الأمر الّذي لا يسبّب بالتالي شعور الضيق والتبرّم لدى الآخرين، بل يحطّ من قدر أنفسنا في الوقت نفسه”.
لقد أعجبتني، بشكلٍ خاصّ، الملاحظة المتعلّقة بالحطّ من قدر أنفسنا عندما نُركّز على العيوب. كتب غوته أنّ قراءة أعمال كانط– على الأقلّ للبعض منّا– لا تشبه عمليّة الدخول إلى غرفة مضاءة جيّدًا. فبعض ملاحظاته الجانبيّة، وخاصّة المتعلّقة بعيوب البشر، تُلقي بالضوء على سمات بسيطة، غير أنّها عميقة، وغالبًا لا نتمكّن من ملاحظتها؛ حتّى فرويد لم يقدّم لنا أمرًا أفضل من ذلك. إنّ التركيز حصرًا على عيوب امرئٍ ما يحطّ من قدرنا؛ لقد لمست شعورًا طفيفًا بالقبح بعد أن أمضيت ساعة أحلّل فيها عيوب زميل لي. بالطبع هناك زملاء يستحقّ سلوكهم التطرّق إليه بالانتقاد، وهناك طرائق ممجوجة لفعل ذلك، وأخرى محترمة وربّما بنّاءة. غير أنّه دائمًا ما يعتريني الشعور بالراحة تجاه نفسي، وأغادر وأعود إلى المنزل أكثر سعادة، عندما أقضي ساعةً في الحديث عن زملاءَ أكنّ لهم المحبّة والاحترام.
لقد كانت ملاحظة كانط حول التركيز على العيوب تتوافق مع الكمّ الكبير للكتابات حول عنصريّة كانط المزعومة ونزعته الاستعماريّة التي بدأت منذ حوالي ثلاثين عامًا، وأَضحت اليوم من أبرز المواضيع الساخنة في الدراسات والأبحاث حول كانط، سواء أكان ذلك بين المتخصّصين أو بين عامّة الناس. وليس اهتمامنا الزائد بالعنصريّة والاستعمار فقط هو ما جعلهما محطّ النقاش حول كانط؛ فأنا أعتقد أنّه من الجيد أن نكون أكثر وعيًا بتاريخ الاستعمار وبالتأثير المنهجي للعنصريّة. غير أنّ هناك أمرًا ما يقف وراء التركيز المستمرّ على سؤال: “إلى أيّ مدى كان كانط عُنصريًّا؟”. هناك شيء في هذه النقطة أشبه بسلوك الضباع الكاسرة، وبالاستمتاع المخزي من خلال اجترار الأخطاء في عمل كانط. ومع ذلك سيظلّ هذا التركيز قائمًا إلى أن نتعامل مع هذه المسألة بشكل أكثر منهجيّة. لذا فإن ما سأقدّمه هنا هو لمحة عن القضايا الفلسفيّة، لا النَّصيّة، التي نحتاج إلى التأمّل فيها إن كان لدينا رغبة في نقل كانط إلى القرن الحادي والعشرين.
ثمّة ثلاثة احتمالات أساسيّة للتعامل مع الكمّ الكبير من الملاحظات العنصريّة الواضحة للعيان بكثرة في أعمال كانط:
الاحتمال الأوّل: يمكننا تجاهل تلك الفقرات كتجاهلنا لفجوة بين أسنان شخص ما، أو زرّ مفقود من معطفه، وذلك من باب التأدّب، والرغبة في عدم الحطّ من قدر أنفسنا بالتركيز على العيوب الصغيرة. لقد أعلى كواين من شأن هذا الموقف، ووضعه موضع ما يسمى بـ “مبدأ الإحسان” أو العمل الخيريّ، الذي لم يكن دومًا في موقع مُنصف لمتلقّيه، شأن كثيرٍ من الأعمال الخيريّة. أمّا تجاهل هذه الفقرات باعتبارها أمرًا تافهًا لا قيمة له، فكان بالتأكيد النهج المتّبع حتّى نهاية القرن العشرين، عندما دفع تشارلز ميلز، بشكل خاصّ، بمسائل العنصريّة إلى واجهة المناقشات الفلسفيّة حول اللَّيبراليّة ونظرية العقد الاجتماعيّ. وفي اعتقادي، فإنّ ميلز كان مُخطئًا– كما سأتطرّق إلى ذلك لاحقًا- ولكنّني أعتقد أيضًا أنّ مبدأ الإحسان يُخلّف وراءه ثغرات. لذا فمن الأفضل، وبالتأكيد لا مفرّ، من عدم التَّعامي وإخفاء مسألة عُنصريّة كانط.
الاحتمال الثَّاني: وهو الخيار السائد، لعلّه كونه السبيل الأسهل، صاحب مبدأ رقّاص الساعة المتأرجح. وينصّ هذا الاحتمال على مقولة أنّ عنصريّة كانط ليست عرضيّة أو طارئة، بل منهجيّة وتتخلّل أعماله جميعها. يشارك هذا الرأي أيضًا ميلز وبيرناسكوني ولو-أدلر وآخرون، ممّن حاولوا إظهار مدى تجذّر العنصريّة في الفلسفة النَّقديّة. ويا للأسف فإنّ هذا الرأي الآخذ في أن يصبح باطِّراد الرأيَ السائدَ، ليس بين المتخصّصين في كانط، ولكن في مقالات كمقالة ويكيبيديا الإنجليزية حول كانط، على سبيل المثال. فالمقالة تشير ببساطة وبصراحة إلى أنّه كان عُنصريًّا، سواء في المقدّمة التمهيدية، أو في قسم منفصل مخصص للعنصريّة، يشكّك فيه محرّرو مقال ويكيبيديا في كوسموبوليتيّة كانط. لقد حاولت الباحثة المتخصّصة بكانط، شيريس فون كزيلاندر، مرارًا وتكرارًا إقناع ويكيبيديا على الأقلّ بإشكاليّة هذا الادّعاء، لتجد أنّه، في كلّ مرّة، تُعاد الادّعاءات على نحو غامض، وتُحذف تعليقاتها.
الاحتمال الثَّالث: وهو الذي عرضه في المقام الأوّل باولين كلاينغيلد، ويُتيح لنا مخرجًا من هذه الخيارات الثنائيّة، وأنا مدينة لها بالشكر على عملها. لقد قامت كلاينغيلد بتعقّب مسارٍ حاسمٍ في تطوّر كانط، إذ انتقل من تكرار الأحكام العُنصريّة المُسبقة التي تتناقض على نحو شديد مع فلسفته المنهجيّة، إلى الكوزموبوليتانيّة الحاسمة ورفض الاستعمار. وهذا الأمر الأخير نجده في العقد الأخير من حياته. ترفض باولين، أو بالأحرى تتجنّب، التكهّن بحالات كانط الداخليّة أو الأفكار التي ربما دفعته إلى التوفيق بين تعليقاته وآرائه المنهجيّة. وبالطبع هي مُحقّة في موقفها هذا، نظرًا إلى النقص في الأدلّة. أودّ فقط أن أضيف أنّه مهما كانت العمليّات الذاتية التي صاحبت تطوّر كانط، فإنّ هذا التطوّر كان موضوعيًّا، سواء في العقل النَّظريّ أو العمليّ، وهو أمر يجب أن يرحب به ويهلّل له حقًّا الكانطيون بيننا.
لمَ لا نفترض أنّه توصّل إلى إدراك بأنّ تعليقاته بخصوص الشُّعوب غير الأوروبيّة كانت متناقضة تمامًا مع آرائه الأخلاقيّة والميتافيزيقيّة؟ يمكننا عندها أن نشيد بهذه الحقيقة باعتبارها دليلًا على تطوّر أخلاقيّ أكثر إقناعًا ممّا قدمه كانط في كتابه “صراع الكليّات”، وهو الأمل الذي يشعر به المراقبون المحايدون عندما يتأمّلون في الثَّورة الفرنسيّة.
وحقيقة أنّ أعظم المفكّرين احتاجوا إلى الوقت من أجل صقل وجهات نظرهم وتطويرها وجعلها أقرب إلى التماسك، هو أمر يجب أن يمنحنا الأمل في أن البقيّة منّا يمكنها تحقيق الشيء نفسه بدلًا من التمرّغ والغرق في مستنقع خيبة الأمل لأنّه لم يتّجه فورًا ومباشرة إلى الصَّواب.
إنّ إيمان كانط بقوّة العقل كان دومًا مرتبطًا بالوعي بحدوده. من يعلم؟ ربما لو مُنح عقدًا أو عقدين إضافيّين من الزمن، لكان قد تراجع ربّما حتّى عن تعليقاته المشينة المتعلّقة باليهود والنساء. وكوني يهوديّة ينبغي عليّ القول إنّني لم أعتقد قطّ أنّ تعليقاته عن “قبيلتي” أو “قبائلي” كانت تستحقّ اهتمامًا أكبر من الاهتمام بزرٍّ مفقودٍ في معطف. فالعيوب تتضاءل أمام عظمة نظريّته النقديّة.
أنّ الفكرة القائلة بأنّ جميع الناس، بغضّ النظر عن اختلافاتهم، لهم الحقّ في التمتّع بالكرامة فقط لكونهم بشرًا… هي إنجاز ححيث
إذًا فقد قدّم لنا عددٌ من الباحثين المتخصّصين في فلسفة كانط ما يكفي من الأدلّة، لو أردنا أن نرفض الاتجاه السَّائد حاليًّا فيما يتعلّق باستخدام تصريحات كانط العنصريّة من أجل هدم المنظومة بأكملها وتفكيكها. وأنا أعتقد أنّ التفاصيل من الأهميّة بمكان، كحقيقة أنّ كانط لم يُضمّن المناقشة الشهيرة الفاضحة حول التسلسل الهرميّ العرقيّ في النسخة النهائيّة المنشورة لكتابه “الأنثروبولوجيا من وجهة نظر براغماتيّة”. غير أنّني أودّ أن أنأى عن تلك الأسئلة لأنّني أقلّ اهتمامًا بالفلاسفة، وبالتأكيد ليس تجاه الباحثين المتخصّصين بكانط، بل إنّ اهتمامي ينصبّ على ممارسة ثقافيّة منتشرة في معظم أنحاء العالم، إن لم تكن في جميع أنحائه. وبكلّ بساطة واختصار، إنّها معركة بين التنوير وما بعد الاستعماريّة، ويبدو أنّ التنوير في موقع الخاسر. أعلم أنّ هذا المؤتمر هو عن كانط، ومن المفترض ألا نتناول الأمور بطريقة فجّة، غير أنّ النُّسخ البسيطة الفجّة هي ما يبقى في الثقافة، ولا أتحدث هنا عن ويكيبيديا. إنّ تجربتي بوصفي فيلسوفة عاملة خارج أقسام الفلسفة على مدى ربع قرن جعلتني أنتبه إلى الطريقة التي يتعامل بها الزملاء في الأقسام الأخرى مع الأسئلة الفلسفية التي تُطرح عليهم. أتذكّر محاضرة لعالم اجتماع ألمانيّ مرموق أشار فيها إلى “جدليّة التنوير”. وأنتم تعرفون ما قاله أدورنو وهوركهايمر عندما رأيا الجانبَ المظلم والاستعمار وما إلى ذلك. وعندما وُجّه إليه السؤال بالإشارة إلى فقرة في “جدليّة التنوير” تذكر الاستعمار، لم يستطع طبعًا أن يذكر واحدة. لكن في يومنا هذا لا يوجد هدف أسهل من التنوير، حتّى لو تضمّنت الانتقادات الكثيرة له كلّ أنواع اللوم والاتّهام الممزوج في خليط طينيّ أملًا في أن يلتصق به شيء منه.
قبل قرن من الزمن كانت الحداثة هي مصدر كلّ مشاكلنا؛ أمّا اليوم فإنّ إلقاء اللوم على التنوير يبدو أكثر دقّة، ولكنّ الأمر ليس كذلك. أتذكّر رسالة إلكترونيّة تلقّيتها هذا الأسبوع من مؤرخّة أمريكيّة مرموقة جدًّا، تشكرني فيها على مقال كتبته لصحيفة “نيويورك تايمز” وقد غيّر رأيها “تقريبًا” حول كانط الذي كانت قد رفضته بسبب تصريحاته حول غير الأوروبيّين.
إنّ الأمر الأغرب في رفض التنوير باعتباره مركزيّة أوروبيّة هو أنّ التّنوير نفسه كان مَن ابتكر تهمة المركزيّة الأوروبيّة، وعندما يُصرّ منظّرو ما بعد الاستعماريّة المعاصرون بحقّ على ضرورة رؤية العالم من منظور غير الأوروبيّين، فإنّهم يتّكئون على صدى تقليد يعود إلى مونتسكيو الذي استخدم شخصيّات فارسية خياليّة لانتقاد الأعراف الأوروبيّة بطريقة لم يكن في وسعه القيام بها لو كتبها بوصفه فرنسيًّا بصوته الشخصيّ وبطريقة مباشرة.
لقد أعقبت “الرسائل الفارسيّة” لمونتسكيو عشرات الكتابات الأخرى التي استخدمت الأسلوب نفسه. مثال على ذلك: حوار لاهونتان مع أحد الهورون، وتتمّة رحلة بوغنفيل لديدرو التي ينتقدان فيها القوانين الأبويّة في أوروبا المتعلّقة بالجنس، التي عاقبت النساء اللواتي أنجبن أطفالًا خارج إطار الزواج، وذلك كلّه من منظور الهورون والتاهيتيّين الذين كانوا أكثر عدالة ومساواة في هذا الجانب. كذلك الأمر فيما يتعلّق بأقسى وأجرأ انتقادات فولتير للمسيحيّة، فقد جاءت على لسان إمبراطور صينيّ وكاهن من السكّان الأصليّين في أمريكا الجنوبيّة.
في كتابهما الأكثر مبيعًا “فجر كلّ شيء” يُقدّم عالمُ الأنثروبولوجيا ديفيد غريبر وعالم الآثار ديفيد وينغرو حُجّة مثيرة للاهتمام، مفادها أنّ انتقاد عصر التنوير لأوروبا من منظور وجهات نظر غير أوروبيّة غالبًا ما تُقرأ على أنّها مجرّد إستراتيجيّات أدبيّة؛ إذ إنّ هؤلاء الكتّاب وضعوا أفكارهم الخاصّة على ألسنة شخصيّات غير أوروبيّة مُتخيَّلة، وذلك تجنّبًا للاضطهاد والملاحقة اللذين كانوا سيواجهونهما لو عبّروا عنها بأنفسهم مباشرة. غير أنّ المؤلّفَين يصرّان على أنّ الشخصيّات غير الأوروبيّة كانت حقيقيّة. وتعتمد حجتهما، إلى حدّ كبير، على دراسة حوار لاهونتان مع أحد الهورون، الصادر عام 1703، أي: في مطلع عصر التنوير، وهو كتاب حقّق نجاحًا هائلًا، وألهم العديد من الأعمال المماثلة التي قلَّدته. يعرض المؤلّف الفرنسيّ في هذا الكتاب سلسلة من الحوارات مع مُفكّر ورجل دولة من شعب الوايندوت يدعى كانديارونك، وقد أجراها معه خلال السَّنوات التي قضاها لاهونتان في كندا وأجاد هناك لغتي الألغونكوين والوايندوت. فبدلًا من الافتراض السَّائد بأنّ السُّكان الأصليّين لم يكونوا قادرين على تقديم الحُجج السّياسيّة البارعة المَنسوبة إلى كانديارونك، يُقدِّم غريبر ووينغرو بعض الأدلّة على أن كانديارونك التَّاريخيّ كان معروفًا بذكائه وفصاحته، وأنه شارك بالفعل في نقاشات مماثلة مع الأوروبيّين، قام لاهونتان بتدوينها.
إنّ أدلّتهما غير قاطعة، وبعض مزاعمهما حول عصر التنَّوير خاطئة. لقد كان كانديارونك التَّاريخيّ مُجرّد مثال واحد من بين العديد من الأصوات التي وصلت إلى مسامع مفكّري التنوير. لقد لاقت الانتقادات التي وجّهها السُّكّان الأصليّون للمال، وحقوق المُلكيّة، والتسلسل الهرميّ الاجتماعيّ، اهتمامًا كبيرًا من الأوروبيّين منذ القرن السَّادس عشر. وكان لها دور في التأثير على نقد التنوير، كما أقر به مفكرون من داخل التيار التنويري نفسه. وربّما لن نتمكّن أبدًا من معرفة إلى أيّ حدّ كانت تلك الانتقادات مختلقة، وكم منها كان أصيلًا. وكما هو الحال مع معظم الجهود الأدبيّة، من المرجّح أنّها كانت مزيجًا من الاثنين معًا. وأثناء قيام غريبر ووينغرو بتبيان القواسم المشتركة بين المدافعين الأوروبيّين عن عصر التنوير وغير الأوروبيّين، فإنّهما ألمحا إلى أنّه من الواجب “إنقاذ” التنوير، وذلك من خلال منحه أصولًا غير أوروبيّة، وأشارا إلى أنّ الأوروبيّين قد سرقوا أفكارًا تعود إلى السكّان المحليّين، إضافة إلى سرقة أراضيهم. بل إنّهما يتحدثان صراحةً عن “إنهاء وإزالة الاستعمار” عن التنوير. إذًا فما تؤكّده المناقشات والمناظرات حول كتاب “فجر كلّ شيء” بلا أدنى شكّ، هو أنّ التنوير كان رائدًا في تعبيد طريق رفض المركزيّة الأوروبيّة، وفي حثّ الأوروبيّين على النظر إلى أنفسهم من منظور بقيّة العالم.
نادرًا ما كانت سجالات التنوير حول العالم غير الأوروبيّ مُتجرّدة من الأغراض الشخصيّة. فلقد قام مفكّروه بدراسة الإسلام بهدف إيجاد دين عالميّ يمكنه تسليط الضوء على عيوب المسيحيّة. وتحاجج كلّ من بايل وفولتير بأنّ الإسلام أقلّ قسوة ودمويّة من المسيحيّة، لأنّه أكثر تسامحًا وعقلانيّة. لم يكن الولع بالصين الذي اكتسح بدايات عصر التنوير، مسألة تتعلّق بالخزف أو فضول بسيط للاطّلاع على ثقافة قديمة بعيدة؛ بل إنّ دراسة الثقافة الصينيّة كان لها أهداف واضحة. الفرنسيّون البرجوازيّون المستاؤون من القيود الإقطاعيّة التي منحت العقود الحكوميّة للأرستقراطيين، أشادوا بالنظام الكونفوشيّ الذي يعتمد التقدّم والصعود فيه على الجدارة التي يمكن قياسها بالامتحانات الوطنيّة. لقد كان استخدام المعارف الأنثروبولوجيّة الثقافية لتعزيز الحجج الخاصّة أمرًا شائعًا، لدرجة أنّ الماركيز دو ساد استخدمه، أو حتّى سخر منه. لقد أضاف دو ساد لمسة جديدة على النمط الشائع: ففي العادة، كانت الغاية من دراسة الثقافات غير الأوروبيّة إبراز عيوب الثقافات الأوروبيّة؛ أما في أعمال ساد، فإنّ القوائم التي تتضمّن جرائم غير الأوروبيّين، وغالبًا ما تكون مَصحوبة بحواشٍ مزيّفة، فإنّها تهدف إلى إثبات العكس: يمكنك أن تجد قسوة لا نهائيّة حيثما ولّيت وجهك.
إنّ صدى صور عصر التنوير للشُّعوب غير الأوروبيّة سيبقى يُدوّي في آذاننا. وبالنظر إلى قلّة فُرص السَّفر ومحدوديّتها، كان على مفكّري القرن الثامن عشر الاعتماد على عدد محدود من التقارير التي غالبًا ما كرّرت الرسوم الكاريكاتوريّة التي قامت لاحقًا بخدمة المصالح الاستعماريّة. ولكن يتعيّن علينا إدراك إلى أيّ مدى وصل إليه هؤلاء المفكّرون بفضل قوّة الفكر وحدها، دون أن تتاح لهم فرصة لدمج تجارب غير الأوروبيّين في وجهات نظرهم. فحتّى غوته، في أسفاره، لم يصل في النهاية إلا إلى صقليّة. وخلافًا لنقّاد اليوم، لقد كان مفكّرو التنوير مدركين تمامًا للثغرات في معارفهم. وها هو جان جاك روسو يكتب في عام 1754:
“على الرغم من أنّ سُكّان أوروبا قد قاموا، إبّان الثلاثمائة أو الأربعمائة سنة الماضية، باجتياح أجزاء أخرى من العالم، وهم ينشرون باستمرار مجموعة إصدارات جديدة تتعلّق برحلاتهم وتقاريرهم، إلا أنّني على قناعة بأنّ الأشخاص الوحيدين الذين نعرفهم حقًا هم الأوروبيّون… فنحن لا نعرف شُعوب جزر الهند الشرقيّة التي يزورها حصرًا الأوروبيّون المهتمون بملء جيوبهم أكثر من أدمغتهم. وما زال يتعيّن دراسة إفريقيا واستكشافها بأكملها، بسكّانها العديدين المتميّزين بطبائع شخصيّة كما بلون بشرتهم؛ فالأرض جميعها مليئة بأمم لا نعرف عنها سوى أسمائها، ومع ذلك ندّعي بأنّنا قادرون على الحكم على الناس والبشريّة!”.
ولم يكن روسو استثناءً في حكمه، فقد حذّر ديدرو بدوره من إصدار الأحكام حول الصين من دون دراية شاملة ومعمّقة بلغتها وآدابها، ومن دون توفّر الفرصة “للتجوّل في جميع المقاطعات، وللتحدّث بحرّية مع الصينيّين من مختلف الطبقات”. وأشار كانط إلى صعوبة استخلاص استنتاجات من الروايات الاثنوغرافيّة (وصف الأعراق البشريّة) المتضاربة التي يدّعي بعضها التفوّق الفكريّ للأوروبيّين، في حين أنّ بعضها الآخر يقدّم بالقدر نفسه، أدلّة معقولة على القدرات الطبيعيّة المتساوية للأفارقة والأمريكيّين الأصليّين. لقد كان مفكّرو عصر التنوير مدركين لمحدوديّة معرفتهم، وحثّوا على الحذر والتشكيك عند قراءة التوصيفات التجريبيّة للشعوب غير الأوروبيّة، غير أنّهم انتقدوا بشدّة التحيّزات الأنانيّة التي غذّت الروايات السياسيّة المغرضة.
إليكم ديدرو وهو يتحدّث عن الغزو الإسبانيّ للمكسيك:
“لقد توهّموا أنّ هؤلاء الناس لا يملكون شكلًا من أشكال الحكم، لكونه لم يكن محصورًا في يد شخص واحد. كما توهّموا أنّهم لا يملكون حضارة، لأنّها كانت مختلفة عن حضارة مدريد؛ ولا فضائل، لأنّهم لم يكونوا يعتنقون المعتقد الدينيّ نفسه؛ ولا إدراك، لأنه لم يكن لديهم وجهات النظر نفسها”.
لقد نُشرت هذه الكلمات كالكثير غيرها دون ذكر اسم صاحبها، وذلك كإجراء احترازيّ متّزن؛ لتجنّب عودة ديدرو إلى السجن الذي تعرّض له سابقًا بسبب كتاباته. لم يكن جميع كُتَّاب عصر التنوير مَحظوظين مثله، إذ إنّ الأخطار التي واجهوها تتعدّى مجرّد الانتقادات اللاذعة وعاصفة الثوران على موقع تويتر. ففي عام 1723 مُنح الفيلسوف كريستيان وولف مهلة ثمانٍ وأربعين ساعة لترك منصبه في الأستاذيّة في جامعة هاله في بروسيا، وإلا سيواجه حكم الإعدام، والسبب في المقام الأوّل ينحصر في كونه حاججَ علنًا بأنّ الصينيّين يتمتّعون بأخلاق رفيعة، حتّى دون اعتناق المسيحيّة. ولم تكن تجربته استثناءً، فقد حُظرت أو أُحرقت جميع النصوص الأساسيّة لعصر التنوير تقريبًا، أو نُشرت دون ذكر أسماء مؤلّفيها. وعلى الرغم من اختلافاتها فقد كان يُنظر إليها جميعًا على أنها تهديد للسلطات القائمة، باسم المبادئ العالميّة الشاملة التي تنطبق على الجميع في أيّة ثقافة كانت.
إنّني أفترض أنّ هذه الأمثلة وغيرها معروفة لدى العديد مِن الحاضرين في هذا المؤتمر، ولكنّنا بحاجة إلى التّطرّق إليها بشكل أقوى. أعتقد أنّ الكثير مِنَّا يشعر بالوجل مِن مُنظّري ما بعد الاستعماريّة، خشية اِتّهامهم بالإمبرياليّة من قبل هؤلاء الأخيرين إنْ هو اختلفَ مَعهم في الرأي. وهناك ممثّلون هزليّون سيّئون يمتلؤون غِبطة بإطلاق هذه الاتّهامات. إضافة إلى ذلك فإنَّ النَّثر في هذا المجال غالبًا ما يتعذّر فهمه، ونحن لم نقم بجهد كافٍ لفهمه. ألسنا نُفضّل أن نقضي أوقاتنا في غُرف الفلسفة التَّنويريّة المضيئة؟ هذا ما اعتقدته، لفترة على الأقلّ، إلى أن أدركت كم هو وقع تأثير نظريّة ما بعد الاستعماريّة اليوم، مُقارنة بفكر التَّنوير، وقررت أنّه مِن المُهمّ التَّعامل مع النَّظريّة الأولى الآنفة الذكر. لا أدّعي أنني متمرّسة بها تمامًا، إلا أنّني تعلّمت أشياء عنها في السَّنتين المُنصرمتين. أهمّ ما تعلّمته هو أنّ الخلط بين مُناهضة الاستعمار ونظريّة ما بعد الاستعماريّة هو أمر خطير، عَلى الرَّغم مِن أنّ هذا الخلط يُمارَس ببراعة من قبل العديد مِن مُنظّريّ ما بعد الاستعماريّة. فالدّراسات الاستعماريّة المبكّرة الّتي بدأت في عام 1951 بحسب المؤرّخ الاستعماريّ فريدريك كوبر كان محور تركيزها مختلفًا تمامًا عن محور تركيز نظريّة ما بعد الاستعماريّة اليوم. فتركيزها لم يكن مُنصبًّا على الفترة الاستعماريّة وأهوالها، بل على تاريخ إفريقيا والهند قبل الاستعمار، وذلك في محاولة لدحض آراء هيجل وغيره، الذين زعموا أنّ إفريقيا، على وجه الخصوص، لم تكن تمتلك تاريخًا قبل وصول الأوروبيّين. (في كتابه المميّز “ضدّ إنهاء الاستعمار” يشير الفيلسوف النيجيريّ أولوفيمي تايو إلى أنّ شمال إفريقيا استعمر إسبانيا لمدّة 700 عام، وهي حقبة تزيد بمئة عام تقريبًا عن المدّة التي استعمر فيها الأوروبيّون إفريقيا. ومع ذلك فإنّ الإسبان يتعاملون مع تلك الفترة باعتبارها جزءًا من تاريخهم، وليس الحدث الحاسم فيه. ويدعو تايو الأفارقة إلى اتّباع النهج نفسه). ثانيًا ركّز العلماء الأوائل في دراسات الاستعمار على دراسة المقاومة ضدّ الاستعمار، وليس على المعاناة تحت نيره.
ليس بالضرورة أن تسير العنصريّة والاستعمار جنبًا إلى جنب، ولكنّه من الأسهل للاستعمار أن يفعل ذلك، لأنّ العنصريّة تبدو نوعًا من التبرير للاستعمار. سأتطرّق إلى هذين الموضوعين معًا. ولكن من الممكن أن تكون استعماريًّا، وحتى استعماريًّا مرتكبًا للإبادة الجماعيّة، دون أن تكون عُنصريًّا على الإطلاق، كما وجب علينا أن نتعلّم على الأقلّ من ثوقيديديس: فالأثينيّون لم يعتبروا الماليانيّين أقلّ شأنًا منهم من الناحية العرقيّة، بل فقط أصغر وأضعف حجمًا. وكان ذلك كافيًا: إنّ الدُّول الكبيرة تبتلع الصَّغيرة كما يبتلعُ اللّيل النّهار؛ هذا هو القانون الطّبيعيّ الذي ليس للعقل اعتراض عليه. عندما كتب فرانز فانون عام 1961 أنّ فصلًا جديدًا في التاريخ يبدأ بإنهاء الاستعمار لم يكن يبالغ. لقد تغلّبت الأمم الأقوى على الأضعف منذ بداية التَّاريخ المدوّن؛ بل حتّى قبل نشوء الأمم بمعناها الحالي. وحتّى القرن الماضي كانت الإمبرياليّة مُمارسة سياسيّة عالميّة، شأنها كشأن أيّة ممارسة أخرى، فقد أنشأ الرُّومان والصينيّون إمبراطوريّات، وكذلك فعل الآشوريون والأزتيك والماليانيّون والخمير والمغول والعثمانيّون على سبيل المثال لا الحصر. لقد تعاملت تلك الإمبراطوريّات بدرجات متفاوتة من الوحشيّة والقمع، غير أنّها جميعًا كانت مبنية على معادلة القوة والحقّ التي لا ترقى إلى مفهوم القانون تمامًا. كلّ هذه الإمبراطوريّات سخّرت قوّتها لإجبار المجموعات الأضعف على التنازل عن الموارد، و دفع الجزية، وتجنيد الجنود في مزيد من حروب جديدة للإمبراطوريّة، وقبول أوامر تتجاوز الأعراف والقوانين المحليّة. وعلى حدّ علمنا كانت جميعها تفتقر إلى أمر واحد، ألا وهو: تأنيب الضمير.
إنّ عمليّة الارتقاء”بالإنسانيّة” إلى مستوى التجريد أمر متقلقل محفوف بالأخطار
الحدث الجديد في القرن الثامن عشر لم يكن الاستعمار، بل مناهضته ومعارضته. في القرن السادس عشر احتجّ بارتولومي دي لاس كاساس على القسوة التي يتعامل بها الإسبان مع السكّان الأصليّين في أمريكا، غير أنّه لم يعترض على مؤسّسات العبوديّة أو الاستعمار بحدِّ ذاتها. على الأقلّ، في البداية، تبنّى وجهة النظر القائلة بأنّه يجب استقدام الأفارقة المستعبَدين للقيام بالأعمال التي كان الفاتحون يرهقون ويعذّبون بها السكّان الأصليّين لأمريكا. ووفقًا للاس كاساس، إنّ فكرة أنّ القوانين الأخلاقيّة والحقوق العالميّة يجب عليها أن تحدّ من المطالبات بالقوّة والسلطة، كانت غائبة تمامًا لدى الطرف الأثينيّ في الحوار، على الرغم من أنّ الميليانيّين قد حاولوا الدفاع عنها. ويفيد التاريخ بما حدث لهم: بعد حصار طويل وقتال، قُضيَ على الرجال، وبيعَت النساءُ والأطفالُ عبيدًا، ولم يحدث ذلك بدافع عنصريّ، بل كان نمطًا يُعد طبيعيًّا لآلاف السنين.
هذا كافٍ لحمل المدافعين عن التنوير على ذرف الدموع. كم من المرّات سمعت أو قرأت عبارات تعلن، في أفضل الأحوال، عمّا يُسمّى بـ “ازدواجيّة التنوير”؟ “لقد كان عصر التنوير عصر العقل وحقوق الإنسان، ولكنّه كان أيضًا عصر العبوديّة والاستعمار”. (هذه العبارة وُضعت وكأنّها تعويذة في معرض كانط في بون). وهذا لا يخلط بين السببيّة والارتباط فحسب؛ بل يقلب التاريخ وتاريخ الأفكار رأسًا على عقب. فما شرع به مفكّرو التنوير ليس هو الدفاع عن الاستعمار، بل شرعوا بمناهضته. ولم يقوموا بذلك من خلال الادّعاءات العامّة المتعلّقة بالكرامة وحقوق الإنسان، بل أيضًا من خلال أمثلة محدّدة للغاية، لدرجة أنّهم حاجّوا وناقشوا مسألة أنّ الشُّعوب غير الأوروبيّة لها الحقّ في مقاومة الاستعمار.
معظمكم على معرفة بالفقرة الواردة في كتاب “السلام الدائم” التي يناقش فيها كانط أنّ الاستعمار يولّد كلّ أنواع الشرور التي تصيب الجنس البشريّ. وعلى الرغم من إشادته بحكمة الصين واليابان في إغلاق أبوابهما في وجه الغزاة الأوروبيّين، فإنّ انتقاده للاستعمار لا يقتصر على غزو الثقافات العريقة والمتقدّمة. ففي الوقت الذي كانت فيه القوى الاستعماريّة الناشئة تبرّر غزوها واستيلاءها على أراضي السكّان الأصليّين في إفريقيا وأمريكا، بحجّة أنّ تلك الأراضي غير مأهولة، وشعوبها غير متحضّرة، أدان كانط هذا الظلم الذي “اعتبر سكّان هذه الأراضي لا شيء”.
أمّا ديدرو فقد ذهب من جهته إلى أبعد من ذلك، إذ رأى أنّ السكّان الأصليّين المهدَّدين من قبل المستعمرين الأوروبيّين، سيكون المنطق والعدالة والإنسانيّة إلى جانبهم، إن قاموا بكلّ بساطة بقتل الغزاة على غرار قتلهم للوحوش البريّة التي كان يمثّلها هؤلاء الغزاة الدخلاء. وقد حثّ شعب الهوتنتوت على عدم الانخداع بالوعود الكاذبة التي أطلقتها شركة الهند الشرقيّة الهولنديّة التي قامت مؤخّرًا بتشييد مدينة كيب تاون.
يقول ديدرو: “حلّقوا، أيّها الهوتنتوت، حلّقوا… امتشقوا فؤوسكم، وشدّوا أقواسكم، وأمطروا هؤلاء الغرباء بوابلٍ من السهام المسمومة. وعسى ألا يبقى منهم أحد على قيد الحياة، ليحمل نبأ كارثتهم إلى بلاده”.
لو قمت بتحديث آلات الحرب المستخدمة في هذا السياق، فستعتقد أنّك وقعت على اقتباس لفرانتز فانون. هذه الفقرة ليست بحالة شاذّة: فالفيلسوف في القرن الثامن عشر دعا إلى مقارعة الاستعمار بالعنف، على نحو مماثل، لا بل بشكل أشدّ قسوة يتفوّق على دعوات الطبيب النفسيّ في القرن العشرين.
لم تكتفِ الانتقادات في عصر التنوير للإمبراطويّة بالإشارة فقط إلى بطش الأخيرة ووحشيّتها، بل قاموا أيضًا بتفكيك النَّظريّات المُستخدمة التي سعت إلى تبرير سرقة أراضي وموارد الشعوب الأصليّة. وكانت إحدى أهمّ هذه النظريّات هي نظريّة قيمة العمل التي وضعها جون لوك التي استُخدمت للزعم بأنّ البدو الرحّل لا يملكون الحقّ في الأراضي التي يمارسون الصيد وجمع الطعام فيها. ووفقًا للوك، لا يحصل النَّاس على الملكيّة إلا عبر الزراعة، وذلك من خلال امتزاج عملهم وجهدهم مع الأرض التي يعملون بها، ومن ثم يحصلون على حقّ ملكيّتها.
ولكنّ كانط هنا كان له رأي مخالف، إذ يقول:
“إن كان هؤلاء الأقوام من الرعاة أو الصيّادين (مثل الهوتنتوت والتونغوسي أو معظم الشعوب الهنديّة الأمريكيّة) يعتمدون في معيشتهم ورزقهم على مساحات شاسعة مفتوحة من الأراضي، فلا يجوز تحقيق الاستيطان (الأجنبيّ) بالقوّة، بل بالتعاقد. وهذا العقد لا يجوز له استغلال جهل هؤلاء السُّكان فيما يتعلّق بالتنازل عن أراضيهم”.
لم يكتف كانط هنا بتقويض نظريّة لوك في الملكيّة، بل أدان أيضًا طريقة الاستغلال المخزي للأقوام الذين لا مفهوم للملكيّة الخاصّة في الأرض لديهم، إذ قد يتنازلون عن جزيرة مانهاتن مقابل حفنة من الخرز. لقد رفض النُّقّاد المتأخّرون هذه الحجّة ضدّ الاستعمار الاستيطانيّ معتبرين أنّ كانط لم يكن قادرًا على الحكم في المسائل الثقافيّة أو التاريخيّة، وحجّتهم في ذلك أنّ “الشعوب البدائيّة” تفتقر إلى مفهوم القانون، ومن ثم فهي غير قادرة على الدخول في عقود ومعاهدات.
إنّ الإعلان بأنّنا نحن أيضًا بشر يكمن في جوهر كلّ ثورة
إنْ كان أفضل مفكّري عصر التنوير قد أدانوا السطوة الهائلة للأراضي وسرقتها التي شكّلت الإمبراطوريّات الأوروبيّة، فما كان رأيهم في السرقة الواسعة للأقوام أنفسهم؟ لقد أدان معظمهم العبوديّة بشكل لا لبس فيه، على الرغم من أنّ بعضهم لم يدرك مباشرة عواقب آرائه. غير أنّ العديد منهم أيضًا ندّد بتواطؤ الأوروبيّين في الحفاظ على العبوديّة، حتّى أولئك الذين لم يكونوا أنفسهم من مالكي العبيد. يصوّر فولتير في رواية “كانديد” رجلًا إفريقيًّا في سورينام بُترت ساقه بعد محاولته الهرب من العبوديّة. يقول هذا العبد: “هذا هو ثمن تناولكم للسكّر في أوروبا”. أمّا ديدرو فقد ذهب إلى أبعد من ذلك. لقد اعتقد أنّ مالكي العبيد لن يتأثّروا بالشفقة أو بالمواعظ الأخلاقيّة، وخلص إلى أنّ على الأفارقة المستعبَدين تحرير أنفسهم بالعنف من الرقّ. وكانت نبوءته بظهور “رجل عظيم، سبارتاكوس أسود” ليقود هذا التحرير، قد ألهمت توسان لوفرتور في سعيه نحو التحرّر من الرقّ. سلّط كانط سهام معارضته للمزاعم الدينيّة التي اختُرعت لتبرير العبوديّة العرقيّة؛ فقبل وقت طويل من قيام الكونفدراليّة الأمريكية كان الزعم بأنّ السود ينحدرون من نسل حام بن نوح الذي لُعن لأنّه كشف عن عورة والده. وللردّ على هذا اللاهوت المشبوه، لجأ كانط إلى المنطق:
“يُخيّل للبعض أنّ حام هو والد الموريّين، وأنّ الله خلقه كعقاب ورثه عنه الآن جميع أبناء ذريته. غير أنّه لا يمكن تقديم أيّ دليل على السبب يجعل اللون الأسود علامة على اللعنة أكثر من اللّون الأبيض”.
من المثير للاهتمام أنّ هذه الفقرة مضمَّنة في مجلّد صادر حديثًا للكتابات التي جُمعت للكشف عن عنصريّة التنوير. ولا يبدو أنّ ناشر الكتاب قد لاحظ أنّ كانط قد نقض حجّة ما زال المسيحيّون المتعصّبون لتفوّق العرق الأبيض يدعمونها حتّى اليوم.
لقد لامست فقط سطح الأدلّة لإدانات التنوير للإمبرياليّة، ولكن كما يعلم الكثير منكم، هناك ما هو أكثر من ذلك بكثير، فبالنظر إلى هذا الكمّ من الأدلّة، كيف تمكّنت أسطورة تأييد التنوير للاستعمار من أن تسود؟ أخشى من أنّ التفسير يسير للغاية، فعلى غرار المفكّرين التقدميّين في كلّ مكان، لم يحقّق مفكّرو التنوير الراديكاليّون انتصارهم في جميع معاركهم. (أنا لست مسؤولة عن حرب العراق أو قصف غزة، ولكن يمكن القول إنّ معارضتي لهما، رغم أنّها كانت مبكّرة وصاخبة واستهلكت الكثير من الطاقة، كانت غير مجدية تمامًا). وفي حين أنّ كانط وآخرين غيّروا تفكير معاصريهم فيما يتعلّق بالعديد من القضايا، إلا أنّهم لم يتمكنوا من إيقاف الاندفاع الأوروبيّ الكبير باتجاه الإمبراطوريّة الذي بلغ ذروته في القرن التاسع عشر. لقد تراجع هذا الخطّ الفكريّ مع مرور القرن الجديد، حتّى إن مفكّرين ليبراليّين مثل جون ستيوارت ميل أيّدوا نسخًا معتدلة من الإمبرياليّة.
ولكن إن لم يتمكّنوا من إيقاف الاستعمار فهم نجحوا في جعله يشعر بالذنب، وأصبحت أفكارهم حجر الزاوية لتوسان لوفرتور وغيره من مناهضي للاستعمار. وكما كتب جان بول سارتر:
“قبل بضع سنوات لم يجد أحد المعلّقين الاستعماريّين البرجوازيّين سوى هذه العبارة للدفاع عن الغرب: نحن لسنا بملائكة. ولكنّنا، على الأقلّ، نشعر ببعض الندم. فيا له من اعتراف!”.
إذا كان تأنيب الضمير وحده هو كلّ ما يمكن لمفكّري التنوير تقديمه، لكان استهزاء سارتر ينطبق عليهم أيضًا. لكن بمجرّد رؤية الأفكار النور، فإنّها تتطلّب التنفيذ. لم يكن لدى الرومان أيّ شعور بالندم أو أيّة حاجة لتبرير إمبراطوريّتهم، كما أنّهم لم يقولوا لرعاياهم إنّ استعمارهم كان جيّدًا ومفيدًا لهم. أمّا بالنسبة للمستعمرين في القرن التاسع عشر، فقد كانوا يتوفّرون، إلى جانب السفن والأسلحة المتطوّرة، على أمر لم يفتقر إليه الإمبرياليّون الأوائل، ألا وهو: الحاجة إلى الشرعيّة. وقد عبّر القوميّ الهنديّ أوروبيندو غوش عن هذا الأمر في القرن التاسع عشر بقوله:
“إنّ فكرة الاستبداد بكلّ أشكاله كان انتهاكًا وجريمة ضدّ الإنسانيّة، وقد تبلورت هذه الفكرة باتجاه الشعور الغريزيّ… كان على الإمبرياليّة أن تبرّر نفسها أمام هذا الشعور الحديث، ولم يكن باستطاعتها القيام بذلك إلا من خلال الادعاء بأنّها وصيّة على الحرية، وقد كُلفت من القدرة العليّة لتحضير غير المتحضّرين”.
هذا هو، ويا للأسف، مصدر الأسطورة القائلة إنّ التنوير شرّع الاستعمار، وكما كتب تزفيتان تودوروف:
“إنّ إسناد التوسّع الاستعماريّ أو “تقسيم إفريقيا” إلى المشروع الإنسانيّ يعني الأخذ بظاهر الكلام والدعاية: إنّها مجرد محاولة فارغة لاستبدال واجهة مبنى شُيد لأغراض مختلفة تمامًا”.
كيف نشأت الأسطورة؟ لقد أدان مفكّرو عصر التنوير الاستعمار، وحاججوا بأنّ العدالة كانت إلى جانب الأمم غير الأوروبيّة التي قتلت الغزاة المحتملين أو أغلقت أبوابها في وجوههم. وبعد نصف قرن، عندما واجه الإمبرياليّون الأوروبيّون انتقادات شديدة باسم الأفكار التي أرادوها لأنفسهم، سعوا إلى إيجاد سبل تتيح لهم الحفاظ على مبادئ الحريّة وتقرير المصير في أوطانهم مع مواصلة انتهاكاتهم في الخارج. وكان الحلّ الذي توصّلوا إليه هو الادّعاء بأنهم سيجلبون تلك القيم إلى الشعوب التي لا تستطيع تحقيقها بمفردها. كما زعموا بأنّ الإمبراطوريّة لم تكن سوى عبء تحمّلوه من أجل مصلحة السكّان الأصليّين، وبأنّهم لم يقوموا بشيء يتعارض مع القيم التي سعوا إلى تحقيقها لشعوبهم، كإنهاء المجاعات، ومكافحة الأمراض، وتحقيق المساواة أمام القانون، بل إنّ المستعمرين كانوا يحملون هذه المنافع والخيرات، إضافة إلى المسيحيّة، إلى الشعوب الجاهلة التي لم تكن تعرفها بعد. لقد كان روسو وديدرو وكانط سيدركون هذه الخديعة بوضوح، وربما بكوا لو رأوا كيف تحولت مثلهم العليا ومبادئهم إلى إيديولوجيّة. لكن النهب كان مغريًا، والنقّاد كانوا قد ماتوا.
إنّ السؤال أليست هي إنساناً؟ كامن في لُغته الأكانيّة الأمّ تمامًا في لغة توماس جيفرسون
باختصار: إنّ جزءًا من نقد ما بعد الاستعماريّة للتنوير يقوم على خطأ تاريخيّ يسير، فالحدث الجديد في القرن الثامن عشر لم يكن الاستعمار، بل مناهضته، وهي مناهضة قادها مفكّرون من عصر التنوير انطلاقًا من مبادئ التنوير نفسها. إلا أنّ حركة المعارضة أو المناهضة هذه قد خسرت، وتوسّع الاستعمار وتمدّد، ليس فقط من خلال سفن أسرع وأسلحة أكثر فتكًا، بل أيضًا من خلال مبادئ التنوير التي استُغلت كدعاية بحتة، على حدّ قول تودوروف.
ولكنّ هناك جزءًا آخر من النقد أكثر عمقًا من جديد لكي نقدّم خلاصة يسيرة لوجهات نظر موجودة في العديد من المصادر، ولكن عُبِّر عنها بوضوح من قبل أعمال تشارلز ميلز: إنّ نظريّة التنوير السياسيّة التي سبقته ومهّدت له، هي نظريّة عنصريّة بشكل موضوعيّ، كونها لم تتناول مسألة العنصريّة. لو كان ذلك صحيحًا لكانت عالميّة التنوير خدعة وعمليّة احتيال. ومن خلال التجرّد من الفروقات في العرق والطبقة والأمّة وتجاهلها، قام مفكرو التنوير بتدوين عرقهم وطبقتهم وجنسهم (وهي فئة لم يأخذوها بعين الاعتبار) ضمن ما افترضوه مبادئ عامّة. لقد كانت الحقائق الشاملة والمصالح والأهواء تجسيدًا لميول واهتمامات أصحاب الأملاك الذكور. وقد كان هذا التجريد لخصائص الأشخاص الذين يُعدون ذوي قيمة أقلّ فيما يتعلّق بقضايا العدالة، طريقة مموّهة لإرساخ جنس وطبقة معيّنين في شيء يبدو متساميًا فُرض على الجميع بشكل ضمنيّ. والصحيح في هذه الادّعاءات هي حقيقة أنّ العديد منّا، ودون تذكيرنا، يميل في الغالب إلى التفكير بطريقة شاملة وعالميّة، لأنّهم من ذوي اللون الأبيض وليس الأسمر، لأنّهم ذكور وليس إناثًا، أشخاص ذوو ميول طبيعيّة وليسوا مثليّي الجنس، وهنا تكمن فائدة بعض المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التنوّع.
ولكن في خضمّ سعينا لزيادة التنوّع نسينا مدى عظمة الإنجاز الذي تتحقق في نقل التجريد الأصليّ للإنسانية . لقد كانت الافتراضات السابقة محدودة الطبيعة في ذاتها، تمامًا كما كانت الأفكار القانونيّة السابقة دينيّة، غير أنّ فكرة وجود قانون واحد يجب أن ينطبق على النبلاء والفلاحين، على البروتستانت والكاثوليك، على اليهود والمسلمين، فقط لأنّهم يتشاركون في الإنسانيّة، فهذا إنجاز حديث بات يصوغ افتراضاتنا بشكل عميق لدرجة أنّنا لم نعد نعده إنجازًا على الإطلاق. علينا أن نقوم بتقدير هذا الأداء التجريديّ، حتى ولو جاء من مفكّري التنوير الذين لم يتمكّنوا من الصّعود فوقه وتخطّيه وظلّوا عالقين في حبال الأحكام المحليّة المُسبقة.
فلنتأمّل الآن بالنقيض: إنّ وجهات نظر كتلك التي عبّر عنها كارل شميت الذي كتب أنّ “كلّ من يذكر كلمة ‘الإنسانيّة’، يحاول خداعك”. ولم يكن هذا الادّعاء مستحدثًا شأنه شأن العديد من أقواله، إذ كان يردد آراء المفكّر اليمينيّ جوزيف دي مايستر الذي كتب عام 1797:
“حاليًّا لا يوجد شيء اسمه “إنسان” في هذا العالم. لقد رأيت في حياتي فرنسيّين وإيطاليّين وروسًا وغير ذلك. وأعلم، بفضل مونتيسكيو، أنّه يمكن للمرء أن يكون فارسيًّا. أمّا فيما يتعلّق بالإنسان، فإنّي أعلن أنّي لم أقابله قط”.
شميت أكثر تعقيدًا إلى حدّ بعيد، ولكنه أكثر إثارة للرعب أيضًا. في الواقع يشير شميت إلى أنّ المفاهيم العالميّة مثل الإنسانيّة هي اختلاقات وتلفيقات يهوديّة تهدف إلى إخفاء مصالح يهوديّة تسعى إلى السلطة والسيطرة في مجتمع غير يهوديّ. ويقترب هذا الطرح بشكل خطير من الحجّة السائدة اليوم والقائلة إنّ عالميّة التنوير تخفي مصالح أوروبيّة خاصة تسعى إلى السلطة والهيمنة في عالم غير أبيض على نحو متزايد.
ولم يدرك أيّ من ناقدي حركة مناهضة التنوير، أو التنوير المضادّ، أنّ الإنسان ليس مفهومًا تجريبيًّا ككلب مثلًا، أو المواطن الفرنسيّ الذي يمكن التعرّف عليه بعد ثوانٍ من الملاحظة. وبدلًا من تكرار مقولة شميت الشهيرة، يمكن للمرء أن يقول: “من ينطق بمصطلح ‘الإنسانية’ فإنّه يقدّم ادّعاءً معياريًّا”. ومن وراء ذلك يمكن أن تتخفّى صياغة شبيهة بالجملة الأولى من القانون الأساسيّ الألماني: “كرامة الإنسان لا يجوز المسّ بها”. كبيان للحقيقة، فإنّ هذا الأمر مثير للسخرية؛ فقد صيغت هذه الكلمات بعد سنوات قليلة فقط من انتهاك الرايخ الثالث لكرامة الإنسان بطرق غير مسبوقة ولا يمكن تصوّرها. إنّ ما يقصدون بها هو فعل إلزاميّ: أي إنّ الاعتراف بشخص ما كإنسان يعني الاقرار بكرامته الواجب احترامها. ويعني ذلك أيضًا أنّ هذا الاعتراف يعدّ إنجازًا؛ فرؤية الإنسانيّة بكلّ مظاهرها الغريبة والجميلة يتطلّب تجاوز المظاهر السطحيّة. بهذا المعنى كان فوكو محقًّا حين قال إنَّ “الإنسان اختراع حديث”. وكشأن منتجات الحداثة الأخرى، لم يمنحها فوكو التقدير، بل توقّع أن تختفي. فقد كتب يقول: “مهمّتنا هي التخلّص من النزعة الإنسانيّة”– الأمر الذي يتطلب قبول “موت الإنسان”، كما علّل ذلك في كتابه “الكلمات والأشياء”.
مفكرو التنوير معارضين بشدّة للطبيعة … لكنّهم كانوا يدركون عدد المرّات التي يُبرَّر فيها الاضطهاد بادّعاءات النظام الطبيعيّ
إنّ عمليّة الارتقاء بـ”الإنسانيّة” إلى مستوى التجريد أمر متقلقل محفوف بالأخطار، والأسهل التفكير فيه من تطبيقه عمليًّا. إذا كان الاعتراف بإنسانية شخص ما يعني الاعتراف بحقّه في أن تتمّ معاملته بكرامة، فإن استعباده أو إبادته يعدّ إنكارًا لإنسانيّته وحرمانه منها. فلنفكّر في السود الذين عوملوا كدوابّ للحمولة والعمل، أو في اليهود الذين عوملوا كالهوام. وخلال حرب فيتنام، كان من الشائع أن نسمع المعلّقين الأمريكيّين يشرحون بجدّيّة مفرطة أنّ الآسيويّين يهتمّون بالموت بشكل أقلّ من بقيّة الشعوب.
يمكن العثور على جذور النظرة المجرّدة للإنسانيّة في النصوص اليهوديّة والمسيحيّة التي رأى بعضنا أنّها خُلقت على صورة الله ومثاله، ولكنّ التجريد في حركة التنوير قام على العقل وليس على الوحي. فمن الفكرة القائلة بأنّ جميع الناس، بغضّ النظر عن اختلافاتهم، لهم الحقّ في التمتّع بالكرامة فقط لكونهم بشرًا، لا يمكن التصوّر والاستنتاج أنّ تلك الاختلافات غير ذات أهمية. بل تضيف التواريخ الفرديّة والثقافات اللحم على عظام الإنسانيّة المجرّدة. ويعقب ذلك مسألة المطالبة بالعدالة المتساوية التي ينبغي أن تكون مضمونة لكلّ امرئ، بغضّ النظر عن التاريخ الشخصيّ الذي عاشه، أو الثقافة التي ينتمي إليها ويعيش فيها.
إنّ عمليّة التجريد باتجاه مفهوم الإنسانية تتطلّب استخدام العقل من أجل تجاوز المظاهر الشكليّة الخارجيّة التي تمنحنا أجسادًا بألوان وهيئات مختلفة. وكما يؤكّد العديد من أتباع ما بعد الاستعماريّة فإّن هذه الذوات المتجسّدة هي طبيعيّة وحقيقيّة، في حين يُعد العقل التنويريّ، كما يُزعَم، أداة للسيطرة، ولا سيّما للسيطرة على الطبيعة. ويا للأسف فإنّ فقرات وردت في كتاب “جدليّة التنوير” تعزّز مثل هذه الآراء، غير أنّه لا وقت لديّ اليوم لمناقشتها، ولكن أودّ أن أشير فقط إلى فكرة أنّ العقل معادٍ للطبيعة تقوم على تعارض ثنائيّ بين العقل والطبيعة، وهو ما لم يكن لأيّ مفكّر من مفكّري التنوير أن يتقبّله. وقد يظهر أنّ الطَّرفين على اختلاف وصراع فيما بينهما، لأنّ قدرة العقل على طرح التساؤلات حول ما هو طبيعّي وما هو غير طبيعيّ تعدّ الخطوة الأولى نحو أيّ شكل من أشكال التقدّم. كان أحد الأهداف الرئيسة لدراسة الثقافات غير الأوروبيّة في عصر التنوير هو التشكيك وإعادة النظر في عدد كبير من المؤسّسات الأوروبيّة التي كانت سلطتها تستند إلى إصرار الكنيسة والدولة على أنها “طبيعيّة”، ومن ثم غير قابلة للتغيير. من الأمور التي كانت تُعد أمرًا طبيعيًّا في القرن الثامن عشر: العبوديّة والفقر وخضوع المرأة وانقيادها، والتسلسل الهرميّ الإقطاعيّ ومعظم أشكال المرض. وحتّى في القرن التاسع عشر كان بعض رجال الدين الإنكليز يُحاجُّون بأنّ أيّة محاولة للتخفيف من المجاعة في إيرلندا تُعدّ انتهاكًا للنظام الإلهيّ. لم يكن مفكرو التنوير معارضين بشدّة للطبيعة أو للشهوة، وهما موضوعان تطرّقوا إليهما بشكل معمّق لا يقلّ قدرًا عن أيّ موضوع آخر. لكنّهم كانوا يدركون عدد المرّات التي يُبرَّر فيها الاضطهاد بادّعاءات النظام الطبيعيّ، وكانوا مصمّمين على استخدام العقل لإخضاع تلك الادّعاءات إلى الفحص الدقيق. وفي كلّ مرة تُحاجُّ فيها بأنّ الفوارق وعدم المساواة الاقتصاديّة أو العرقيّة أو بين الجنسين ليست حتميّة، فإنك تستخدم هنا عقلك لتحدّي أولئك الذين يصرّون على أنّ هذه الفوارق وعدم المساواة هي بكلّ بساطة جزء من العالم.
لقد كان روسو وديدرو وكانط سيدركون هذه الخديعة بوضوح، وربما بكوا لو رأوا كيف تحولت مثلهم العليا ومبادئهم إلى إيديولوجيّة
نحن لا نحتاج إلى العودة بالتفكير إلى القرن الثامن عشر لنفهم مدى التطرّف وأهميّة تجريد العرق والطبقة والجنس، فيكفي أن نتخيّل دونالد ترامب أو ناريندرا مودي أو بنيامين نتنياهو قد أعلنوا موافقتهم على النظر إلى العالم من منظور الأمر المطلق- ولو لساعة واحدة فقط- لندرك أنّ هذا المنظور أبعد من أن يكون فارغًا أو أيديولوجيًّا بالمعنى الذي حمّله إيّاه تشارلز ميلز. “إنّ الإعلان بأنّنا نحن أيضًا بشر يكمن في جوهر كلّ ثورة”، على حدّ قول جان بول سارتر. ولا يعني هذا القول أنّ سارتر نظر إلى البشر على أنّهم بلا هوية أو جسمانيّة، بل يعني بكلّ بساطة أنّ التجريد المتضمَّن في الانتقال من “الجزائريّ” إلى “الإنسان” مع كامل الحقوق والواجبات التي يتمتّع بها “الفرنسيّ”، لا يجب أن يكون شكلًا من أشكال القمع، كما يشير إلى ذلك أتباع ما بعد الاستعماريّة. وعلى العكس من ذلك، يمكن أن يكون ذلك الخطوة الأولى نحو التحرّر: فكل حُجّة مُناهضة للعبوديّة، أو للاستعمار أو للعنصريّة أو للتحيّز الجنسيّ متمثّلة في السؤال: “أليست هي إنسانًا؟”
يقول الفيلسوف الغانيّ أتو سكيي – أوتو: إنّ السؤال كامن في لُغته الأكانيّة الأمّ تمامًا في لغة توماس جيفرسون الإنكليزيّة. ويعتبر سكيي – أوتو أنّه من الإهانة اعتبار أنّ فكرة الإنسان يجب استيرادها من أوروبا. وبكلّ حزم يستخدم فلسفة اللّغة العاديّة لمحاججة ومعارضة ادّعاء جوديث بتلر بأنّ هناك “كانط” موجود في كلّ ثقافة، عادًّا ذلك فرضًا أو إخضاعًا ثقافيًّا أوروبيًّا مركزيًّا. ويذكر سكيي – أوتو في كتابه “العالميّة اليساريّة”: هذا ليس فرضًا أو إخضاعًا على الإطلاق”، “فلغاتنا الأمّ تؤدّي هذا العمل بانتظام”. وهو إنّما يعتمد في ذلك على أفضل معارف فلسفة اللّغة العاديّة، ويحضّنا على الالتفات إلى ما يقوم به المتكلمّون باللغة الأمّ عندما يبرّرون مطلبًا أخلاقيًّا. ويضيف قائلًا: “من الواجب أن يُحسب لأوروبا الفضل بأنّها أضفت على الحدس والأحلام المشتركة للبشريّة مصطلحًا رسميًّا ومؤسّساتيًّا، ولكن لا تمنحوا الغرب حقوق الملكيّة الحصريّة”.
إنّ ما رُفض في الماضي بوصفه شخصنة أو قدحًا شخصيًّا يسمّى اليوم بالتحديد الموقفيّ أو الموضعيّة. أقول ذلك بشيء يسير من الدعابة، لأنّني أعتقد أنّ فكرة التحديد الموقفيّ أضحى مبالغًا فيها بشكل كبير، غير أنّها في بعض الأحيان وسيلة جيّدة للتحقّق من كونك تعتقد بأنّ شيئًا أو آخر هو عالميّ. ولهذا السبب بدأت بالبحث عن انتقادات للافتراضات الأساسيّة لنظرية ما بعد الاستعماريّة من قبل أشخاص ينتمون إلى ما يسمّى بالجنوب العالميّ”. هذه الانتقادات هي أكثر شيوعًا ممّا تظنونّ؛ يمكنكم الاستماع إلى البعض منها في مؤتمر “التنوير في العالم” الذي سيعقده منتدى أينشتاين في نهاية أغسطس/آب. ولأنّنا ننطلق اليوم من افتراض أنّ كلّ شخص من الجنوب العالميّ سينحو باتجاه نظريّة ما بعد الاستعماريّة، فإنّنا نقبل قراءات وتفسيرات النصوص التي حَرّفها وشَوَّهها أتباع ما بعد الاستعماريّة، لذا سأختم كلمتي بهذا الاقتباس:
“ليس العالم الأسود من يحدّد سلوكي. بشرتي السوداء ليست مستودعًا لقيم محدّدة. فالسماء المرصعة بالنجوم التي ألقت الرهبة في كانط، كانت قد كشفت لنا أسرارها منذ زمن طويل”.- بشرة سوداء، أقنعة بيضاء.
1. المحرر: ما بعد الكولونيالية أو (Postcolonialism).
البروفيسورة سوزان نايمان
فيلسوفة وكاتبة أمريكية، وهي مديرة منتدى أينشتاين في بوتسدام منذ عام 2000. درست الفلسفة في جامعة هارفارد، وجامعة برلين الحرة. عملت أستاذة للفلسفة في جامعة ييل وجامعة تل أبيب. لقد كتبت على نطاق واسع عن عصر التنوير، والفلسفة الأخلاقية، والميتافيزيقا، والسياسة، وأظهرت مرارًا وتكرارًا أنّ الفلسفة هي قوة حيوية للفكر والعمل المعاصر.
من الناحية السياسية قامت بحملة احتجاجية في المقام الأول ضد السياسة الأمريكية في حربيها على فيتنام والعراق، وعملت مساعدةً في حملة باراك أوباما. كانت السيدة نايمان عضوًا في معهد الدراسات المتقدمة في جامعة برينستون، وزميلًا في مركز دراسات مؤسسة روكفلر في بيلاجيو بإيطاليا، وزميلًا كبيرًا (سنيور) في المجلس الأمريكي للجمعيات العلمية. وهي اليوم عضو في أكاديمية برلين براندنبورغ للعلوم والجمعية الفلسفية الأمريكية. وألَّفت تسعة كتب تُرجمت إلى 15 لغة، وحازت على جوائز من منظمة NEP، ورابطة الناشرين الأمريكيين، والأكاديمية الأمريكية للدين، وغيرها. ظهرت نصوصها في نيويورك تايمز، ومجلة نيويورك ريفيو أوف بوكس، وذا غلوب آند ميل، والغارديان، ودي تسايت، ودير شبيغل، وفرانكفورتر ألغماينه تسايتونج، والعديد من المطبوعات الأخرى.