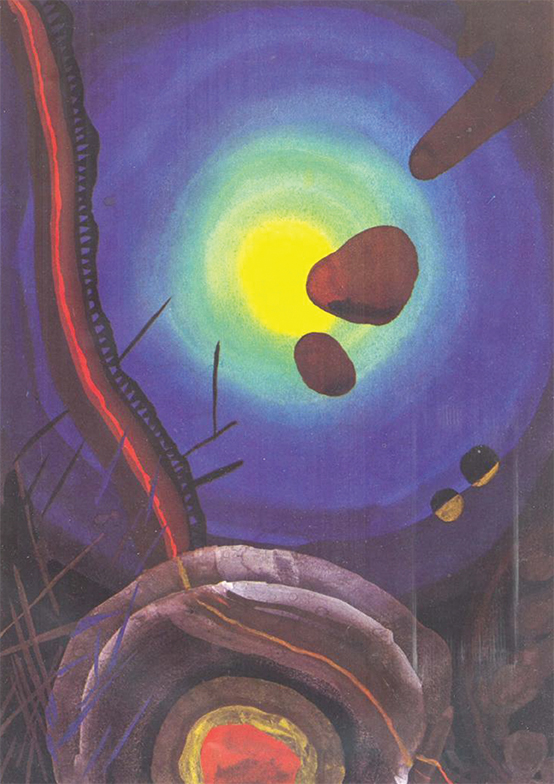لا شكّ فِي أنّ كلّ مَنْ تابع مَسرحيات الأخويْن رحباني، عاصي ( 1923 – 1986 )، ومنصور (1925 – 2009)، والفنانة فيروز (1934)، وأحيانًا الفنانة صباح (1927 – 2014). قد لاحظ أنّ فكرة الوطن، بمستوياتها المختلفة، قد شكّلتْ الركيزة الأساسيّة فِي أعمالهما معًا، والّتي امتدت على الخشبة مِن العام 1957 إلى العام 1984. عملهما المسرحيّ الأول جاء على شكل لوحات غنائيّة وعنوانه “لوحات وتقاليد”، قُدِّم في بعلبك. وعملهما المشترك الأخير حمل اسم “الربيع السّابع”، وجرى تقديمه على مسرح جورج الخامس في أدونيس( شمالي بيروت).
هذه المَسيرة الفنيّة الغنيّة الّتي شملت ما يربو على العشرين عملًا -ما بين أوبريت غنائيّة، ومسرحيّة شبه متكاملة المواصفات الفنيّة- هي العمود الفقري للتراث الرحباني الواسع الانتشار في لبنان وفي العالم العربي، مع ما بين هذا التراث من تفاوت في التوجّه ناجم، مِن دون أدنى شك، من اكتسابهما، بعد كل عمل، المزيد من الخبرة والثقافة، والنضج، والثقة الفنيّة بالنفْس. وقد وصلا، بفضل نجاحاتهما الشعبيّة الواسعة وبفضل نجوميّة السيّدة فيروز، إلى مرحلة شكّل فيها مسرحهما حالة تشُبه الوجدان الشعبي، ليس في لبنان وحده ولكن كذلك في معظم أقطار العالم العربي.
وعشق الوطن عشقًا رومانسيًّا خالصًا ومتفانيًا هو جزء لا يتجزّأ من مفهوم وطن الأغنية الرحبانيّة في تلك المرحلة
وصورة الوطن في المسرح الرّحباني، لاسيما في البدايات، هي صورة بسيطة للغاية، وهي كذلك مثاليّة إلى حدود بعيدة بحيث اعتبرها كثيرون بأنها مجرّد وهم جميل لا يمكن أن نشهد له ترجمة فعلية على أرض الواقع.
فالوطن عندهما، تلك المرحلة، هو القرية البريئة، كي لا نقول البدائيّة. صحيح أن أبناء القرية يتشاحنون ويتقاتلون، ولكن الحل يأتي دائمًا على يد شخصيّة أبويّة يرتضي معظم أبناء القرية حكمها. وقوام هذا الحل يرتكز على المحبّة والإنفتاح والتسامح الرومانسي: “القمرْ بيضوّي عَ الناس/ والناس بيتقاتلو/ عَ مزْارع الأرض الناس/ عَ حجْار بيتقاتلو/ نحنا ما عنّا حجرْ/ لا مزْارع ولا شجرْ/ انتي وأنا يا حبيبي/ بيكفّينا ضو القمرْ/. لذلك فإن نهاية كل المشاكل في هذا الوطن/ القرية، تقوم دائمًا على مقاربات متفائلة ومثاليّة، أي يوتوبيّة وهميّة: “ديرو الميّ ديرو الميْ/ خللي يشربْ كل الحيْ/ خللي تشربْ كل الدنيي/ ويعْلى الزرْع ويحلى الفيْ/”
بالتأكيد لم يكنْ واقع الوطن اللبناني – ولا أي وطن آخر في العالم – بمثل هذه الطوباويّة، لكن علينا أن نعرف، وأن نعترف بذلك، أن وطن الأغنية شيء ووطن الواقع شيء آخر مختلف تمامًا.
والوطن الفولكلوري، عند رحابنة المرحلة الأولى، هو وطن التبادل التجاري والزراعي بين الناس حينًا، وبين الدول حينًا آخر. وفي هذا تجسيد واضح لصورة الفينيقي الشاطر الراسخة في ذهن العديد من اللبنانيين، وهو الذي تُنْسَب إليه أمور جلل ، ليس أقلها اختراع الأبجديّة وتعليم العالم القديم كله وصناعة السفن التي جابتْ العالم القديم بأسره:
“بدْنا نتاجرْ/ ناخدْ ونعطي/ نْسَفِّرْ مراكبْنا عَ كل شط بهالدني/ وبكل شط بهالدني/ تنزلْ مراكبنا/”، وإذا بالإزدهار الناتج عن تلك التجارة البحريّة الناشطة يحمل في كلّ يوم المزيد من الثروات والبحبوحة لأبناء هذا الوطن: “مراكبْنا تروح وترجعْ/ تشْحن بضايعْ وترجعْ/ صار عنّا أسطول تجاري/ بدّو يقْطًعْ المصاري/”.
ووطن الأغنية الرحبانيّة، على صورة القرية ومثالها، منفتح على العالم وأبناؤه متحابّون متحاورون
ومن ملامح طوباويّة الصورة الخاصة بالوطن الرحباني أن يكون هناك تكامل وتعاون بين السلطة القويّة والفنون الشعبيّة ليكتمل حضور الوطن المزدهر والمستقِر: “أنا بسيفي بحرّرْ هَ المناطق/ وبحقّقْ لبنان/ وانتِ بالغنيّي بتخلّيلو اسمو/ يزهّرْ وينْ ما كان”/”. هكذا يفاخر المواطن، في المفهوم المسرحي الرحباني، تلك المرحلة، بوطنه الكامل الأوصاف والمسْتوْفي كلّ شروط الأوطان: “القوي لبنان/ الغني لبنان/ الهنا والجنا/ بسما لبنان/”.
وعشق الوطن عشقًا رومانسيًّا خالصًا ومتفانيًا هو جزء لا يتجزّأ من مفهوم وطن الأغنية الرحبانيّة في تلك المرحلة: “بنْدُرْ صوتي/ حياتي وموْتي/ لمجد لبنان/”. هكذا يتكرّس الوطن أبديًّا سرْمديًّا عاصيًا على كل تهديد أو خطر زوال: “واللي بدْنا نقولو قلناه/ إنّو لبنان كان وصار وبدّو يبقى/”.
ووطن الأغنية الرحبانيّة، على صورة القرية ومثالها، منفتح على العالم وأبناؤه متحابّون متحاورون: “وما زال في جْسورا/ بها الأرض مشْرورا/ بدّن يضلّو الناس/ يجُو لَعند الناس/ وتْزورنا الدنْيي ونْزورا/”. وهم مؤمنون بوطن له دورٌ أكبر من مساحته ومسالم: “يا زغير وبالحق كبير/ وما بيعْتدي/ يا بلدي/” و” بلاد بدها تتْقدم/ ما حدا بيردّا/(…) لا رحْ نتْعدّى عَ حدا/ ولا حدا عليْنا يتْعدّى/”.
وكذلك وطن الأغنية محبوب دائمًا: “خدْني زرْعني بأرض لبنان”، وهي مَحبّة تشكّل جزءًا من التربية البيْتيّة التي ينادي بها الرحابنة بتعميمها على كلّ البيوت والعائلات. وخير مثال على ذلك وصيّة الأب لأبنته العروس قبل أن تؤسّس عائلتها الجديدة: “وربّي ولادِك عَ الرضى/ بالمحبّة والرضى/ بتزَّهر الأرض وهيْك/ بيشعْ الفضا/ وزْرَعيُنْ بالوعر أرز وسنديان/ وقوليلهنْ لبنان، بعد الله / يعْبدو لبنان/”.

لكنّ هذا الوطن المعشوق في كلّ الظّروف لا يمكن أن تكون الحياة فيه نزهة جميلة دائمًا. لا بدّ من النّضال ليستحقّ المواطنون أن يعيشوا بحريّة وأمان واستقرار. لذلك هناك مُفترق حاسم في وطن الأغنية حدث في مسرحيّة “أيام فخر الدين”، عندما صرخ الأمير فخر الدين المَعني الثاني الكبير(1572 – 1635) في رجاله قائلًا: “بدْكُنْ الاستقلال؟/ اعتمْدو عَ الله / وعَ حالكنْ/خدوه بالقُوّي/ بيضربة السيف اللي بتْضوّي/”
قلتُ إنّ هذا الكلام شكّل المفترق، أو هو النقلة النوعيّة بين وطن الأغنية ووطن الواقع. وليس مُصادفة توزُّع المسرح الرحباني على ثلاث مراحل: من البداية إلى ما قبل “أيام فخر الدين” الّتي بدأ فيها التحوّل الحقيقي – مرحلة “الشخص” (1968)، “جبال الصوّان” (1969)، “يعيش يعيش” (1971)، “بترا” (1977) – ومرحلة “المؤامرة مستمرّة” (1980) ، و”الربيع السابع” (1984)، وهي مرحلة الحرب الأهليّة.

اللبنانيّة التي غادر فيها الرحبانيان نهائيّا، واللبنانيون عموما، حياة الإسترخاء والطمأنينة ووهم الاستقرار وما كان يُعتَقَد أنه سلام دائم.
باختصار، فكرة الوطن الواقعي بدأت، انطلاقًا من المرحلة الثانية، تصبح ملموسة. طبعًا، وعلى عادة الرحبانييْن، ظلت الأغنية موجودة، بمعنى صورة الوطن الجميل، ولكن التركيز على الوطن الواقعي، مثله في هذا مثل بقية الأوطان، صار واضحًا أكثر. والنماذج على هذا المنحى الجديد كثيرة: “الدولة بدها تقبضْ/ يا بتقبضْ مِنْ الأهالي/ وبتْحسّنْ وضع الأهالي/ يا بدْها تقبض من برّا/ وتصير متْزلْمي لَ برّا/”. وصارت المطالبة بالعدالة الاجتماعيّة ملحّة أكثر: “وكان في ولاد عمْ يلعبو بالشمس/ وتيابن مخزْقة/ الولاد بدّنْ يكبرو/ ما بيقدرو ينطرو تَ يصير في حكومي/” ، أو “لا تخافو/ ما في حبوس بتْساع كل الناس/ بيعْتقْلو كتيرْ/ بيبقى كتيرْ/ وبللي بيبقو رحْ منكمّلْ/”.
من دون شك، غنائيّة المرحلة الأولى التي ولّدتْ وطن الأغنية المثالي، أخلتْ المكان، بدءًا من فجر المرحلة الثانية، أمام واقعيّة النضج الفكري التي أنتجتْ وطن الواقع. وأعتقد أن الأخويْن رحباني، ومعهم كلّ اللبنانيين، قد لمسوا لمْس اليد إن وطن الأغنية غير قابل للحياة إلا… في الخيال.
د. غوى سعادة
تحمل شهادة دكتوراة في طب الأسنان من جامعة القديس يوسف، بيروت. تابعت تخصصها في معاهد ومستشفيات باريس في اختصاص طب الأسنان عند الأطفال وفي تقويم الأسنان. لها دراسات منشورة في مجلات علميّة. كما لها اِهتمامات في الآداب الشَّعبيّة وفِي شؤون الصّحة والتغذية والبيئة. وقد نشرت مقالات في هذا المجال في أكثر من مجلة، ودوريّة.