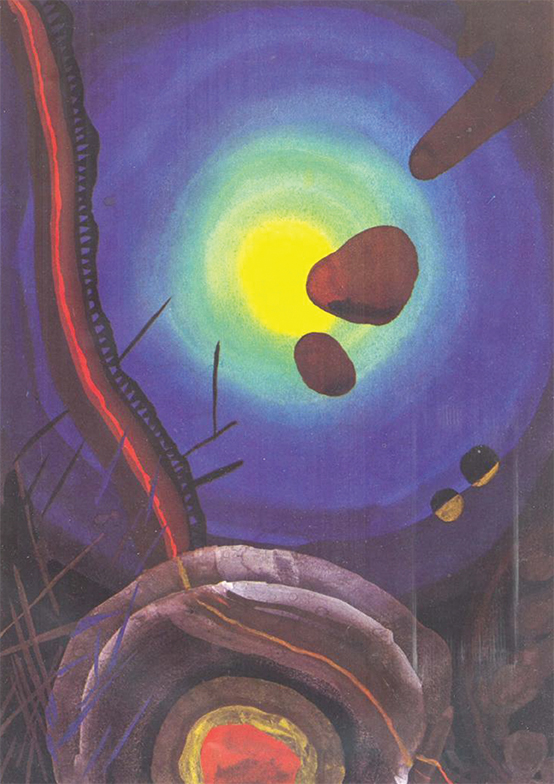“يمكنك أن تصاب بالجنون في محاولة للكتابة عن مدينة”.
دواير ميرفي، روائي أمريكيّ.
أن تحاول كروائيّ أو كاتب مُذكَّرات اِتخاذ مدينة ما موضوعًا، فتقبض على روحها لتبني نصوصك حولها وفي أجوائها المكانيّة، لتبدو بالفعل مَهمّة مُحيّرة حدَّ الاِستحالة. فعن ماذا ستكتب:
عن المدينة التي كنت تعرفها صغيرًا، شوارعها التي تغيَّرتْ ومَحلاتها التي اختفت ومقاهيها التي لم تعد قائمة، فلم تعد مدينتك حينها تشبه الحالية في شيء؟ أو عن المدينة التي سيعثر عليها الزوار غدًا إن جاؤوا سائحين، حيث الشّوارع العريضة والمباني الكبيرة والمطاعم الشّهيرة والأضواء، أم تلك المُختفية فِي الشّوارع الجانبيّة حيث دور “السينما” الصغيرة، والمطاعم الشعبيّة التي تعمل على مدار 24 ساعة، ومكتبات الكتب المستعملة، وأكشاك الصحف، والحانات وعُلب الليل التي لا يصل إليها إلا أصحاب المنطقة؟
إنّ أيّ نصّ أدبيّ حول التّجربة الشخصيّة للمكان سيأخذ دون شكّ ما لا يقل عن العامين؛ ما بين اِكتماله، ووصول الكتاب المطبوع ليد القارئ، وسرعان ما سيجد المرء كثيرًا مِن المواقع الّتي سجّلها قد تسربّت من اليدين مُجددًا: واجهة ذلك المَتجر قد تغيرت، وما كان فرنًا للكعك أصبح فرعًا لبنك، ومقر الحزب صار متجرًا لبيع الدّواجن، فكأن المدينة سيّدة تغيّر ثيابها بين كلّ عُطلة نهاية أسبوع وأخرى. ثم هل المدينة أماكن أم أشخاص، تجارب أم أصوات، هدوء أم صخب وضوضاء، روائح أم حكايات، صُحف أم سيارات أجرة، محطات قطار أم كورنيش ميناء، جامعة عتيقة أو حي دبلوماسيّ، إشارات المرور أم مَقاعد الاِنتظار، المُستشفيات أم حدائق الأحياء، المقابر أم الأرصفة وكتابات الجدران؟ وماذا عن الجرائم الشّهيرة، والسّرقات الكبرى، وأماكن المقابر الجماعيّة، والحواجز وخطوط التّماس– إن كنت مثلي مِن مدينة شهدت حروبًا أهليّة؟ وماذا عن الطقس والمطر، الضوء ودرجة الحرارة؟ والأسماء؟ هل نحتاج إلى سجل رسمي لتسميات الأماكن والأجواء بلهجة سكانها أم نطلق عليها أسماء خياليّة من عفو الخاطر؟ ولعل السّؤال الأهم يظل ذائقة الكاتب ذاته. فهل هو يكتب عن مدينته من وحي العيش المباشر واللّحظيّ فيها، أم كتجربة نوستالجيا لاستعادة ماضٍ قبل الغربة القسرية. وهل يكتبها كحبيبة أولى، أم هو يقارنها بأخريات عرفهّن في غربته وترحاله: أن تكتب بيروت بعدما غرقت في حياة باريس أو لندن مثلاً، ليس أبدًا كأن تكتب بيروت وأنت أقصى رحلة خارجها أخذتك نحو صيدا – كيلوميترات قليلة نحو الجنوب – وهل يكتب الرجال عن مدنهم، كما قد ترسمها النساء؟ وهل يرى مهاجر خاسر حزين مدينته كمن تركها سعيدًا هنيئًا بحثًا عن أيّام أفضل؟
فإذن من أين نبدأ؟
لقد مدّنا الأدب الأوروبيّ المُعاصر بِتجربةٍ مُثيرةٍ للاهتمام في البحث عن روح المدينة مِن خلال تأثيراتها النَّفسيّة على الأفراد، وهي لذلك اِستعارت اِسمها “سايكو- جيوغرافي” أو (الجغرافية النفسيّة)، وهو مصطلح مِن مساحة التقاطع الخلّاق بين التّحليل النفسي، وجغرافيا البيئات الحضريّة.
وهل يكتب الرجال عن مدنهم، كما قد ترسمها النساء؟ وهل يرى مهاجر خاسر حزين مدينته كمن تركها سعيداً هنيئاً بحثاً عن أيّام أفضل؟
وتقوم نظريّة “السايكو- جيوغرافي”، بشكلها الفضفاض على اختبار المشاعر، والعواطف الذاتيّة من خلال التجوّل مشيًا عبر الأماكن المختلفة، وفق طُرق مُبتكرة، ومتمردة على السائد وربّما بلا خطّة (drift)، ومِن ثمّ إطلاق العنان للحواس لتسجيل التجربة المميزة لتذوّق عين المكان. وكثيرًا ما تُنتج هذه الجولات إحساسات يُسجّلها البعض وفق أدواتهم الذاتية للتعبير: من مثل كتابة وصفيّة، أو نحتًا روائيًا أو رسومًا “اِسكتشيّة” أو حتّى مُسوحًا مِعماريّة مدعومة بالصور والقياسات، أو أفلامًا وثائقيّة.
وعلى الرّغم من أنّ الاعتراف بمصطلح “سايكو- جيوغرافي”، كان بقلم المُنظر الماركسيّ الفرنسيّ “غاي ديبورد” في العام 1955م، إلا أن هنالك ما يشبه الإجماع على أنّ الفكرة مُستوحاة مِن مَفهوم للشاعر والكاتب الفرنسي “تشارلز بودلير” في القرن التاسع عشر عن “الفلانور” – ما يعادل المتجوّل الحضريّ لأجل التجوّل – وقد أصبح الأمر لاحقًا موضع تجارب للعديد من المعماريين، والفنانيين، والثوريين، والروائيين، في محاولاتهم المتباينة الدّوافع، للقبض على جوانب من روح مُدنهم وأحيائهم، التي لا يمكن العثور عليها في الكتيبات السياحيّة أو السجلات الرسميّة. وغالبًا ما تكون المواد التّسجيليّة الّتي يرجع بها هؤلاء من جولاتهم “السيكو- جيوغرافيّة”، غنيّة فكأنها سِجل تاريخيّ حقيقيّ للمكان في برهة مُحددة من الزّمان.
تأثرت مُمارسة “السايكو- جيوغرافي”، بجذورها المُتمردة والغامضة الّتي بدأت مِن تفاعلات ساحرة بين ثوريين ماركسيين، و”أناركيين” فوضويين، مع فنانين، وشعراء “دادائيين وسورياليين” –حيث شكلوا لاحقًا بعد مؤتمر لهم في إيطاليا عام 7591م، ما صار يُعرف بالأممية التموضعيّة (Situationist International)، التي حلّت رسميًا في 2791م- ولذلك طالما انحازت ممارستها إلى نوع من المرح العابث، وممارسة تحدٍ للسائد، وكسر للحاجز بين الثقافة النّخبويّة والحياة اليومية من خلال فعل الضّياع غير المبرمج والتيه مشيًا في قطاع معيّن من المدينة. وعدو هذه التجربة دائمًا هو السير الهادف الذي يرتبط بجدول أعمال مُسبّق لأن ذلك –وفق “السيكوجيوغرافيين”- يُسقط من الإحساس جوانب هامّة من الطريقة التي نختبر بها كبشر العالم الحضري.
الروائي كفلانور (Flaneur)
خَمُلَ ذِكْرُ “السايكو- جيوغرافي”، بعد غياب الأمّميّة التَّموضعيّة وتفرّق نجومها، لا سيّما بعد هزيمة ثورة الطلاّب في فرنسا (1968) ، واسترداد اليمين زمام المبادرة الثقافيّة هناك. على أن الإمكانات المُغريّة لأسلوب الغوص في قلب المناطق الحضريّة، وقراءة المدينة، في مستوى لا تلتقطه التجارب المَشهديّة الطابع، الّتي يقوم عليها نموذج الاستهلاك السياحيّ للمكان، منح “السايكو-جيوغرافي”، حياة جديدة بداية من عقد التسعينيات، وتقاطر كُتَّاب، وفنانون، وصانعوا أفلام، بل ومحرضون ثوريون، لاِستعادة الفكرة مجددًا أساسًا كأداة لاختبار روح الأمكنة.
ولعّل أبرز التّجارب على الإطلاق في إطار هذه الاستعادة “للسايكو- جيوغرافي”، أتت من الأديب والروائي البريطانيّ إيان سنكلير (مواليد 1943)، الّذي دبّج مجموعة هامة من الأعمال المُستقاة من جولات “سايكو-جيوغرافيّة” في أجزاء مُختلفة من مدينة لندن أصبحت تعدّ مداخل لا بدّ منها لاستيعاب روح هذه المدينة العريقة، والثريّة الثقافة، ما وراء نسق الترويج التجاري المُعتاد الذي يستهلكه ملايين السياح الأجانب دون لمس روح المدينة الحقيقية. ويبدو النصّ لدى الكاتب “لويس سنكلير”، متينًا ليس بفضل قوّة موهبة النثر حصرًا، وإنما لاستمداده مادة نثره من تجربة تعايش حقيقي مع المكان، فتتحوّل الصّور الحضريّة في يديه إلى لوحات شعريّة أكثر سحرًا مِن الخيال. إنَّها وفق النّاقد “مايكل هوفمان” أشبه بإعادة بناء كليّة للحيّز الحضريّ مِن خلال اللُّغة.
عند “سنكلير”، فإنَّ مَسيرتهُ “سايكو-جيوغرافيّاً”، أقرب لِمُمَارسةٍ طُقوسيّةٍ تطهريّةٍ مِن وعثاء الحداثة، ووسيلة للتصدي للمنظومةِ الميكانيكيّة، الّتي تَضغطُ على اِستمراريّة الإحساس الفردي بـ “الزّمكان”، وفعل تمرّد ضد العالم المُعاصر، وطريقة إنتاجه للفضاء العام. ومن الجليّ أنّ كتاباته استدعت اهتمام كُتَّاب، وروائيين، ومدونين آخرين من أرجاء العالم “الإنجلو- ساكسوني”، وأضاف هؤلاء من تجاربهم “السايكو-جيوغرافيّة” في نيويورك، ولوس أنجليس، ونيو أورليانز، ومومباي، وسيدني، وغيرها أبعادًا مُثيرة للاهتمام لعمليّة صياغة النّصّ الرّوائيّ عن المُدن، والبعد الذاتي للعلاقة بالأماكن. ولا تقتصر تلك التّجارب على خوض غمار المدينة بحثًا عن جوانبها السريّة المُستغلقة على المنشغلين فحسب، بل وأصبحت بمثابة وصفة لاستعادة (سحر) أماكن وأجزاء من البيئة الحضريّة يتمّ تجاهلها أو لا تخضع في العادة للاهتمام، ومختبر لقراءة العلاقات العاطفيّة اللاعقلانيّة والأسطوريّة التي تربط بين مواقع أو مبانٍ مهجورة وسكان المدينة. كما أنّ ممارسة “السايكو-جيوغرافي” قد تكون مؤثرة بشكل خاص في مواضع شهدت خبرات جرائم أو مُعاناة بشريّة قد لا تعني السياح أو نسيها السكان المحليون مع تعاقب السنين، فكأنها حينئذ تأريخ جديد، وكسر لطغيان خلل الذاكرة الجمعيّة الانتقائيّة لا سيّما في مُدن واجهت صدمات كبرى كبرلين مثلاً، وأداة نقديّة لاستجواب شقوق التاريخ.
إنّ العمل الرّوائيّ الّذي يتخذ من مدينة ما موضوعًا له لا شكّ سيكتسب عمقًا، وثراءً، وقدرةً، على الكشف إنْ هو اِستند إلى مادة “سايكو-جيوغرافية”، فجعل غير المرئي مُتجسّدًا في نصّ مُستوحى مِن تجربة تمرد واِنجراف ولقاءات صدفة مع واقع الأشياء فِي منطقة التقاطع بين الأمكنة والأزمنة لهو فعل سياسيّ عالي النبرة، وخطاب مستلّ من تجارب عيش بشري تمنح الرّواية سلطة أدبيّة عُليا.
ومع سيطرة النّموذج “النيو- ليبرالي” على معمار مدننا المعاصرة، وغلبة غابات الخرسانة، والصلب، والزجاج على الأُفق الحضريّ لمعظمها، وتسارع اِندثار الأجزاء ذات الطّابع الحميميّ، والثّقافيّ فيها لِمصلحةِ الحيّزات المُعقمة والباردة، فإنّ الكتابة الرّوائيّة عَن المكان، وعلاقتنا فيه كأفراد بالاستفادةِ مِن مَنهج “السيكو- جيوغرافي” تبدو لذلك مَسألة أكثر إلحاحًا مِن أيّ وقتٍ مضى، أقلّه كذاكرة شعبيّة لحفظ تاريخ يُراد له ألا يكون تاريخًا. إنّ مُدننا تتحرك مِن تحت أقدامنا، وتتقلَّب هُوياتها قبل أن نمتلك ترف الوقت لاستيعابها، ولذا فإنني أزعم بأنّ الرّوائيّ (الفلانور) سيكون “شامان” قبائلنا في هذا العصر.
ندى حطيط
إعلاميّة، وكاتبة، وصانعة أفلام وثائقية، لبنانيّة- بريطانية الجنسيّة. حائزة على دبلوم دراسات عليا في الإخراج المسرحيّ (كلية الفنون- لبنان) وإجازة في الصّحافة (كلية الإعلام- لبنان)، وماجستير بدرجة شرف في صناعة الأفلام الوثائقيّة (جامعة كينغستون – لندن). لها ديوان شعر منشور 2019 (لا مدينة تلبسني)، وكتاب مطبوع 2012 (بماذا يفكر العالم). وكتاب جماعي صدر حديثًا 2022 (الرّسائل اللُّبنانيّة: قرنٌ مِن القلق بين الانتداب والتّحرير(.