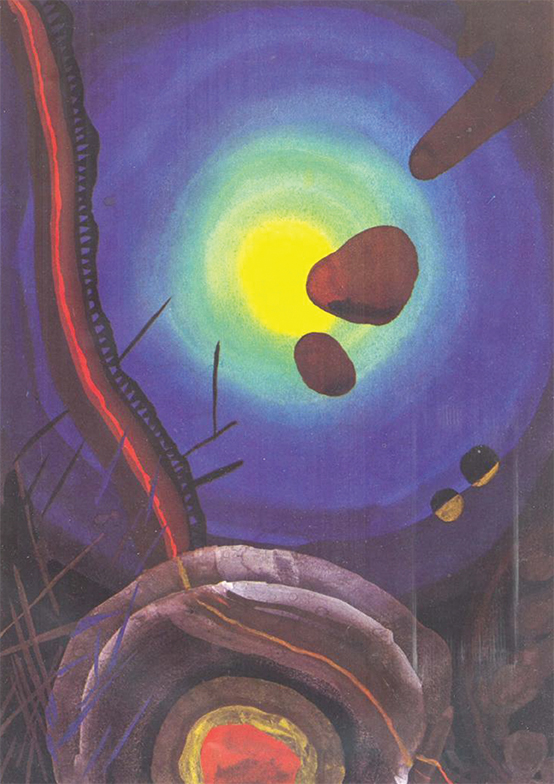عَلى الرّغم من أنّ كانط -عَلى حدّ علمنا- لم يستعمل مُصطلح “الإسلام” (Islam) إلا مرة واحدة، في نصٍّ ينتمي إلى الفترة ما قبل النّقديّة مِن مسيرته، وهو “ملحوظات حول مشاعر الجميل والجليل”1، فإنّ إشاراته، وتعليقاته الفلسفية على العرب، وعلى أخلاقهم، وعلى ديانتهم، وعلى نبيّهم، مبثوثة في نصوص عديدة، من قبيل “محاولة في أمراض الرأس”2، و”نقد العقل العملي”3، وكتاب “الدين في حدود مجرّد العقل”4، ومقالة عن نبرة فائقة أخذت حديثًا في الفلسفة5، وميتافيزيقا الأخلاق “نظرية الفضيلة”6، ونزاع الكلّيات7، والأنثربولوجيا من وجهة نظر براغماتية8، ودروس في الميتافيزيقا9، ودروس في الإتيقا10، وعدد من المواضيع الأخرى.
تحميل المقال
ومن ثمّ، فإنّ الأمر لن يتعلّق هنا بعرض خصومي لموقف “نقدي”، أو “كولونيالي”، أو متعصّب (غربي، أوروبيّ، حديث…) من دار الإسلام، كما نحت بعض الدَّراسات الاستشراقية المعكوسة إلى ذلك11، حيث يُحرّكها هذا النوع من التساؤل: “كيف يمكن لتاريخ الفكر الألماني أن يبدو، بالنسبة إلى مُلاحظ مُسلم، وعلى نحو أكثر تخصيصًا، بالنسبة إلى ملاحظ ليس يهمّه سوى كيف أثّرت ثقافته وعقيدته في التقليد الفلسفي الألماني، وكيف تمّ تصويرها داخله، وكيف تفاعلت معه”12. ومِن ثمّ، يكون الهدف مقابلة النزعة “المركزية الأوروبية” (eurocentric) المفترضة في نصوص كانط، بنوع من النزعة “المركزية الإسلامية” (islamocentric)13، في نحوٍ من الثأر النقدي المُشرِّف. كذلك لن يتعلّق الأمر بأيّ طمع في أسلمة كانط نفسه1441، ولا بالزجّ به في مقارنة لصيقة مع من تمّ تحويله إلى بطل تنويري في سردية أنفسنا المعاصرة؛ أي مع ابن رشد، والاتكاء على آرائه لنقد أنفسنا15. كذلك ينبغي ألا نحوّل علاقتنا بكانط إلى استلطاف (هووي)، أو إشباع حنيني مَفاده أنّ كانط الشاب قد كتب يومًا على شهادة الدكتوراه، بأحرف عربية، وبخطّ اليد، عبارة البسملة كاملة16، وكأنّه شعر أنّه ينتمي إلينا بوجهٍ ما، أو أنّ عليه دَينًا ميتافيزيقيًا تجاهنا لم يجد له من تعبير لائق سوى إثبات ذلك التوقيع ما بعد الأوروبيّ، على أغلى ما عنده يومئذ من الاعتراف الرُّوحيّ بنفسه. وهي وثيقة عُثر عليها في بعض أوراق فيلسوف كونكسبورغ، ودار حولها بعض جدل بين الألمان أنفسهم، إلى حدّ التساؤل المُتحيّر على موقع يحمل اسم (DYBTH)17: “هل ينتمي الإسلام إلى ألمانيا، سيّدي كانط؟”18، ردًّا على ما بادر بكتابته أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة مونستر، ماركو شولير Marco Schöller، في مقالة تحمل عنوانًا لاذعًا هو “القهوة جزءٌ من ألمانيا”، نشره فيFinancial Times، قائلًا: “… إنّ قليلًا من نزع الإيديولوجيا في السجالات حول الإسلام لا يمكن أن يضرّنا. إنّ الفيلسوف الألمانيّ إيمانويل كانط قد وضع على شهادة الدكتوراه التي حصل عليها سنة 1755م، بالأحرف العربيّة عبارة البسملة التي هي فاتحة السُّور القرآنية: بِسم الله الرَّحمن الرَّحيم…”19.
لا أحد يمكنه أن يقف على السياق الذي أتى فيه كانط إلى هذا النوع من الإشهاد، أو التوقيع “المسلم” على وثيقة دكتوراه شبابه، إلا أنّ مبدأ حسن الظنّ الذي يتحدّث عنه فلاسفة تحليل اللّغة قد يكون عونًا فلسفيًّا على تفهّم ذلك الصنيع. لقد خلق عندنا أفق انتظار لمعنى ما، علينا أن نعمل على استكشافه.
من أجل ذلك وبدلًا من ذلك سوف نصرف همّنا نحو البحث في دلالات الإشارات التي تكرّرت تحت قلم كانط، الفيلسوف الكسموبوليطيقي، إلى الجهة الروحية التي نقف فيها نحن العرب أو المسلمين الذين يعيشون في فترة “ما بعد الملة”، أو “ما بعد دولة الملة” التي كان ابن خلدون قد أرّخ جيّدًا لنهايتها التاريخية بسقوط دولة الخلافة، وانكسار شوكتها.
“أمّا دين مُحمّد فهو يتميّز بالكبرياء؛ إذ بدلًا مِن المُعجزات، قد وجد التأييد الخاص بإيمانه في الانتصارات،وفي قهر الشعوب الأخرى، وطقوس عبادته كلّها من نوع شجاع”.
نحن إذًا مدعوون هنا إلى لقاء ما بعد تاريخي، وبمعنى ما “ما بعد إسلامي”، كما نتحدّث اليوم عن “ما بعد حداثي”، مع أنفسنا القديمة، من خلال مرآة كانط، لكنّ ذواتنا الجديدة هي التي ستمثّل هذا الدور ما بعد التّاريخي، باعتباره مهمّة استطلاع ميتافيزيقي طريفة من شأنها أن تُساعدنا على بلورة وسائط “حديثة” في مُخاطبة أنفسنا القديمة، ومن ثمّ العمل على تحرير الإمكانات التي ما زالت تدعونا إلى الانتماء إلى مصادر أنفسنا دونما خجل “حداثي” بها، أو منها.
علينا أن نُقرّ بأنّ نوعًا من الخجل الأنطولوجي ظلّ يمنع أجيالنا من النّهل من مصادر أنفسنا نهلًا موجبًا وصحّيًّا، كما تفعل كلّ الشعوب “الحديثة” الأخرى، وليس يرفع مثل هذا الخجل الأساسي سوى مجموعة من تمارين اللقاء مع أنفسنا القديمة، من خلال مرايا العصر الذي نعيش فيه؛ وحدها معاصرة جيّدة بإمكانها أن تساعد على إعادة التأريخ لأنفسنا على نحو “جديد”؛ أي على نحو “مغاير”، بالمعنى الحرفي للفظ؛ أي من خلال تحدّي الغير لنا، أو من خلال تحدّي الغيرية، أو المغايرة التي يفرضها علينا رأي الأغيار، أو الآخرين فينا، ولا سيّما رأيهم في ذاكرتنا العميقة، وفي نفوسنا القديمة بالذات.
أوّلًا: ما دامت هذه الذاكرة العميقة، أو النفوس القديمة، هي التي ما زلنا نستقي منها مصادر أنفسنا الجديدة، سواء أكان ذلك صراحةً أم رغمًا عنا.
ثانيًا: بما أنّ هؤلاء الأغيار قد صاروا، بفعل الأزمنة الحديثة، شكل “النحن” الحديثة لأنفسنا، وبعد فرض واقعة “الحداثة” (الميتافيزيقية، والسياسية، والتكنولوجية) فرضًا عالميًّا في شكل “تعمير” باطني وشامل لأشكال وجودنا المعاصر، هم صاروا يقومون منّا مقام أنفسنا.
سوف نوزّع مفاصل هذا البحث إلى فقرتين:
1- كانط والعرب.
2- كانط والإسلام.
ثم بعد ذلك خاتمة.
1- كانط والعرب أو (في شعوب الجليل)
ضمن “دُروس في المِيتافيزيقا” التي كان كانط ألقاها ما بين 1775 و1780م، يحصي العرب مِن بين الشُّعوب التي “أخذت” الفلسفة عن اليونانيين، إلى جانب الفرس20، لكنّ دورهم يتعدّى هذا العمل الكسول؛ إذ إنّ كانط قد رصد، في إنتاجهم الفلسفيّ، مهمّة إعادة إحياء الفلسفة بعد خمودها. قال: “وفي نهاية الأمر خمدت جذوة الثّقافة عند الرُّومان، وظهرت البربرية، وذلك حتى جاء العرب الذين غمروا أجزاء من الإمبراطورية الرومانية، ونذروا في القرن السّابع أنفسَهم للعلوم، وأولوا أرسطو مكانة مرموقة. وحين أفاقت العلوم في الغرب من كبوتها، تمَّ اتّباع أرسطو كالعبيد”21.
علينا أن نذكّر هنا بأنّ هذا الكلام ألقاه كانط في درس عموميّ للطلبة الألمان، في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، ومن ثمّ هو تنزيل رسمي لموقع العرب في تاريخ الثقافة، كما وصلت إلى الأوروبيين. العرب هم الذين أنقذوا الثقافة الإنسانية من البربرية، بعد انحسار الرومان؛ وذلك عندما نذروا أنفسهم للعلوم، وهو ما فعلته أوروبا لاحقًا، بعد فترة “اتّباع عبودي” لأرسطو معرّب، بطل الفلسفة ذاك الذي أعاده العرب إلى الخدمة بعد خمود طويل. العرب كونيّون هنا بعقولهم، وليس بطقوسهم.
لكنّ ما كتبه كانط عن العرب في مقالة مبكّرة مثل مقالته “حول مشاعر الجميل والجليل (1764م)”، هو الذي يكشف لنا عن تعاطفه الكبير مع شخصيّة “العربيّ”، وتمهّله عند ملامحها الطريفة، في نطاق إحصاء أخلاقي وروحي شامل للطباع القومية للشّعوب الأساسية للإنسانية الحديثة.
قال: “إذا ما اجتزنا الآن بنظرة خاطفة، تلك الأجزاء الأخرى من العالم، إذًا لالتقينا بالعربي، الإنسان الأكثر نبلًا في الشرق، ولكن المشوب بشعور كثيرًا ما ينقلب إلى مغامرة خطرة22. إنّه مضياف، ذو سماحة، وصادق؛ إلا أنّ حكاياته وقصصه، وأحاسيسه عامة، مخلوطة في كلّ آن بشيء من الأعاجيب. إنّ خياله المحموم إنّما يقدّم له الأشياء في صور23غير طبيعية وملتوية، حتى انتشار ديانته إنّما كان مغامرة كبيرة. وإذا كان العرب بمنزلة إسبان الشرق، فإنّ الفرس هم فرنجة آسيا. إنّهم شعراء جيّدون، مهذّبون، وأصحاب ذوق على قدر محمود من الرقة والأناقة24. إنّهم ليسوا بأتباع متشدّدين للإسلام25، وإنّهم ليسمحون لمزاجهم المشدود إلى المزاح بأنْ يتأوّل القرآن بقدر محمود من الترفّق والتلطّف26,27“.
كان هذا الكلام سنة (1764م)، وقد ساقه كانط في الفصل الرابع من المقالة المشار إليها، وهو يحمل عنوانًا لافتًا: “في الطباع القومية، من جهة ما ترتكز على الشعور المختلف بالجليل والجميل”28. وما دام كانط قد شبّه العرب بالإسبان، فإنّ ما قاله عن الإسبان يمكن أن يمدّنا بمفاتيح تأويلية من شأنها أن تساعدنا على تنزيل رأي كانط في العرب، وتقدير مدى أصالة هذا الرأي. وفي هذا الفصل المذكور يفرّق كانط بين شعوب الجميل، وشعوب الجليل، على هذا النحو:
الإيطاليون والفرنسيون هم شعوب الجميل؛ في حين أنّ الألمان، والإنجليز، والإسبان، هم شعوب الجليل29. ومن الواضح، تبعًا لما تقدّم، أنّ العرب يُصنّفون ضمن شعوب الجليل، وهو تخريج يبدو لنا براءً من أيّ تخرّص “استشراقي” بالمعنى الذي بثّه إدوارد سعيد عن المفكّرين الأوروبيين، وطبّقه بعض الباحثين على تأويل كانط لماهية الإسلام بوصفه من نتاج “شعب” وجد أفقه الروحي في معنى “الجليل”30. ومن ثمّ فإنّه علينا أن نفهم ما معنى “الجليل” في نصّ 1764م هذا؟
قال: “الجميل ذاته إمّا فاتن ومؤثّر، وإمّا مضحك وظريف”31، وهذا -حسب كانط- دأب الإيطاليين والفرنسيين. أمّا عن الجليل فيقول: “في الطبع القومي، الّذي يمتلك تعبيرًا عن الجليل، يكون هذا الأخير إمّا مِن نَمط الهائل الذي يميل شيئًا من الميل إلى المُغامر الجسور، وإما هو شعور بالنبل، أو ربما هو رائع. وأعتقد أنّ لي أسبابًا تُمكّنني مِن أن أمنح الإسبان النمط الأوّل من الشعور، أمّا الثاني فللإنجليز، وأمّا الثالث فللألمان”32.
من كلّ ما تقدّم نحن نسجّل الآتي: إنّ رأي كانط في العرب لا يحتوي على أيّ نوع من الضغينة “الكولونالية”، أو اللاهوتية؛ بل هو رأي فلسفي ساقه كانط بالطرافة نفسها التي أصدر بها أحكامه على الطباع القومية التي تتحكّم في حواس الشعوب الكبيرة التي تؤلّف الإنسانية الحالية.
قال كانط: “ليس غرضي أبدًا أن أصوّر طباع الشعوب بشكل مفصّل؛ بل أنا أرسم فحسب بعض الملامح التي تعبّر عندها عن الشعور بالجليل والجميل… ولهذا السبب فإنّ اللوم الذي يمكن أن يقع، في بعض الأحيان، على شعب ما لا يهاجم أحدًا، طالما أنّه من طبيعته، حيث إنّه يمكن لكلّ شعب أن يوجّهه كما رصاصة إلى الشعب المجاور له…”33.
إنّ المحمّديين إنّما يعرفون (كما يبيّن ريلاند) كيف يمنحون وصفَ فردوسهم، المرسوم بكلّ شهوة حسيّة، معنًى روحيًّا جدًّا حقًّا، وذلك ما فعله الهنود مع تفسير الفيداس، على الأقلّ، بالنسبة إلى القسم المتنوّر من شعبهم.
ومن المفيد جدًّا أن نذكّر هنا بأنّ ثنائية “الجميل والجليل” التي اعتمدها كانط في هذه المقالة، ثمّ لاحقًا في كتابه النقدي الثالث (نقد ملكة الحكم)، ليست غريبة عن المصطلح العربيّ- الإسلاميّ الكلاسيكيّ؛ فكان ابن عربي قد وقف عند الصفات الجمالية، والصفات الجلالية للإله الإسلامي في لغة القرآن. ومن العجيب أنّ هذه الفكرة تعود إلى الانبجاس في قلب القرن الثامن عشر، دون أن نستطيع التأريخ لهذا المبحث بدقة. إنّ العرب شعب ينتظم طبعه القومي وفقًا للشعور بالجليل، باعتباره شعورًا بالخشية التي تميل إلى ركوب الخطر. الشعور بالجليل هو شعور سابق إلى القلب بالهائل، وبخشية عميقة تُصاحب شعور العرب بأنفسهم؛ هوية تُقدّ من صحبة الخطر، ومن تحوّيل الكينونة إلى مُغامرة شاملة. علينا أن نكتفي هنا بتمييز استراتيجي: يجب عدم الخلط بين عاطفة الجليل التي شخّصها كانط، وبين التهمة الاستعمارية التي سيقترفها القرن التاسع عشر ضدّ العرب كونهم متعصّبين، وغير قادرين على التجريد العقلي… إلخ. الشعور بالجليل طبع قومي يشترك فيه العرب مع الإسبان، والإنجليز، والألمان، وليس عاطفة “شرقية” عدمية. ومن الطّريف أن نورد هنا لقطة أخرى من حوار كانط مع شخصية العرب، حيث يذكرهم أيضًا في معرض حديثه عن “المرأة المليحة” في ذهنية الأوروبيّ، ولا سيّما الّتي شَكل جمالها يكمن في “الوسامة”، أو “الشكل الحسن” (die hübsche Gestalt)، وهو ما يتجسّد -حسب كانط- في البنات الشركسيات، والجورجيات، وحيث يعلّق كانط قائلًا: “لا بُدّ من أنّ الأتراك، والعرب، والفرس، متفقون جدًّا مع هذا الذوق، من أجل أنّهم راغبون جدًّا في تحسين، أو تجميل (verschönern) شعبهم بمثل هذا الدم الرفيع”34. وهذا يعني أنّ كانط يعتقد فعلًا بأنّ العرب جزء من الذوق الإنساني؛ بل هو متّفق في صميمه مع الذوق الأوروبيّ، وذلك في مسألة جمالية حسّاسة مثل نوع المرأة التي يمكن أن تُحرّك الرجل عامةً؛ لحسنها ووسامتها.
2- كانط والإسلام
أ– جنّة مُحمّد: تأويلان مختلفان (1788 و1793م)
ما بين 1788م، تاريخ نشر كتاب (نقد العقل العملي)، وسنة 1793م، تاريخ نشر كتاب (الدين في حدود مجرد العقل)، تعرّض كانط إلى التمثّل بما هو “محمّدي” -كما يقول- بطريقتين تبدوان متعاكستين، وعلينا أن نفحص عن الدلالة الفلسفية لذلك. ففي المرة الأولى نعثر على قولة ساقها كانط، في موضع متقدّم من كتابه النقدي الأساسي الثاني، وتحديدًا في الفصل الثاني (حول جدلية العقل المحض في تعيين مفهوم الخير الأسمى) من الكتاب الثاني (جدلية العقل المحض العملي). فبعد نقد العقل النظري، تبيّن لكانط أنّ مصلحة العقل، في الميدان العملي، من نوع مختلف عنها في ميدان العلوم. لم يعد الأمر يتعلق بأن نعرف؛ بل أن نريد. وفي تقديره فإن تعيين الإرادة أصعب من تحصيل المعرفة. تعيين الإرادة يعني أن نحدّد لأنفسنا غاية أخيرة على الأرض، وهذا ما لا يمكن لأيّ علم أن يقوم به. وحين يتوقّف العقل النظري عن توجيه النفس ينفتح أمامها كلّ حقل المُفَكَّر فيه الذي لا يمكن أن نعرفه. عندئذ يشعر العقل بأنّ لديه مصلحة غير نظرية تتعلّق بميدان واسع من إمكانات الاستعمال، إلا أنّها ميدان، حيث لا يمكن لأيّ عقل نظري أن يساعدنا. ومن يصدّق أنّ العقل الذي في العلوم يمكن أن يعيّن إرادتنا حول مصيرنا في الكون، يتعلّق “باختلاقات عقلية فارغة” تكمن مصلحة العقل العملي في التخلّص منها. وليس ثمّة من طريقة لذلك غير أنْ ينقد العقل العملي نفسه، وأن يشرّع لنفسه بطريقة غير نظرية تمامًا. وأهمّ موقف لنقد العقل لنفسه ألا يقبل من نفسه شيئًا يؤدّي إلى تقويض العقل النظري؛ لأنّ كلّ عقل عملي، أو أخلاقي، يفعل ذلك: “يقوّض مصلحة العقل التأمّلي، ويرفع الحدود التي وضعها هو بنفسه لنفسه، ويسلّمها إلى هراء، أو جنون المخيلة”35.
إذًا فكلّ تفكير أخلاقي يتناقض مع التزامات العقل النظري في أنّه لا يمكن أن ينتج معرفة عقليّة عمّا يكون خارج التجربة الممكنة المتاحة للعقل البشري، بما هو كذلك -نعني مسائل النفس والعالم والإله- إنه تفكير سيّئ السيرة، ويؤدّي إلى رفع الحدود التي أقامها العقل النظري بين ما يمكن أن نعرفه بعقولنا البشرية، وما لا يمكن أن نعرفه بهذه العقول. وكلّ ما قد نطمع في معرفته بعقولنا، وهو يوجد خارج نطاق الطبيعة الإنسانية، هو “هراء، أو جنون المخيلة”.
أن العرب بمنزلة إسبان الشرق، فإنّ الفرس هم فرنجة آسيا. إنّهم شعراء جيّدون، مهذّبون، وأصحاب ذوق على قدر محمود من الرقة والأناقة.
وفي هذا السياق تمثّل كانط المعنى الحسي والخيالي للجنة في الإسلام، وفكرة “الذوبان في الألوهية” الذي يقول به الإشراقيون والمتصوّفة. قال: “في الواقع، بقدر ما يوضَع العقل العملي في أساس هذا الأمر، وذلك من حيث هو مشروط بشكل باثولوجي، نعني: يتحكّم فحسب في مصلحة الأهواء تحت المبدأ الحسّي للسعادة، فإنّ هذا التكليف الثقيل لا يمكن أن يُطلب من العقل التأمّلي. إنّ جنّة محمّد، أو الذوبان في الألوهية، لدى الحكماء الإلهيين والمتصوّفة، وكلّ طرف، كما هفت نفسه، ووقع في خاطره، هي أمور تفرض على العقل أهوالها، وقد يكون من الأحسن ألّا يكون لنا عقل من أن نلقي به، بهذه الطريقة، إلى كلّ هذه الأخيلة والأحلام. ولكن إذا كان العقل المحض يستطيع، من تلقاء نفسه، أن يكون عمليًّا -وهو في حقيقة الأمر كذلك كما يثبته الوعي بالقانون الأخلاقي- فذلك لأنّه دائمًا عقل واحد يحكم وفقًا لمبادئ قبلية … عليه أن يقنع؛ لأنّ ذلك ليس ببصيرة من بصائره؛ بل هو بالفعل من جهة توسّعاتٍ ما لاستعماله بأيّ قصد آخر، وهنا بقصد عملي؛ ولا يتنافى ذلك على الإطلاق مع مصلحته التي قوامها الحدّ من جريرة ما هو تأمّلي”36.
كيف نقرأ هذا النصّ؟ وهل علينا أن نواصل الاعتذار لأنفسنا من كانط، أو عذر كانط الذي لا يعرفنا حقيقة؟
ما قصد إليه كانط هنا ليس نقد الإسلام، ولا التخرّص على شخصية محمد الرسول؛ بل البحث الترنسندنتالي في شروط إمكان استعمال عقولنا في الميدان العملي فحسب. أي: ميدان تعيين الإرادة وفقًا لقوانين الحرية الإنسانية، وبالتحديد عن مسائل تقع أصلًا خارج التجربة الممكنة للحواس البشرية. الإرادة هي لحظة تكون فيها النفس تحت تأثير انفعالات لا مردّ لها؛ لأنّها نابعة من طبيعتها، وهو ما أشار إليه كانط بعبارة “مشروط بشكل باثولوجي”، و(“باثوس” في اليونانية تعني الانفعال).
وحده العقل النظري يفعل بشكل عفويّ ومحض. ما عدا ذلك نحن ندخل في قارة الانفعال البشري، ومن ثم العقل الأقرب إلى طبيعتنا البشرية، كما هي في انفعالاتها الحميمة، هو العقل العملي، وليس العقل الذي في العلوم. العلوم مصطنعة، لكنّ الانفعالات أصلية. ولو كلّفنا النفس إدارةَ شؤون الانفعال لوجدنا أنفسنا أمام وضعية الباحث عن السعادة بحواسّه، أو بخياله، وليس بأيّ شيء آخر؛ لذلك تختار النفس أفضل ملكاتها لتدبير الانفعال من دون تدميره، ولا الخضوع لسلطته. وكلّ عقل يكتفي بتحقيق أهوائنا، تحت سلطة المبدأ الحسي للسعادة، هو عقل باثولوجي؛ ولذلك سوف نثقل كاهل العقل، لو طالبناه بأن يعمل تحت إمرة ملك لا يفكّر.
إنّ الفيلسوف الألمانيّ إيمانويل كانط قد وضع على شهادة الدكتوراه التي حصل عليها سنة 1755م، بالأحرف العربيّة عبارة البسملة التي هي فاتحة السُّور القرآنية: بِسم الله الرَّحمن الرَّحيم…
في ضوء هذا التوصيف الفلسفي، يبدو حديث الدين عن الجنة والنار حديثًا يخرج عن نطاق العقل؛ لكنّه يوجد في دائرة الانفعال؛ أي حيث يمكننا مواصلة السعادة بوساطة الحواس، أو المخيلة. والمشكل العميق الذي يثيره كانط أنّ العقل وحده يمكن أن يشرّع لنا معنى للمصير لا يؤدّي إلى تقويض الحدود التي وضعها العقل النظري لنفسه في ميدان المعرفة. والمفارقة أنّ الأخلاق؛ أي ميدان الحرية الإنسانية، هي ميدان غير نظري، ولا يمكن أن نمتثل فيه للعقل النظري كما يعمل في العلوم. ومع ذلك فإنّ ما علينا احترامه من قوانين لحريّتنا لا يجب أبدًا أن يقوم على اختلاقات عقلية فارغة، أو متناقضة مع طبيعة العقل البشري. لا يفعل العقل، في استعماله العملي، غير توسيع إمكانية التفكير في حريتنا؛ فهو لا ينتج أيّ معرفة حقيقية حول أنفسنا. والرهان هو: كيف نصل إلى حرية التفكّر؟ ما تعدنا به الأديان؛ أي جنّة الخلد، هو مصلحة روحية تقع فوق كلّ مصالح العقل العملي، ونعني: فيما أبعد من كلّ استعمالات الإرادة في حدود طبيعتنا البشرية. ربما كان خطأ كانط هنا أنّه ما زال يأخذ “الجنة” بمعنى أنطولوجي؛ أي بمعنى نمط من الكينونة نحن سوف نعيشه يومًا بعد موتنا؛ لذلك لو أنّ كانط كان معاصرنا، بعد المنعرج اللُّغويّ، لأخذ معنى الجنة مأخذًا سرديًّا، أو بوصفه يحيلنا على عمل لُغويّ، هو العمل الإنجازي؛ الجنة، بما توحيه في قلوب الناس من وعود أخروية بالسعادة، وليس بما يعتقده المؤمن العامي. لكنّ لكانط طريقته الخاصة في “تدارك” ذلك التأويل الذي قدّمه سنة 1788م، وهذا ما فعله، بشكل صريح، في القطعة الثالثة (في انتصار مبدأ الخير على مبدأ الشر، وتأسيس ملكوت الله على الأرض)، من كتاب (الدين في حدود مجرّد العقل) (1793م). قال: “إنّ المحمّديين37 إنّما يعرفون (كما يبيّن ريلاند38) كيف يمنحون وصفَ فردوسهم، المرسوم بكلّ شهوة حسيّة، معنًى روحيًّا جدًّا حقًّا، وذلك ما فعله الهنود مع تفسير الفيداس39، على الأقلّ، بالنسبة إلى القسم المتنوّر من شعبهم”40. تقريبًا المثال نفسه الذي أورده سنة 1788م، ولكن من أجل إصدار تعليل فلسفي أكثر تفهّمًا، وأكثر تلطّفًا. وما كان من “هراء وجنون المخيلة”41 صار الآن، سنة 1793م، “معنى روحيًّا جدًّا حقًّا” (!). كيف نفهم هذا التغيّر في فهم كانط للإسلام؟
كان رهان كتاب (نقد العقل العملي) قابلًا للصياغة على هذا النحو: إلى أيّ مدى يمكن لعقولنا أن ترتّب قوانين الحرية، دون تقويض حدود العقل النظري؟ أي إقامة ميتافيزيقا للحرية، ولكن من دون ادّعاء إنتاج معرفة حول أيّ خطوة خارج العالم المحسوس؛ ولذلك كان حكم كانط يبدو قاسيًا على أيّ نوع من الطمع في إقامة سعادة حسّية خارج حدود العقل البشري. ورأي كانط، سنة 1788م، كان: إنّ جنّة محمّد لا تفكّر.
أمّا رهان كتاب (الدين في حدود مجرّد العقل)، فهو قابل للصياغة على هذا النحو: إلى أيّ مدى يمكن لأخلاقنا العقلية أن تطوّر تقنيات رجاء مناسبة لطبيعتنا البشرية (المحدودة بالعالم المحسوس)، شأنها أن تؤمّن لنا علاقة روحية بالإله، أو بمنطقة الإيمان التاريخي، ولكن دون السقوط في أيّ حماسة دعويّة، أو لاهوت محارب؟ ورأي كانط، سنة 1793م، هو أنّ المحمّديين قد تأوّلوا فردوسهم الحسّي بشكل روحي حقًّا. الجديد لدى كانط أنّ الدين قد انتقل، عنده، من حارس لسعادة الحواس بوساطة الآخرة (1788م) إلى مصاحب مناسب لتقنيات الرجاء بوساطة إيمان يفكّر(1793م). وفي واقع الأمر، من الناحية الفلسفية، انتقل كانط من بحث ترنسندنتالي في شروط الإمكان القبلية للإيمان العقلي، فلا يحتاج إلى أيّ سعادة كي يكون فاضلًا، إلى نقاش تأويليّ حول المعنى الروحي حقًّا الذي يمكن أن نعترف به للإيمان التاريخي الذي يعتنقه شعب ما لنفسه، ويحوّله إلى مؤسسة تقديس. هذا الانتقال الخطير (سنة 1793م) من الفلسفة إلى التأويل هو الذي منح كانط مرونة نظرية طريفة غيّرت موقفه من فردوس المحمّديين. ولذلك سؤال كانط (سنة 1793م) هو: من المؤوّل الأسمى للإيمان التاريخي؟ وجوابه هو: إنّه الإيمان الديني المحض. كلّ الإشكال في معنى “المحض” هنا، فالمحض هو الكوني. وحسب كانط أهمّ “علامة” على حقيقة أيّ دين هي “ادّعاء مشروع الكونية”42 الذي يصاحبه؛ ولذلك هو لا يعتبر أنّ الوحي “المتداول بين الناس هو نفسه الوحي كما شاءه الله نفسه؛ بل هو وحي تاريخي، ونعني: في صيغة كتابية، أو لفظية، أو سردية، أو مؤسساتية، ونعني: في صيغة بشرية. وهو تاريخي؛ بسبب الحاجة الطبيعية للبشر إلى التشوّق إلى أن يكون، دومًا، للمفاهيم والعلل العقلية العليا، حاملٌ حسّيٌّ ما تستند إليه”43. لا يمكن لأيّ دين أن يستغني عن الحواس، وتاريخ أنفسنا هو دومًا تاريخ استعمالنا لحواسّنا، وليس الفردوس، أو الجنّة، غير أقصى سياسة لحواسّنا في المستقبل، ولا معنى لأيّ آخرة من دون حواسّ.
إنّ الضروب المختلفة من الإيمان لدى الشعوب، إنّما تمنحها أيضًا، شيئًا فشيئًا، طابعًا مميّزًا على الصعيد الخارجي في العلاقة المدنيّة.
اكتملَ النِّصَاب الآن: وحي يُخاطب الحواس، لكنّ الخطر فيه أنّه ينبغي أن يتكلّم لُغة كونيّة حتّى لا يُدمّر شكل الحياة؛ أي شرط التَّعايش بين البشر. كونيّة؛ أي عقلية. ليس تأويل الدّين -حسب كانط- سوى تفسيره على نحوٍ يتوافق مع القواعد الكلية للدين العقلي المَحض. ومعنى الدين العقلي: “أن يُسهم في أداء جميع واجبات الإنسان، بوصفها أوامر إلهية، وهو ما يمثّل جوهر كلّ دين”44. بيد أنّه ليس للدين العقلي مضمون دعويّ جاهز، مثلما هو حال الأديان التاريخية. لذلك ما من حلّ أمامنا لفهم الدين التاريخي، مثل الإسلام، سوى أن نؤوّل النصّ “نصّ الوحي”، لكنّ خطورة كانط هنا لا تكمن في تقنيات التأويل التي يمكن أن يقدّمها، أو أن يمارسها؛ بل في أدب التأويل الذي يقترحه: هو يعترف بأنّ كلّ تأويل لنص الوحي “يظهر لنا، بالنظر إلى النصّ (نصّ الوحي)، متكلّفًا، وقد تمّ على كره في أغلب الأحيان، وفي أغلب الأحيان، يمكن أن يكون كذلك بالفعل، ومع ذلك ينبغي، إذا كان ممكنًا فحسب، وكان هذا النص يقبل به، أن يُفضَّل على مثل ذلك التفسير الحرفي الذي إمّا أنّه لا يحتوي على أيّ شيء مطلقًا من أجل الخلقيّة، وإمّا أنّه يعمل رأسًا ضدّ الدوافع التي تحضّ عليها”45. ما يقترحه كانط عنف تأويلي مناسب لعقولنا؛ مناسب: أي موافق للمعنى الكوني للأخلاق التي يمكن أن تقبل بها طبيعتنا البشرية بشكل محايث. كلّ الشعوب قامت بهذا العمل التأويلي الأساسي لوجودها التاريخي: “كلّ علماء الشعوب” تصرّفوا مع “كلّ أنواع العقائد القديمة والجديدة” على نحوٍ، حيث صارت في النهاية “في توافق تام مع المبادئ الخلقية الكونية للإيمان”46. وهذا ما يصدق -حسب كانط- على اليونان، والرومان، واليهود، والهنود، وفيما يخصّنا، على المحمّديين47.
ب– دين شجاع، أو في حدود الكبرياء
لا يبلغ حوار كانط مع الإسلام ذروته إلّا في هامش من كتاب (الدين في حدود مجرّد العقل)، عندما يصف ما يسمّيه “المحمّدية” بأنّها دين مؤسّس على الكبرياء، وبأنّ كلّ طقوسها من نوع شجاع48. وهو موقف لا يمكن أن نفهمه حقًّا، إلا متى وضعناه في لحظة فلسفية تعتمد منهج الدين المقارن، ونعني قراءة رأي كانط في ضوء آرائه في المسألة نفسها، كما يطرحها في شأن الأديان الأخرى، ولا سيما المسيحية واليهودية، ونحن سنورد النصّ كاملًا حتى نتعرّف السياق، ونرى جملة المسألة في تركيبها الخاص. قال: “إنّ الضروب المختلفة من الإيمان لدى الشعوب، إنّما تمنحها أيضًا، شيئًا فشيئًا، طابعًا مميّزًا على الصعيد الخارجي في العلاقة المدنيّة، يُنسَب إليهم، لاحقًا، كما لو كان الخاصية الكلية لمزاجهم. كذا حال اليهودية فهي، تبعًا لتأسيسها الأوّل، بما أنّها شعب كان يجب عليه أن يفصل نفسه عن كلّ الشعوب الأخرى بوساطة كلّ المناسك التي يمكن تخيّلها، والعقابية في شطر منها، وأن يحتاط من كلّ اختلاط بها، قد جذبت لنفسها تهمة كره البشرية.
أمّا دين مُحمّد (der Mohammedanism) فهو يتميّز بالكبرياء؛ إذ بدلًا من المعجزات، وجد التأييد الخاص بإيمانه في الانتصارات، وفي قهر الشعوب الأخرى، وطقوس عبادته كلّها من نوع شجاع. أمّا المعتقد الهندي، فهو يمنح أتباعه طابع عدم الشجاعة (Kleinmütigkeit) لأسباب مناقضة، تمامًا، لتلك التي ذكرناها للتوّ. وبذلك فإنّه من اليقين أنّه ليس أمرًا كامنًا في الهيئة الباطنة للإيمان المسيحي؛ أنّه يمكن أن نلومه لومًا مماثلًا؛ بل في الطريقة التي يُقدَّم بها إلى النفوس، بسبب الذين يرون فيه، من كلّ قلوبهم، رأيًا حسنًا، إلّا أنّهم -إذْ يجعلون من الفساد البشري منطلقًا، ويشكّون في كلّ فضيلة- يضعون مبدأ الدين في الورع (Frömmigkeit) فحسب (وما يُفهَم من ذلك مبدأ السلوك الشقيّ بالنظر إلى تقوى الله التي علينا انتظارها من قوّة تأتي من فوق)؛ من أجل أنّها نفوس لا تضع أيّ ثقة في نفسها أبدًا، وهي تتطلّع، في قلق دائم، إلى عونٍ يأتيها من خارج الطبيعة؛ بل حتى تظنّ أنّها، بهذا الاحتقار لنفسها (الذي هو ليس من الخشوع في شيء)، تمتلك وسيلة للظفر بحظوة ما، وهي أمور لا ينبئ التعبير الخارجي عنها (في النزعة التقويّة “Pietismus” أو التظاهر بالورع)، إلّا عن نوع من النفوس التي تربّت على العبودية. هذه الظاهرة المتميّزة (للكبرياء لدى شعب ليس بعالِمٍ، إلا أنّه بصيرٌ بإيمانه) يمكن أيضًا أن تتأتّى من تخيّل مؤسّسه، كونه وحده قد جدّد في العالم، مرة أخرى، مفهوم وحدة الله، وطبيعته فوق المحسوسة. وسيكون في ذلك -لا ريب- نحو من النبل الذي أضفاه على شعبه؛ إذْ حرّره من عبادة الصور، ومن فوضى الشرك، لو كان يستطيع أن ينسب إلى نفسه هذا الفضل عن حقّ. أمّا الطابع المميّز للطبقة الثالثة من أتباع الدين [المسيحيين] التي تجد أساسها في الخشوع المفهوم على نحو سيّئ، فإنّ الحطّ من الاعتزاز بالنفس، في تقدير المرء لقيمته الخلقيّة لا يجب عبر التعيير بقداسة القانون، أن يسبّب احتقار المرء لنفسه، بقدر ما يجب أن يُحدِث لديه [VI، 185] -طبقًا لهذا الاستعداد النبيل الذي في صلب أنفسنا- مزيدًا من العزم على الاقتراب أكثر فأكثر دومًا من موافقة هذه القداسة، والجدارة بها. وبدلًا من ذلك فإنّ هذه الفضيلة التي تتمثّل على الحقيقة في الشجاعة على ذلك إنّما يتمّ ردّها إلى الوثنية، كأنّها اسم متّهم بعدُ بالاعتزاز بالنفس. وعلى الضدّ من ذلك يُمجَّد الاجتلاب الذليل للمنافع والميزات. إنّ التزمّت (التعصّب الديني، التفاني الزائف/ devotio spuria) هو الاعتياد على وضع ممارسة الورع، ليس في الأفعال المرضية لله (في القيام بكلّ الواجبات الإنسانية) بل، بدلًا من ذلك في التعامل المباشر مع الله، من خلال مظاهر الرهبة؛ وهي ممارسة ينبغي أن تُعدّ عندئذ ضربًا من عبادة العبيد (opus operatum)، إلا إذا أُضيف أيضًا إلى الاعتقاد في الخرافات شيءٌ من الوهم الحماسيّ بأنّ وراء ذلك توجد مشاعر فائقة للحسّ (سماوية) مزعومة”49.
نحن نريد أن نناقش رأي كانط في الإسلام، في ضوء هذا السؤال الهادي: ماذا نفعل اليوم بكبريائنا الديني؟ وهل يمكننا أن نضع حدودًا لكبريائنا، حيث لا تتحوّل شجاعتنا الدينية إلى مجرّد “حماسة” بلا أيّ وعود إنسانية كونية؟
الفيلسوف الكسموبوليطيقي، إلى الجهة الروحية التي نقف فيها نحن العرب أو المسلمين الذين يعيشون في فترة “ما بعد الملة.
فلسفيًّا ينطلق كانط من أنّ الفرق الحاسم بين البشر، في مسألة الدين، هو ذاك الذي يفصل بين مَن يبحث عن عبادة الإله في هذا الشيء الحسّي أو ذاك، وبين الذين يعتقدون بأنّ “تلك العبادة لا توجد إلا في النيّة الهادفة إلى سيرة حسنة فحسب”50. الدين -مهما كان- نيّةٌ فحسب، ليس لها من هدف آخر سوى سيرة حسنة فحسب. بين العرّاف البدائي والأسقف الأوروبي فرق في المسافة، ولكن ليس في المبدأ51. الإيمان عمل شكلي، أو لا يكون. إنّه تحسين لشكل الحياة في أنفسنا لا غير؛ ولذلك كلّ إيمان يدّعي أنّه يؤسّس معرفة بشيء خارج عقولنا هو ضرب من “البابويّة” فحسب، ونعني أنه: لا يعدو أن يكون نوعًا من “هيبة الأب” فحسب، وهذا هو أصل المعنى اللاحق “للاستبداد الروحي”52. وحسب كانط، لا يمكن تبرير الاستبداد حتّى بما هو أفضل لنا. قال: “إنّ مراسيم تأمرنا بشكل استبداديّ (despotisch)، على الرغم من أنّها مفروضة علينا من أجل الأفضل لنا (ولكن ليس بوساطة عقلنا)، لا يمكننا أن نرى فيها أيّة فائدة”53. ولا فرق عندئذ بين استبداد المبادئ، واستبداد التمائم؛ لأنّ الفرق الحقيقي يكمن -حسب كانط- بين “الخضوع الخانع لعقيدة ما بوصفها عبادة العبيد”، وبين “التكريم الحرّ الذي يجب أن يتمّ، في المقام الأوّل، تجاه القانون الأخلاقي”54.
بِهذا المَعنى ليس من دلالة للفظة “دين” (religionn) سوى معنى “التقوى” بمعنييها: “الخوف من الله”، في مَعنى أنَّ العلاقة مَع اللهِ هي “دَين”، وليس هذا الدَّين غير لُزوم احترام القانون الأخلاقيّ؛ و”مَحبّة الله”، بِمعنى أنَّ الإيمان “اختيار حُرّ، بِناءً على الرّضا بالقانون”55. أمّا مَن يطمع في إعطاء مَضمون حسّي، أو تشبيهيّ، للكائن فوق المَحسوس الّذي نحتاج إلى وجوده كي يكون هناك مَعنى نهائيّ لوجودنا على الأرض، وهو مَعنى لا يمكننا أن نَبتَّ فيه بعقولنا، فإنّ “فكرة هذا الكائن لن تستطيع أن تصمد لذاتها في نِطاق العقل التأمّلي”56. بهذا المعنى الدّقيق، يقترح كانط أن نُقدّم الفضيلة على التّقوى، والأخلاق على الدّين، “أن نعرض نظرية الفضيلة قبل نظرية التقوى”57. هذا الطَّابع المُشتق، أو الفرعي، للتقوى سوف يجعلها غير قادرة على الاكتفاء الأخلاقي بنفسها. إنّ “نظريّة التقوى لا يمكنها أن تُمثّل لذاتها الهدف النَّهائيّ للمسعى الأخلاقي؛ بل هي تصلح وسيلة فحسب لزيادة قوة الشّيء الّذي في حدِّ ذاته يصنع إنسانًا أفضل، ونعني: نيّة الفضيلة”58.
جوهر الدين أن يمدّ أيّ فضيلة بشرية بنحو من “القوّة” الاستثنائية التي لا يمكن للأخلاق أن تستمدّها من أيّ جهة أخرى. “زيادة القوة” في أنفسنا، هذا هو جوهر أيّ إيمان بشري، ولكنّ هذا يعني أنّ أخطر ما يمكن أن يُصيب دينًا من الداخل لن يكون -حسب كانط- شيئًا آخر سوى أن “يتعرّض لخطر إسقاط شجاعته (التي تمثّل جوهر الفضيلة)، وتحويل التقوى إلى خضوع عبودي ومتملّق، تحت سلطة آمرة بشكل استبدادي”59. ما يقترحه كانط أن نترك جوهر الفضيلة؛ أي فكرة الشَّجاعة، تتخلّل إلى جوهر التقوى؛ أي الإيمان الحرّ. وفي رأيه أنّ “هذه الشجاعة ينبغي أن تقف على قدميها بنفسها”60. لا يمكن لأيّ كان أن يعلّمك كيف تكون شجاعًا، وكيف تكون حرًّا في الوقت نفسه؛ فليس ثمّة شجاعة تابعة لأحد. وحدها الشجاعة التي تستطيع أن تشرّع لنفسها، هي حرّة. ودور الدين أن يعلّم الناس “تقوية” الشجاعة بوساطة نمط معيّن من “المصالحة” (Versöhnung) مع أنفسنا، في معنى نحوٍ من “التبنّي” لأنفسنا. وهكذا يقابل كانط بين الشجاعة التي “تفتح لنا السبيل نحو سيرة جديدة في الحياة”، وبين “جهد فارغ، كي نجعل ما حدث لم يحدث (أي القيام بكفّارة)، فإنّ الخوف من تملّك هذه الكفّارة، وتمثّل عجزنا الكامل عن الخير والشُّعور بالقلق من السّقوط مرة أخرى في الشرّ، أمور لا بدّ من أن تُفقد الإنسان شجاعته، وتضعه في حالة خلقية منفعلة مؤلمة، هو حيث هو لا يضطلع بأيّ شيء ممّا هو عظيم، أو خير؛ بل ينتظر كلّ شيء من التمنّي”61. إنّه، في هذا السيّاق بالتحديد، أتى كانط في كتاب (الدّين في حدود مجرّد العقل) إلى الهامش المطوّل الذي توقّف فيه عند الطبع الروحي للمحمّديين. وهذا الطبع الرُّوحيّ هو الكبرياء. قال: “أمّا دين مُحمّد (der Mohammedanism) فهو يتميّز بالكبرياء؛ إذ بدلًا من المعجزات، وجد التأييد الخاص بإيمانه في الانتصارات، وفي قهر الشعوب الأخرى، وطقوس عبادته كلّها من نوع شجاع”. أيّة علاقة فلسفية بين “الكبرياء” وبين “طقوس عبادة من نوع شجاع”؟
الطَّريف في خطّة كانط هنا كونه ينظر إلى الدين باعتباره مفترق طرق بين “ضروب مختلفة من الإيمان لدى الشعوب”، ومن ثَمَّ هو لا يهتمّ بأيّ نمط من الإيمان، إلّا في ارتباطه بأمرين: أنّه خاص بشعب معيّن؛ لا سيما أنّه يفرض عليه، على الصعيد الخارجي، “علاقة مدنيّة” مؤدّاها أنّ هذا الإيمان قد تحوّل، لدى ذلك الشعب، إلى ضرب من “الخاصية الكلية لمزاجه”. كلّ دين هو طبع كلّي لشعب من الشعوب يستعمله، باعتبار علاقته المدنية بذاته الخارجية، أو المزاج العام لنفسه العميقة. بهذا المعنى، تبدو اليهودية -حسب كانط- دين شعب “جذب لنفسه تهمة كره البشرية”. لماذا؟ لأنّه دين حوّل مزاجه العام إلى شريط من المناسك، والعقوبات الروحية التي تهدف صراحةً إلى أن “يفصل نفسه عن كلّ الشعوب الأخرى”.
تبدو اليهودية، في عين كانط، نمطًا من العزلة الروحية للشعوب. ولذلك كلّ تهوّد هو سياسة انفصال ذاتي عن بقية الإنسانية، وهو انفصال يؤدّي دور المزاج، أو العلاقة المدنية بالنفس؛ ولذلك فإنّ “تهمة كره البشرية” لا تُؤخذ هنا مأخذًا سلبيًّا؛ بل إن الكره كسياسة انفصال ذاتي هي شكل التذوّت الخاص بشعب دون آخر. الكره هو المزاج الروحي الكلي لنفس يهودية، لكنّ الكره ليس مجرّد انفعال حزين هنا؛ بل هو مزاج؛ أي خاصية كلية لضرب من العلاقة بالنفس. هنا تأتي هذه العبارة الحازمة: “أمّا دين محمّد”، والأدقّ “المحمّدية”، أو “مذهب محمّد”. علينا أن نضع، في الاعتبار أنّه بعد “الكره” اليهودي سوف يتحدّث كانط عن “الكبرياء” المحمّدي الذي لا يعبد إلا بوساطة “طقوس شجاعة”. ولكن ماذا يعني كانط بمفهوم “الشجاعة” ؟ وهل كلّ ما هو شجاع ينبغي أن يتميّز بالكبرياء؟ وعندئذ علينا أن نسأل: هل يُفرّق كانط بين “الكبرياء” وبين “التكبّر”؟
– في المقدّمة إلى “نظرية الفضيلة” من كتاب (ميتافيزيقا الأخلاق) (1797م)، شرح كانط فكرة “الفضيلة” بطريقة طريفة: إنّ الفضيلة ليست تنازلًا؛ بل “قدرة”. ينبغي أن تكون قادرًا على الفضيلة، لكنّ هذه القدرة لا تتعلق بفعل شيء طبيعي؛ بل بشيء معاكس لطباعك؛ وميولك. وهكذا “ينبغي على المرء أن يحكم على نفسه بأنّه يستطيع، ما يأمر القانون أمرًا لا مشروطًا، بأنّه يجب عليه أن يفعله”62. وراء الفضيلة، هناك استطاعة، إلا أنّه لا يمكن أن تعبّر عن نفسها إلّا في شكل واجب. وفي هذا السياق بالذات، أتى كانط إلى معنى “الشجاعة”؛ الشجاعة بوصفها قدرة نبيلة على الواجب، وبهذا المعنى، المنتصر الحقيقي هو من ينتصر على نفسه. قال: “بيد أنّ القدرة والعزم المتروّي على مقاومة خصم قويّ، ولكن غير عادل، هي البسالة (Tapferkeit ، fortitudo)، وبالنظر إلى الخصم المناوئ للنيّة الخلقيّة فينا، هي الفضيلة (virtus). وهكذا فإنّ النظرية الكلية للواجبات، في الجزء الذي يضع تحت القوانين ليس الحرية الخارجية؛ بل الحرية الباطنية، هي نظرية الفضيلة”63.
في رأي كانط، وحدهم الأحرار يمكن أن تكون لهم واجبات؛ فليس كلّ ما يوجبه المرء على نفسه واجب خلقي. فليس في معنى الواجب الخلقي إكراهٌ لأحد؛ بل “إكراه لأنفسنا” فحسب64. وإذا كان “القانون” لا يمسّ إلّا ما سمّاه كانط “حريتنا الخارجية”، فإنّ “الفضيلة” تتعلّق بحريّتنا الباطنية، ولكن هل كلّ ما يُفعل بحرية حرّ؟ حسب كانط كلّ من تسوّل له نفسه أن يفعل بي شيئًا مناقضًا لإرادتي يتعامل معي، ليس بوصفي غاية في ذاتي، بل بوصفي مجرّد وسيلة لشيء غريب عن ذاتي. هناك تناقض ينخر كلّ حرية تستعمل البشر بوصفهم مجرّد وسيلة. قال كانط: “سيكون ذلك فعل حريّة، إلا أنّه مع ذلك ليس فعلًا حرًّا”65. وحده الفعل الشجاع يكون نابعًا من حرية حرّة؛ ولذلك ما فتئ يؤكّد كانط: “لهذا السبب فإنّ هذه القوة الأخلاقية أيضًا، بما هي بسالة، إنّما تشكّل شرف المحارب (die Kriegsehre) الحقيقي الأكبر والوحيد للإنسان”66.
بأيّ معنى إذًا تتميّز النّفوس الشّجاعة بالكبرياء؟ إذ يتساءل كانط مثلًا: هل يمكن أن نَعُدَّ “الجرائم الكبرى” نَابعةً مِن ضَرب مِن “قوّة النّفس”، أو “رباطة الجأش” (Stärke der Seele)67، وليس من “فضائل كبيرة”؟ في الفقرة 42 من “نظرية الفضيلة” في (ميتافيزيقا الأخلاق)، بسط كانط تعريفه للكبرياء على النحو الآتي:
إنّ الطَّريف في خطّة كانط هنا كونه ينظر إلى الدين باعتباره مفترق طرق بين “ضروب مختلفة من الإيمان لدى الشعوب”، ومن ثَمَّ هو لا يهتمّ بأيّ نمط من الإيمان، إلّا في ارتباطه بأمرين: أنّه خاص بشعب معيّن؛ لا سيما أنّه يفرض عليه، على الصعيد الخارجي، “علاقة مدنيّة.
“إنّ التّكبّر(/der Hochmut ’’superbia’’) -كما يعبّر هذا اللَّفظ عن ذلك الميل دائمًا إلى السّباحة في الأعالي- هو ضربٌ مِن الطّموح (ambitio) بمقتضاه نحن نُطالب أُناسًا آخرين بأن يُقدّروا أنّهم لا شيء بالمقارنة معنا، ومِن ثَمَّ هو رذيلة تتناقض مع الاحترام الّذي يُمكن لأيّ بشر أن يدّعيه لنفسهِ ادّعاءً مشروعًا. وهو شيء ينبغي أن نميّزه عن الكبرياء (der Stolz/’’animus elatus’’، مِن حيث هو حُبّ التكريم ‘’Ehrliebe’’)، بمعنى الحرص التام على عدم التنازل عن أيّ شيء من كرامتنا الإنسانية، بالمقارنةِ مَع الآخرين (الذين تعوّدنا مِن دهرنا أن نُطلق عليهم صفة النّبيل)؛ ذلك أنَّ التكبّر يشترط على الآخرين احترامًا هو، مع ذلك يمنعه عنهم، لكنّ هذا الكبرياء قد يتحوّل إلى خطأ وإلى تهجّم، حين يكون أيضًا مُجرّد ادّعاء على الآخرين بأن يهتمّوا بأهمّيتنا”68. لقد حصلنا الآن على أدوات التوضيح المناسبة لقول كانط عن الإسلام: إنّه دين شُجاع يتميّز بالكبرياء.
فبأيّ معنى؟ ربّما نعثر هنا على سِرّ المَيل إلى تسمية “الإسلام” بأنّه “المُحمّديّة”. ربما قصد كانط أنّه من هذا القبيل: لكي نفهم الإسلام، علينا إرجاعه إلى خُلُقِ مؤسِّسِه. “محمّد” –مثل بقيّة الرسل- هو بالأساس، بالنسبة إلى كانط، نمط خلقيّ، أو مَثَل أعلى خلقيّ، وعلينا أن نتعامل مع دينه على هذا الأساس. ما هو “محمّدي” فعلًا هو “خلقي” في الدين الذي أسّسه، وما عدا ذلك هو شيء لا يمكن أن يهمّ العقل البشريّ، عندما يريد أن يُحدّد فكرة الدّين بإطلاق. هنا نفهم مَعنى الكبرياء المُحمّديّ؛ إنّه يدعو إلى دين لا يعوّل على “المعجزات” الّتي تستخفّ بالعقل البشريّ (مثل الدّين اليهوديّ، أو المسيحيّ)؛ بل على “الانتصارات وقهر الشعوب الأخرى”؛ دين يشتقّ ماهيته مِن الانتصار، أي إنّ ماهيته الأصلية ماهيّة حربيّة. بهذا المَعنى رُبّما كان الإسلام أوّل دين بالمَعنى “الحديث”؛ أي أوّل دين “ذاتي”، أو “مُحايث”، وبعبارة مُزعجة: هو أوّل دين “عِلمانيّ” في تاريخ التوحيد. وفِي هذا النّحو ينبغي أن نَفهم إشارة كانط بأنّ “طُقوس عبادته كلّها مِن نوع شجاع”. الطَّقس الشُّجاع هو طقس لا يستخفّ بقدرة البشر؛ بل يتماهي مَع هذه القدرة، ويدفعها إلى الذَّهابِ في مُحايثتها إلى النّهاية. والمُحايثة تَعني استعمال قوة الطَّبيعة البشريّة دون أيّ تعوّيل عَلى المُعجزات، وهذا بالضبط ما لاحظه كانط في ماهية الدّين المُحمّديّ، وهو “مُحمّدي” بِهذا المَعنى بالذات: إنّه دين كبرياء، بمعنى “حُبّ التّكريم”، (Ehrliebe) لإنسانيتنا، باعتباره المقياس البعيد المدى لأيّ نوع مِن العِبادة. لكنّ الهالة الفلسفيّة لرأي كانط في الإسلام لن ينكشف إلا إذا ضبطنا الاعتراضات الخُلقيّة الخطيرة جِدًّا التي سجّلها كانط ضدّ الطِّباع التي تحكم “الهيئة الباطنة للإيمان المسيحيّ”. فما يتميّز به ما هو “محمّديّ”، هو بالتحديد أنّه غير مَسيحيّ بمعنى دقيق جدًّا، أخذ كانط يطرحه بعد إشارته اللّطيفة إلى المُحمّديّة بِاعتبارها دين الكبرياء. مِن المُفيد أن نَسوق الملامح السّالبة للإيمان المسيحيّ الّتي استخرجها كانط في مرآة الإيمان المُحمّديّ؛ أيّ الإيمان الشُّجاع، وهذه الملامح هي:
1) أنّه يُمكن أن يُلام على “الطّريقة التي يُقدَّم بِها إلى النُّفوس”.
2) أنّه “يجعل من الفساد البشري منطلقًا”.
3) أنّه “يشكّ في كلّ فضيلة”.
4) أنّه “يضع الدّين في مبدأ الورع”، فبمعنى “السّلوك الشَّقي بالنظر إلى تقوى الله”.
5) أنّه يُخاطب “نُفوسًا لا تضع أيّ ثقة في نفسها أبدًا”.
6) أنّه يتوجّه إلى نُفوس تُعوّل على “الاحتقار لنفسها” كي “تظفر بحظوة ما”.
7) أنّه عبارة عن “نزعة تقوية” لا يُنبئ التَّعبير الخارجيّ عَنها إلّا “عن نوع من النُّفوس الّتي تربّت عَلى العبوديّة”96.
وبذلك إنّ الدّين المُحمّديّ دين لا مسيحيّ في ماهيته، أو في طبعهِ الرُّوحيّ الأخصّ؛ أي هو يَدين بكثيرٍ مِن قُوّته إلى الطَّريقة التي يُقدّم بها نفسه؛ أنّه يؤسّس عبادته على طقوس شُجاعة؛ أنّه ينطلق مِن أنَّ الإنسان عَلى “الفطرة” خيّر، ومِن ثمّ فإنّ الفضيلة إمكانيّة أصيلة فيه؛ أنّه لا يعوّل على ورع شقيّ؛ بل على تقوى شُجاعة، أنّه يُخاطب نُفوسًا ذات كبرياء، ومكرّمة لنفسها، ولا تحصر عملها في تقويّة فارغة مِن الحقّ في “الدنيا”؛ أيّ في كلّ مَا تحتوي عليه طبيعتها مِن قِوى وطِباع قوّية. كلّ هذه الصِّفات هِي الصِّفات الخُلقيّة الّتي يُريد كانط تأسيسها في الشَّخصيّة البشريّة قاطبة، وبالاعتماد على تعليل عقليّ قبلي. بيد أنّه يجدر بنا أن نُنبّه إلى أنّ كانط قد حاول، في موضع لاحق، أن ينسب حكمه السابق إلى الطبع الرّوحي للإسلام؛ أي طبع الكبرياء، وذلك في الطبعة الثانية (سنة 1794م)، حيث أضاف، للغرض، هامشًا إلى الهامش الذي كان قد أثبته إبّان الطبعة الأولى (سنة 1793م). قال: “هذه الظاهرة المتميّزة (للكبرياء لدى شعب ليس بعالِمٍ إلا أنّه بصيرٌ بإيمانه) يمكن أيضًا أن تتأتّى من تخيّل مؤسّسه، كونه وحده قد جدّد في العالم، مرة أخرى، مفهوم وحدة الله، وطبيعته فوق المحسوسة، وسيكون في ذلك -لا ريب- نحو من النُّبل الذي أضفاه على شعبه؛ إذْ حرّره من عبادة الصور، ومن فوضى الشرك، لو كان يستطيع أن ينسب إلى نفسه هذا الفضل عن حقّ. أمّا الطابع المميّز للطبقة الثالثة من أتباع الدين [المسيحيين] التي تجد أساسها في الخشوع المفهوم على نحو سيّئ، فإنّ الحطّ من الاعتزاز بالنفس، في تقدير المرء لقيمته الخلقيّة، لا يجب، عبر التعيير بقداسة القانون، أن يسبّب احتقار المرء لنفسه، بقدر ما يجب أن يُحدث لديه، [VI، 185] -طبقًا لهذا الاستعداد النبيل الذي في صلب أنفسنا- مزيدًا من العزم على الاقتراب أكثر فأكثر، دومًا، من موافقة هذه القداسة، والجدارة بها. وبدلًا من ذلك فإنّ هذه الفضيلة التي تتمثّل على الحقيقة في الشجاعة على ذلك إنّما يتمّ ردّها إلى الوثنية، كأنّها اسم متّهم بعدُ بالاعتزاز بالنفس. وعلى الضدّ من ذلك يُمجَّد الاجتلاب الذليل للمنافع والميزات. إنّ التزمّت (التعصّب الديني، التفاني الزائف، “devotio spuria”) هو الاعتياد على وضع ممارسة الورع، ليس في الأفعال المرضية لله (في القيام بكل الواجبات الإنسانية)؛ بل بدلًا من ذلك في التعامل المباشر مع الله، من خلال مظاهر الرهبة؛ وهي ممارسة ينبغي أن تُعدّ عندئذ ضربًا من عبادة العبيد (opus operatum)، إلّا إذا أُضيف أيضًا إلى الاعتقاد بالخرافات، شيءٌ من الوهم الحماسيّ بأنّ وراء ذلك توجد مشاعر فائقة للحسّ (سماوية) مزعومة”70.
إنّ مَصدر الصَّدقة هو “النهب من الآخرين”؛ لأنّ “التَّضحيّة للربّ في شخص الفقراء” بوساطة النّهب سرقة، وليست عطاء.
هنا يُريد كانط أن ينبّهنا إلى أنّ الكبرياء، هذه “الظَّاهرة المُميّزة” لما هو “مُحمّديّ”، ليس “علمًا” يمتلكه شعب ما دون آخر؛ بل هو “بصر بالإيمان” الخاص به. ولكن ما الذي يجعل شعبًا ما “بصيرًا” (verständig)؛ أي مُتفهّمًا للطبع الرّوحيّ الّذي صَدر مِنه إيمانه؟ الجواب هو أن يتواضع بالشكل المُناسب، حيث لا “يتخيّل مؤسّسه” كونه “وحده من جدّد مفهوم الله”. هذا بالضبط ما لا يدّعيه المحمّديون؛ لذلك يبقى على كانط أن يعترف بأنّ “تحرير شعب ما من عبادة الصور، ومن فوضى الشرك” نوع رفيع من “النبل” الذي يحقّقه دين الكبرياء. هذا التنسيب، أو الشرط الذي وضعه كانط، مهمّ جدًّا؛ لأنّه يضمن التفريق الدقيق بين دين الكبرياء ودين التكبّر. هنا يعود كانط إلى إلقاء نظرة إضافية على المهانة الروحية التي يلحقها دين العبيد بجوهر الإيمان. وهو، مرة أخرى، يأخذ الدين المسيحي مثالًا، فهذا الأخير يؤسّسه نفسه على “الخشوع المفهوم بشكل سيّئ”: الخشوع الذي يقوم على “الحطّ من الاعتزاز بالنفس في تقدير المرء لقيمته الخلقية”، وذلك في مقابل “قداسة القانون”.
والأطروحة التي يدافع عنها كانط هي: بدلًا من احتقار أنفسنا أمام قداسة القانون علينا أن ننمّي “الاستعداد النبيل الذي في صلب أنفسنا”؛ ذلك الذي مِن شَأنه أن يمنحنا “مَزيدًا مِن العَزم على الاقتراب أكثر فأكثر دومًا من موافقة هذه القداسة والجدارة بها”. وضدّ الاعتقاد المسيحي بأنّ الشجاعة، على ذلك موقف وثني، يؤكّد كانط أنّ الاعتزاز بالنفس ليس قيمة وثنية؛ بل إنّ ما هو وثني هو “التزمّت”، و”التَّفاني الزَّائف”، وحصر الإيمان في “الورع الزَّائف”، وحصر الدّين في “مَظاهر الرَّهبة”، وليس ذلك سوى “عبادة العبيد”. بذلك يتبيّن لنا في آخر الأمر أنّ كانط لم يتكلّم على الإسلام، أو عن المُحمّديّة، إلا مِن أجل نقد الإيمان المسيحيّ، في مِرآة إيمان آخر يتميّز عنه بالقدرة على التعبير عَن نفسهِ بشجاعة71، ومِن ثمَّ فهو أقرب إلى حفظ الكرامة الإنسانيّة مِن أيّ دين آخر، اللّهم إلّا الدين العقليّ المحض، الّذي أراد كانط تأسيسه فلسفيًّا، في نوع مِن التَّجريب التّأويليّ مَا بعد الإسلاميّ.
خاتمة: صدقة الإنسانية، أو ما الذي يمكن أن نُعطيه اليوم؟
بقيت إشارة ذات أهمية خاصة هي تلك التي ساقها كانط في آخر كتاب (الدين في حدود مجرّد العقل)، وتتعلّق بالدلالة الفلسفية للأوامر الخمسة الكبرى في العقيدة المُحمّدية، ولا سيما: أيٌّ منها يجدر بنا الوقوف عندها؟
قال: “كما هو الشأن، على سبيل المثال، في العقيدة المُحمّديّة، مَع الأوامر الكبرى الخمسة؛ الوضوء، والصلاة، والصوم، والصدقة، والحجّ إلى مكة؛ ومن بين هذه الأوامر الصدقة، وحدها، تستحق أن تُستثنى، متى ما تمّت بناءً على نيّة حقيقية فاضلة، وفي الوقت نفسه دينيّة، ومن أجل واجب إنساني. عندئذ تستحقّ، بالفعل، أن تُعَدَّ وسيلة لاستجلاب النّعمة. ولكن بما أنّها -حسب هذه العقيدة- يمكن أن تتوافق مع النّهب مِن الآخرين للشيء الذي يُقدَّم تضحيةً للربّ في شخص الفقراء، فإنّها لا تستحقّ أن تُستثنى”72.
مِن الطَّريف أن يقف كانط عند “الصَّدقة” باعتبارها الأمر الدّيني الخليق باستثنائه من أوامر العقيدة المُحمّديّة. يرى كانط أنّ الصّدقة متى ما تمّت بناء على نيّة حقيقية؛ أي “فاضلة ودينية في الوقت نفسه”، ومن “أجل واجب إنساني”، فهي تستحقّ اسم “النّعمة” الإلهيّة. وبطبيعة الحال يشترط كانط ألّا يكون مَصدر الصَّدقة هو “النهب من الآخرين”؛ لأنّ “التَّضحيّة للربّ في شخص الفقراء” بوساطة النّهب سرقة، وليست عطاء. علينا أن نسأل الآن: هل لدينا اليوم ما نُعطيه من أنفسنا العميقة للإنسانية؟ ونعني: أيّ نوع من الصّدقة الإنسانيّة يمكننا أن ندّعي بلا تردد، أو خجل؟ المصدر الوحيد للثروة الروحيّة اليوم هو الثّقافة الغربيّة، ونحن لا ننفكّ ننهل مِن مَنابع المَعرفة الإنسانيّة الكونيّة الّتي وضعتها الإنسانيّة الغربيّة المُعاصرة عَلى ذمّتنا، وكانط أبرز مثال على ذلك. أم أنّنا لم نفعل، إلى الآن، سوى “النَّهب مِن الآخرين”؛ النَّهب الرُّوحيّ، والفلسفيّ، والعلميّ، والتّكنولوجيّ مِن الغَربِ؟ مَتّى تُصبح صَدقتنا نابعة مِن “نيّة فاضلة” تكون “دينية” في الوقت نفسه؟ ولكن أيضًا: هل يمكن أن يكون التعلّم، والطموح إلى التعلّم، ضربًا من الصدقة الكونية؟ لقد حدث انكسار معياريّ في وجودنا المعاصر بين مشاعر الإيمان وقيم السيرة الحسنة، بين الدين والأخلاق. ولا يبدو أنّنا نملك بعد علاجًا أوّليًا مناسبًا لوضعنا الروحي الراهن، عدا ما منحنا إيّاه فيلسوف مثل كانط. بيد أنّ شعورًا مزعجًا لا يلبث أن يلمّ بالباحث غير الغربي، أو المسلم، انتماءً، عندما يتابع مع كانط رحلته التأويلية داخل قارة الدين، ويحاول أن يستفهم إشاراته النقدية للضروب المختلفة من الإيمان التي ما انفكّت تعمل في ضمير الإنسانية. ربّ شعور هو: كأنّما مع انبثاق الأزمنة الحديثة، وقع تبادل أسرى ميتافيزيقي بيننا وبين الغرب؛ أعطونا دين العبيد (المسيحي)، وأخذوا منّا دين الأحرار (المحمّدي)، فصاروا، كما قيل ذات مرة، في رشاقة مُرّة، “مسلمين بلا إسلام، ولكنّنا صرنا مسيحيين بلا مسيحية”. وقد صار علينا من بعدُ أن نفرّق هذه المرّة تفريقا حاسمًا بين مُجرّد “الاستقلال” عن الغرب (وهو معنى “liberty” من اليونانية “eleutheria” التي تُشير إلى وضع يكون بهِ المَرء مُستبدًّا بنفسهِ، مُنفصلًا عَن غيره، متميّزًا) وبين “الحرية” (وهو معنى “freedom” من الجذر الهنديّ- الأوروبيّ “priya” الذي يعني “العزيز أو “المحبوب”، ويشير إلى المُشاركة ضمن عائلة أو قبيلة مُستقلّة)73.
ولم يكن كانط غير الفيلسوف الذي أرّخ لذلك الحدث الرُّوحيّ “الحديث” بِمرارة غير خفيّة على القارئ الأوروبيّ، ولكن بآداب ضيافة للمقروء الإسلاميّ، لا تزال عصيّة علينا. إنّ مُشكل العلاقة الفلسفيّة المُمكنة بين كانط والإسلام ليس خاصًّا “بنا”، بل هو همٌّ نظريّ عَالميّ تَصدّى له بِالمساءلةِ باحثون “غربيّون”، وذلك لأسباب خاصة “بِهم” وذلك مُنذ اللَّحظة الّتي دَخل فِيها الإسلام في أُفق الإنسانيّة “ما بعد الحديثة” بقوّة مُذهلة. صَار السُّؤال هو: كيف يمكن لنّظريّة كانطيّة أن تُستعاد –أن تقع زيارتها مِن جديد- وذلك مِن أجل أخذ الإسلام في الحُسبان وبغرض إمكانية العيش مَعه؟ طبعًا علينا التذكير بأنّ أصل هذه المقالة هو الخوف (الليبراليّ) مِن فتح الباب لرهط مِثل طالبان74 أو داعش. لكنّ الحلّ الأكثر استساغة هو العمل على خَلق سِياق (مِن النَّوع الّذي اقترحه جيل دولوز) يسمح بحدوث “تركيب” لطيف من “الهويات” الثّقافيّة حيث يمكن التكيّف مَع مَا يُمكن أن يعنيهِ الإسلام راهنًا ولكن أيضًا حيث يُمكن للإسلامِ أن يتكيّف مَع الثّقافةِ الغربيّة عَلى نحو مُوجبٍ، في إطارِ مُراهنة فلسفيّة رشيقة عَلى أن يظهر “سبينوزيون مسلمون ينجحون في توسيع حدود ما مَعنى أن يكون المَرء مُسلمًا”75.
ومِن ثمّ لا يحقّ لأيّ ثقافة أن تُطالب ثقافة أخرى باتّباع نموذجها الخاص في التَّنوّير. ليس عَلى المُسلمين أن يتنوّروا بِشكلٍ أوروبيّ، بل عليهم أن يخترعوا طريقتهم الخاصة في تحرير الضّمير. إلا أنّ ذلك يفترض قبل كل شيء أن يفهموا ليس فقط أنّ تنوّير العقول مهمّة لا يمكن الاستعاضة عنها بأيّ ضرب مَزعوم مِن التَّأصيل، بل إنّ الدّين “بعد” عَصر التّنوير لم يعد كما كان.
المصادر:
1 – I. Kant, Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen (1764); in: Ausgabe der Preußischen Akademie der Wissenschaften, Berlin 1900, AA, II, 237, 252.
2 – E. Kant, essai sur les maladies de la tête, AA, II, 267.
3 – I. Kant, Kritik der praktischen Vernunft (1788), AA, V, 120.
4 – I. Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (1793), AA, VI, 111, 137, 184.
5 – E. Kant, Sur un ton supérieur nouvellement pris en philosophie, AA, VIII, 390.
6 – I. Kant, Die Metaphysik der Sitten (1797), AA, VI, 428.
7 – I. Kant, Der Streit der Fakultäten (1798), AA, VII, 50.
8 – I. Kant, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (1798), AA, VII, 205, 269, 279, 312, 316.
9 – E. Kant, Leçons de métaphysique. Traduction par Monique Castillo, Paris, Librairie Générale Française, 1993, pp. 123, 128.
10 – E. Kant, Leçons d’éthique, AA, XXVII, 719.
11 – Cf. Ian Almond, “Kant, Islam and the Preservation of Boundaries”, in: History of Islam in German Thought. From Leibniz to Nietzsche, Routledge, New York, 2010, pp. 29-52, 165-166.
12 – Ibid. p. 166.
13 – Ibid.
14 – Cf. Malik Mohammad Tariq, “A comparative study of kantian and islamic view of human freedom”, http://www.allamaiqbal.com/publications/journals/review/apr03/05.htm.
15 – Saud M.S. Al-Tamamy, Averroes, Kant and the Origins of the Enlightenment. Reason and Revelation in Arab Thought. Library of Modern Middle East Studies, I. B., 2014.
16 – Bobzin, H., „Immanuel Kant und die “Basmala”. Eine Studie zu orientalischer Philologie und Typographie in Deutschland im 17. und 18. Jahrhundert. In: Zeitschrift für arabische Linguistik 25 (1993) 108-131.
- • (DYBTH) اختصار يعني: (DONT YOU BELIEVE THE HYPE)؛ “لا تصدّق الإشهار”. -Marco Schöller, „Der Kaffee ist ein Teil von Deutschland“, in: Financial Times Deutschland von 11.03.2011: “…Und ein bisschen Entideologisierung könnte uns in der Islam-Debatte nicht schaden. Der deutsche Philosoph Immanuel Kant setzte über seine Doktorurkunde von 1755 in arabischen Buchstaben die Basmala, die Eröffnungsformel der Koransuren: “Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen…”.
1 – E. Kant, Leçons de métaphysique, op.cit, p. 123.
2 – Ibid, p. 128.
3 – in das Abenteuerliche.
4 – Bildern.
5 – Sie sind gute Dichter, höflich und von ziemlich feinem Geschmacke.
6 – Sie sind nicht so strenge Befolger des Islam.
7 – eine ziemlich milde Auslegung des Koran.
8 – I. Kant, Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen, op.cit, AA, II, 252.
9 – Ibid. AA, II, 243.
10 – Ibid.
11 – Battersby, Christine, “Kant’s Orientalism: Islam, ‘race’ and ethnicity”, in: The Sublime, Terror and Human Difference, Routledge, London and New York, 2007, pp. 68.
12 – Ibid. “Das Schöne selbst ist entweder bezaubernd und rührend, oder lachend und reizend”.
13 – Ibid. “In dem Nationalcharaktere, der den Ausdruck des Erhabenen an sich hat, ist dieses entweder das von der schreckhaften Art, das sich ein wenig zum Abenteuerlichen neigt, oder es ist ein Gefühl für das Edle, oder für das Prächtige. Ich glaube Gründe zu haben, das Gefühl der ersteren Art dem Spanier, der zweiten dem Engländer und der dritten dem Deutschen beilegen zu können.”
14 – op.cit., AA, II, 243.
15 – op.cit., AA, II, 237.
16 – إ. كانط، نقد العقل العملي، ترجمة غانم هنا، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2008، ص 312.
17 – المصدر نفسه، ص 312-314 (بتصرّف).
18 – die Muhamedaner
19 – Reland
20 – Vedas
21 – كانط، الدين في حدود مجرّد العقل، ترجمة فتحي المسكيني، دار جداول، بيروت، 2012، ص 781.
22 – كانط، نقد العقل العملي، مصدر سابق، ص 312.
23 – كانط، الدين في حدود مجرّد العقل، مصدر سابق، ص 581.
24 – المصدر نفسه.
25 – المصدر نفسه، ص 681.
26 – المصدر نفسه.
27 – المصدر نفسه.
28 – المصدر نفسه، ص 781.
29 – المصدر نفسه، ص 982، الهامش.
30 – المصدر نفسه، ص 982-092.
31 – المصدر نفسه، ص 872.
32 – المصدر نفسه.
33 – المصدر نفسه، ص 772.
34 – المصدر نفسه، ص 282، الهامش.
35 – المصدر نفسه، ص 382.
36 – المصدر نفسه، ص 782.
37 – المصدر نفسه.
38 – المصدر نفسه.
39 – المصدر نفسه، ص 882.
40 – المصدر نفسه، ص 882-982.
41 – المصدر نفسه، ص 982.
42 – المصدر نفسه، ص 982-092.
43 – Kant, Metaphysik der Sitten. Tugendlehre, AA, VI, 38 …” nämlich das zu können, was das Gesetz unbedingt befiehlt, daß er tun soll”.
44 – Ibid.
45 – Ibid. AA, VI, 380.
46 – Ibid. AA, VI, 381: “…ein Widerspruch mit sich selbst: ein Akt der Freiheit, der doch zugleich nicht frei ist”.
47 – Ibid. AA, VI, 405.
48 – Ibid. AA, VI, 384.
49 – Ibid. AA, VI, 465.
50 – كانط، الدين في حدود مجرّد العقل، مصدر سابق، ص 982، الهامش.
51 – المصدر نفسه، ص 982-092، الهامش.
52 – Tampio, Nicholas, Kantian Courage: Advancing the Enlightenment in Contemporary Political Thought, Fordham University Press, 2012.
53 – كانط، الدين في حدود مجرّد العقل، مصدر سابق، ص 203.
54 – Tampio, Nicholas, Kantian Courage, op. cit. p. 24-25.
55 – Ibid. p. 173.
56 – Ibid. p. 176.
فتحي المسكيني
هو أكاديمي وشاعرٌ وفيلسوف ومترجِم تونسي معروف. أثرى المكتبةَ العربية بالعديد من المؤلَّفات والترجمات القيِّمة في الفكر والفلسفة، ونال جائزة الشيخ زايد للكتاب في الترجمة عام 3102م لترجمته كتاب “الكينونة والزمان” للفيلسوف الألماني “مارتن هيدغر”. عُنِي كثيرًا بدارسة الفلسفة، ولا سيما الفلسفة الألمانية، وهو يشغل حاليًّا منصبَ أستاذ تعليم عالٍ في الفلسفة المعاصِرة بجامعة تونس، وهو ينشر أعماله البحثية باللّغات العربيّة والألمانيّة والفرنسيّة.