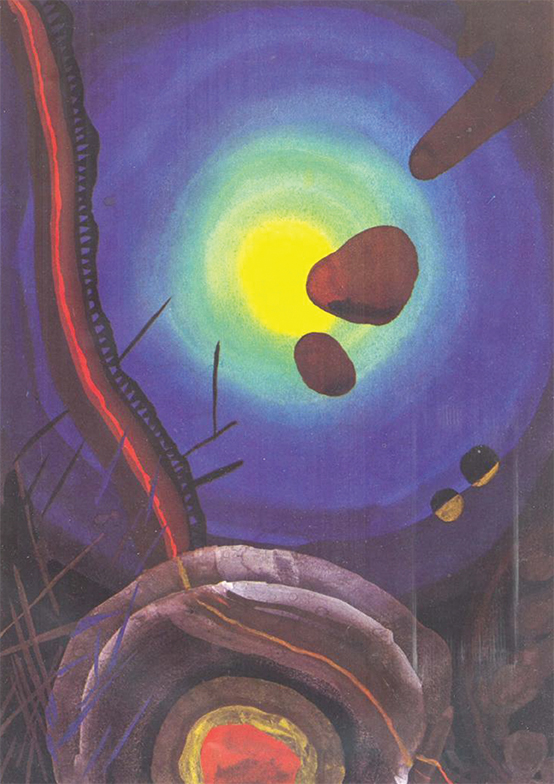مقدمة:
لعلّ الجدل بين القانونيّ والأخلاقيّ يعدُّ إشكالًا لا قرارة له، فبين من يدمجهما، وبين من يسوِّغ أحدهما بالآخر، وثالثٍ ينتصر لجهة بالضد من الأُخرى، نجد أنفسنا أمام منجزاتٍ فلسفيّةٍ كبيرة ومتشعبة، وإذا ما أضفنا البحث في قدرة الاتفاق المثاليّ الخلقيّ على إنشاء بيئةٍ سلميّةٍ وواقعيّةٍ، تتخذ التّعايش والتّضامن معيارًا لها، فإنَّنا سنجد الإشكال يتّسع أكثر، ولأجل الحدِّ من كثرة التّفريع الذي يمكن أن تنتجه هذه الدّراسة، وجب تحديد البحث بنماذج تحاكي، بل تتصدر قوائم المنتجين فيها قولًا ونصًّا
DOWNLOAD
وإنَّني لأجد في ايمانويل كانط Immanuel Kant (1724-1804) مثالًا بارزًا لدراسة هذه الإشكاليّة، في إمكان القانونيّ عبر الأخلاقيّ، ونتيجة ذلك في التّعايش والسّلم المجتمعيّ، ويمكن أن ننطلق من فرضية بحث مفادها: أنَّ الشّروط الأخلاقيّة قادرة على صناعة تعايش سلميّ، وفق مبادئ عدلٍ كونيّة.
اعتبارات كانط المثاليّة وتأسيساته الواقعيّة
يمكن فهم ما قدَّمه كانط في تصورات عن الحقّ والسّلام انطلاقًا من تصوراته في حالة الطبيعة وفهم طبيعة الإنسان ونزوعاته الأُولى، فهو يجعل الحال الطبيعيّة مقابلة للمدنيّة، كما يلزم فهم أبعاد الشّروط الأخلاقيّة للفعل الإنسانيّ ومدى أثر كل ذلك في صناعة شرطٍ موضوعيّ مدنيّ يهدف بنزعة كونيّة الى إيجاد سلامٍ وتعايش. يقول كانط: “شيئان يملآن الوجدان بإعجابٍ وإجلال، يتجددان ويزدادان على الدّوام كلما أمعن الفكر التّأمل فيهما: السّماء المُرصّعة بالنجوم من فوقي، والقانون الأخلاقيّ في داخلي” (كانط، A2007، ص 269) ومن هنا ننطلق مما ختم به كانط كتابه في “نقد العقل العمليّ”، إذ البناء على القانون الأخلاقيّ، بوصفه المحرك الأهم فيما يخص علاقة الإنسان بذاته والآخرين، سيكون ركيزة الفكر الكانطيّ، وفي عودة إلى معنى حالة الطبيعة يلزم بداية أن نفهم ما تتضمنه من طرفين مركبين لها، هما:
1-حالة الطّبيعة القانونيّة، ويقابلها حالة المدنيّة القانونيّة.
2-حالة الطّبيعة الأخلاقيّة، ويقابلها حالة المدنيّة الأخلاقيّة.
ويتصوَّر كانط الأفراد، في حالتي الطّبيعة الأخلاقيّة والقانونيّة، بشرًا قادرين على أن يسنّوا قوانينهم بأنفسهم، دون وجود طرف خارجيّ يعترف به الجميع، فكل إنسان، في هاتين الحالتين، هو القاضي لنفسه، وليس فيهما حكم عموميّ بيده السّلطة، أي لا يملك أحد حق الواجبات على الجميع، أو تحويلها إلى ممارسة، مع الإشارة إلى أن الحالتين متداخلتان. (ينظر: كانط، 2012، ص 163) وحالة الطّبيعة القانونيّة تشتمل التّصور في أنَّ الكل في حرب ضد الكل، وحالة الطّبيعة الأخلاقيّة تشتمل التّصور في أنَّ هنالك معاداة متبادلة وعامة لمبادئ الفضيلة (كانط، 2012، ص 166-167). و”القانون الأخلاقيّ يتطلب العدالة، أعني السّعادة المتناسبة مع الفضيلة، والعناية الإلهيّة وحدها هي التي يمكنها أن تضمن ذلك (…) ويلزم أن تكون هناك حرية، بما أنه لن يكون هناك شيء من قبيل الفضيلة دون ذلك” (رسل، 2011، ص 279).
ويرى كانط أنَّ حالة الطّبيعة بمجملها بوصفها حالة سابقة على التّنظيم السّياسيّ، ليست حالة يعمها السّلام أو الوئام، بل هي حالة أقرب ما تكون الى حالة الحرب، أو أنَّها كانت دائمًا متضمنة تهديدًا بالحرب واستخدامها، لا بل إنّ للحرب دورًا مهمًّا في نشوء الدّول وتوزعها الجغرافيّ (كانط، B2007، صفحة 39)، وسنرى كيف أنَّ كانط يخرجنا من هاتين الحالتين في الوضع المدنيّ. ويتأسّس وفق ما سبق تصور كانط للدّولة المدنيّة بأنَّها دولة اجتماعيَّة تُنَظمها قوانين الحقّ، وتوجد وفق اتباعنا للمبادئ العقلانيّة الآتية:
1- مبدأ الحرية: وتشير هنا أنَّ كلَّ فرد في المجتمع إنَّما هو إنسانٌ قبل كلّ شيء.
2- مبدأ المساواة: وتشير إلى أنَّ كل فرد من أفراد المجتمع هو متساوٍ مع غيره باعتباره موضوعًا للقوانين وندًّا للآخرين.
3- مبدأ الاستقلال الذّاتيّ: ويعني أنَّ كل فرد بتحقق حريته ومساواته أمام الأفراد الآخرين يُعدُّ مواطنًا، مُعتمِدًا على نفسه، ومُقِّرًا بما يمتلكه من حرية، وما يعامل الآخرين به ويُعامَلون من منطلق المساواة (Kant، 1891، ص 35).
4- الشّخصيّة المدنيّة– القانونيّة: التي تُشير إلى أنَّهُ في أُمور الحق لا يجوز أن ينوب عن الفرد المواطن أي أحد غيره (بدوي، 1979، ص 95).
السّياسة والتّاريخ: جدل المثال والواقع
يعرض كانط تعاليمه السّياسيّة، إما بواسطة تصوّره عن القانون، أو تصوره عن فلسفة التّاريخ (هانسر، 2005، ص 176)، وفلسفة التّاريخ لدى كانط، هي فلسفة تقوم على حتميّة التقدم، ويقصد بها: رؤيته في وجود ضرورة تاريخيّة، تحكمها الطبيعة أو القدر أو العناية، وعلى الإنسان أن يتلاءم معها، من أجل تحقيق تقدمه، وبناء مجده (كانط، B2007، ص 37)، وتسعى فلسفته في التّاريخ، إلى التّغلب على الانفصال بين الأخلاق والسّياسة، وواجبها أن تشير إلى التّقدم نحو النّظام القانونيّ إذ إنَّه وسيلة ذلك الاِندماج المُرتقب بين السّياسة والأخلاق. (هانسر، 2005، ص186) وبذلك يؤمن كانط بمشروع للجنس البشريّ، يحققه الائتلاف مع الطبيعة، وهذا المشروع يتطلب أن تكون الإرادة الإنسانيّة العاقلة الواعيّة هي التي تشكله وتحققه وتنجزه. (مجموعة مؤلفين، 1987، ص 381).
ما سبق كان عن الشّطر الأول لتأسيس كانط للفلسفة السّياسيّة، وهو بُعد السّياسة في فلسفة التّاريخ، أمّا عن تأسيسه السّياسة على البُعد القانونيّ، فهو يقيم تأصيله الفلسفيّ للسّياسة على أساس الحق والقانون عبر جزئيته في العقل العمليّ، إذ تقر “فلسفة كانط السّياسيّة أنَّ العقل المستقل والقانونيّ، على أساس الحرية، يمثل مصدر الحق السّياسيّ، ومن جانب آخر تقوم محكمة العقل، ومن خلال اعتماد بعض قواعد التّفكير الصّحيح، بإخضاع الآراء والأفكار [السّياسيّة]، للتّمحيص والنّقد، وتسعى لتعريف المبادئ الأساسيّة للسّياسة” (المحمودي، 2007، ص 206). وللدّمج بين بُعد فلسفة التّاريخ في صنع السّياسيّ الخلوق، والبُعد القانونيّ للنّظريّة السّياسيّة، يقول كانط: “إنَّ الأخلاق بذاتها هي علم العمل بالمعنى الموضوعيّ لهذه الكلمة، من حيث اشتمالها على جملة من القوانين المطلقة، التي ينبغي أن نعمل بمقتضاها… إذن لا يمكن أن يقوم خلاف بين السّياسة من حيث هي علم العمل بالقانون، وبين الأخلاق من حيث علمه النّظريّ، فلا نزاع هنالك بين النّظر والعمل” (كانط، B2007، ص 49). ذلك يعني أنَّ الجانب النّظريّ يمثل الأخلاق والعمليّ هو السّياسة، وهما جانبان قانونيّان. ولذلك تعمل السّياسة من أجل ميثاق قانونيّ وجمع الإرادات، وبما أنَّ “الإرادة العامة، المعطاة أولًا، هي وحدها التي ترسم حدود الحقّ بين النّاس، ولكن هذا التّألف بين الإرادات جميعًا، ما دام متسقًا مع العمل وجاريًا على مقتضى آلية الطبيعة نفسها يمكن أن يكون في الوقت نفسه علّة تُحدث الأثر المطلوب، وتضمن تحقيق فكرة الحق والقانون فإنَّ مبادئ السّياسة الأخلاقيّة مثلًا أنَّ الشّعب يجب ألا يلتئم في نظام دولة، إلا وفقًا لمعاني الشّريعة عن الحرية والمساواة، وهذا المبدأ لا يقوم على الفطنة، بل على الواجب” (كانط، B2007، ص 56-57). وهذا الواجب الأخلاقيّ يفترض وجود قوانين تخرجه من وضعه الأصليّ. وهنا يتبين مدى إصراره على أن تتمحور الفلسفة السّياسيّة حول حرية الإنسان بوصفه كائنًا عاقلًا، وكيفية صيانة مثل هذه الحرية، وكذلك البحث في “قدرة الفرد على وضع قوانين أخلاقيّة وتطبيق هذه القوانين، وهذا يعني أنَّ كل واحد مساوٍ لكل واحد مبدئيًّا. وعلى الحقوق القانونيّة والمؤسسات السّياسيّة أن تستهدف حماية هذه الحرية وهذه المساواة” (سكيربك وغيلجي، 2012، ص 597). ولذلك يقرر كانط وصايا قانونيّة تكون منطلقات للفعل الإنسانيّ وأُصولًا للتّعايش السّلمي بين الأفراد والجماعات وهي:
1- كُن أمينًا: والأمانة القانونيّة المقصودة هي أن يؤكد الإنسان قيمته بالفعل مع الآخرين بأمانة، وذلك ما عبّر عنه بالقضية: “لا تجعل نفسك مُجرد وسيلة للآخرين، بل كُن في الوقت نفسه غاية لهم”، وهذا هو الحق اللازم عن الإنسانيّة في شخوصنا.
2- لا تُضرِّ بأحد: ويؤكد كانط أنَّ هذا الأمر واجب قانونيّ، حتى لو أدى إلى الانفصال عن كل العلاقات مع الآخرين، ولو قاد إلى الفرار من الجماعات الإنسانيّة.
3- شارك الآخرين بالاجتماع: وذلك إذا لم يكن في وسعك تجنب معاشرتهم، مع الاحتفاظ بكلّ ما ننتسب له من هويات أو معتقدات.
يقسم كانط القانون، بوصفه عِلمًا، إلى قانون طبيعيّ يقوم على مبادئ قَبليّة، وقانون وضعيّ يكون صادرًا عن المشرّعين. والقانون بوصفه ملكة إلزام الغير بالواجب إلى: فطريّ وآخر مكتسب، والأول هو قبل التّنظيم السّياسيّ والأخير بعده، والعلاقات القانونيّة لا تكون موجودة إلا بين الأشخاص، وهي إمّا أن تكون داخل مجتمع طبيعيّ، على أساس العلاقات النّاشئة عن كونهم كائنات حرة، أو في مجتمع مدنيّ، من خلال علاقات أفراده النّاشئة عن تأسيس الجماعة السّياسيّة، والأول يسمى قانون خاص والثّاني قانون عام. (بدوي، 1979، ص 31-32) وعلى ذلك نجد “أنَّ ميتافيزيقا الحق الكانطيّة، لم تكن مُجرد بناء نسقي لمبادئ الحق، والفعل السّياسيّ، والدّول، والحرية العموميّة، والحقوق وغيرها، بل كانت قبل ذلك تموضعًا داخل العقل السّياسيّ الغربيّ، وعودة إلى مبادئه، التي حاول أن يؤسس ذاته عليها، وقراءة عميقة لإشكالياته السّياسيّة… فقد شكَّلت لحظة بلغت فيها الحداثة السّياسيّة مستوًى من الوعي الفلسفيّ مكّنها من مراجعة تصوراتها عن الدّولة والحكم والسّلطة والحقوق البشريّة” (منصف، 2009، ص 83). وبذلك فإنَّ الحق الفطريّ الوحيد هو الحرية، وبالمقدار الذي يمكننا من أن نعيش مع الآخرين، هو حقٌّ مكفول للإنسان بما هو إنسان، أي بمقتضى إنسانيّته. ويشتمل هذا الحق على المساواة الفطريّة “الاستقلال الذاتي”، وهو أن يكون المرء ملزمًا، عن طريق غيره، بما يلزم الآخرين تجاهه، أي أن يكون عادلًا، والحقيقة أنَّه لا وجود للظلم قبل صدور أي مرسوم قانونيّ، لأنَّ أي فعل قبله لا يُعد ظالمًا، وما عدا الحرية هذه لا يوجد حق طبيعيّ “فطريّ” آخر، بل كل الحقوق الأخرى مكتسبة، لأنَّها نتيجة لعلاقات خارجيّة تقوم وفقًا لقوانين كليّة. (بدوي، 1979، ص33) وحق الحرية سيعوَّض بمكتسبات متفرعة منه في الحال المدنيّة.
– المجتمع المدنيّ ومكتسباته في إمكان التّعايش: سبق أن أشرنا الى حالتي الطبيعة القانونيّة والطبيعة الأخلاقيّة، ويرى كانط أنَّهُ في مقابلهما تكون الحالة المدنيّة القانونيّة والحالة المدنيّة الأخلاقيّة. ويُعرِّف الحالة المدنيّة القانونيّة بأنَّها: “علاقة البشر فيما بينهم، من جهة ما يوجدون على نحو جماعيّ تحت أحكام قانونيّة عموميّة، (وهي بكاملها أحكام قسريّة)” (كانط، 2012، ص163). والحالة المدنيّة الأخلاقيّة: هي “تلك التي يكونون فيها متحدين تحت قوانين خالية من الإكراه، بمعنى تحت قوانين الفضيلة بمجردها” (كانط، 2012، ص163)، وتعني أنَّ الوضع السّياسيّ يقتضي وجود قوانين قسريّة، ولا يمكن أن يركن الى الأخلاق بالمعنى القسريّ لأنَّها ضد مبدأ الحرية، فتبقى الأفعال الأخلاقيّة حرة حتى داخل التّنظيم السّياسيّ. وهذه القوانين هي سر التّعايش والسّلم. ولكن المشكلة هنا في قدرة القوانين على أن تكون مُلزمة أخلاقيًّا بحيث لا يمكن مخالفتها؟ “لأنَّ الإنسان رغم أنَّه قادر بعقله العمليّ على إدراك ضرورة القانون وعموميته، إلا أنَّ كلّ إنسان يميل مع ذلك إلى أن يستثني ذاته من الخضوع للقانون، وذلك من أجل إشباع رغباته” (مصدق، 2009، ص16) وهنا تبدأ الحاجة إلى الاجتماع والتّعايش، بعد إمكان النّزوع للحرب، واضحة للعيان حسب تصور كانط، فهي نتيجة وحيدة للخلاص إذا لم نرغب أن تهيمن علينا إراداتنا الخاصة، ورغباتنا التي يمكنها أن تدمرنا انطلاقًا من الذّات والفردانيّة الأنانيّة. وبما أنَّ هنالك حالًا مقابلة هي الطبيعة التي ذكرنا أنَّها بلا قانون أو سلطة أو إرادة كلية للاحتكام، فإنَّه حسب كانط، يجب الآتي:
“كل نوع من الكائنات العاقلة هو بالفعل مُحدد، من ناحية موضوعيّة، في فكرة العقل بغاية جماعيّة، نعني الارتقاء بالخير الأسمى بوصفه خيرًا جماعيًّا. ولكن لأنَّ الخير الأخلاقيّ الأسمى لا يتحقق من خلال سعي الشّخص المفرد نحو كماله الخلقيّ الخاص، بل يتطلب اتحادًا للأشخاص في كلٍّ واحدٍ من أجل الغاية نفسها، من أجل إقامة منظومة من النّاس ذوي النّيّات الحسنة … من حيث يشير [هذا الكل] إلى جمهوريّة كليّة بحسب قوانين الفضيلة” (كانط، 2012، ص 167).
يرفض كانط تصوّرات هوبز ولوك وروسو، في العقد الاجتماعيّ، عن حالة الأصل الطبيعيّ، لمسوّغات عديدة منها: أنَّ العقد يمنح حقوق الأفراد لغيرهم، بينما هي لهم فقط، ولذلك يرى أنَّ الحالة السّياسيّة أو المدنيّة هي: العلاقة بين أفراد شعب من الشّعوب، ومجموع الأفراد فيها إلى كلّ فرد آخر يُسمّى “دولة”، وتُسمّى الدولة ب “الشّأن العام” إذا نُظر إلى شكلها، من حيث إَنَّها تمثّل مصلحة مشتركة للجميع في إطار قانونيّ. وتُسمّى “القوّة” في حال علاقتها مع الشّعوب الأخرى، ويعرّف كانط الدولة بأنَّها: توحيد كثرة من الناس تحت قوانين شرعيّة، بحيث تكون هذه القوانين ضروريّة قبليّة، أي: صادرة طبيعيًّا عن مفهومات القانون الخارجيّ (أي الحرّيّة والمساواة والاستقلال القانونيّ) بوجه عام.
إنّ صاحب الحقّ في التّشريع هو الشّعب وحده، لأنّه “لا يمكن أن يَضُرَّ نفسه، بينما الفرد الواحد، حين يُشرِّع لغيره، قد يُضرّ بهذا الغير. ولا أحد يريد الأذى لنفسه، فالشّعب إذا شرّع لا يريد الأذى لنفسه” (كانط، 2012، ص 95).
ويربط كانط هذا المطلب بتأسيس الجماعة السّياسيّة الأخلاقيّة كما سبق، فينبغي “على كلّ الأفراد أن يكونوا خاضعين إلى تشريع عموميّ، وينبغي أن يكون من الممكن أن يُنظر إلى كلّ القوانين التي تربط بينهم باعتبارها أوامر ووصايا من مشرّع عام للجماعة. فإذا كانت الجماعة التي يُراد تأسيسها، جماعة حقوقيّة: فإنّ الجمهور ذاته الذي اتّحد في كلٍّ واحدٍ، هو الذي ينبغي أن يكون المشرّع لقوانين الدّستور” (كانط، 2012، ص 169). ولكن يجب أن نذكر أنّ تأسيس الجماعة القانونيّة المدنيّة لا يعني أن تكون هناك قوانين قَسريّةً على الجماعة الأخلاقيّة، لأنّ كانط يعتقد أنّ الجماعة الأخلاقيّة لا يمكن تصوّرها إلا بوصفها جماعة تحت أوامر إلهيّة، بمعنى كونها شعب اللّه الموافق لطبيعة الفضيلة. (كانط، 2012، ص 170). وحينما يشير كانط إلى الدولة وكيفيّة انعقاد وضعها بعد الحال المدنيّ، يعمل على تبرير مكتسباتها بعد الحال القانونيّة الوضعيّة، والمُكتسب الأشمل هو المواطنة، وتمتّع أعضاء المجتمع المدنيّ بالصفات القانونيّة. وبذلك، وانطلاقًا من الفلسفة الأخلاقيّة والسّياسيّة الكانطيّة، “تستوعب الحكومة المدنيّة القائمة على أساس التّصورات القبليّة للعقل العمليّ – أي الحرّيّة والمساواة والاستقلال – الأُناس والرعايا والمواطنين الذين يتمتّع كلّ فرد منهم ب: الحرّيّة في إطار القانون كإنسان، والمساواة أمام القانون كرعيّة، والتّقنين كمواطن” (المحمودي، 2007، ص 281).
ويظهر، وفق ما سبق، أنّ الحكومة المدنيّة لا يحقّ لها أن تتدخّل في سعادة الآخرين وأخلاقهم ودينهم، وإنّما منفّذة للقانون فقط، وهي حافظة للتّوازن والانسجام في المجتمع لأجل تأمين حرّيّات الأفراد فيه. لأنّ المواطن الجيّد ليس عليه أن يكون جيّدًا أخلاقيًّا، وإنّما أن يعيش وفق قوانين المجتمع. (المحمودي، 2007، ص 281). ومن خلال معرفتنا مدى قدرة الجماعة المتعاقدة لمصالحها بطرق أخلاقيّة شبه قبليّة أو استباقيّة في أن تكون مؤسّسة لنظام ديمقراطيّ قادر على الإجماع أو العمل وفق المشترك، يتّضح لنا نقده للأنظمة الاستبداديّة، وبذلك يرفض كانط تصوّر أفلاطون لحكم الفلاسفة.
ولذلك يقول: “لا رَجاء في أن يصبح الملوك فلاسفة أو الفلاسفة ملوكًا، وما ينبغي أن يكون ذلك مأمولًا، لأنّ ولاية السّلطة من شأنها أن تُفسد حكم العقل، وأن تقضي على حرّيّته قضاءً لا مردّ له. ولكن الملوك أو الشّعوب المالكة (التي تحكم نفسها طبقًا لقوانين المساواة) لا ترضى بأن تنقرض طبقة الفلاسفة أو أن تلتزم الصَّمت، فلا يُسمع لها صوت، بل تدع لها حرّيّة الجهر بآرائها والتّعبير عنها بصراحة، وهذا أمرٌ لا مناص للملوك ولا للشّعوب عنه؛ لأنّ فيه إبانة لشؤونهم وهداية لسبلهم” (كانط، B2007، ص 46–47). وذلك يعني أنّ مهمّة الفيلسوف هي المراقبة، والنّقد، والتّقييم، والتّقويم، وليس الحكم المباشر.
ويرى كانط أنّ هناك ثلاثة أشكال من أنظمة الحُكم هي: (بدوي، 1979، ص 123–124).
أوّلًا: النّظام الأوتوقراطيّ، وهو حكم الشخص الفرد.
ثانيًا: النّظام الأرستقراطيّ، وهو أن تكون السّلطة العليا بيد عدد قليل من المواطنين.
ثالثًا: النّظام الدّيمقراطيّ، وفيه يسود الجميع على الجميع، ويتمتّعون بحياتهم الكاملة، ويُعدّ الجمهوريّ واحدًا من أشكاله.
وهذه الأنظمة الثلاثة، إذا ما استدعت أن يكون الفرد، أو القلّة، أو الكثرة، أشخاصًا معيّنين، ولهم الحقّ في تصوّر أنفسهم سادة على غيرهم، ويصنعوا استبدادًا ما، فلا يمكن أن تكون أنظمة صالحة؛ لذلك فالحلّ هو النّظام الجمهوريّ، وهو الشكل المفضّل لدى كانط، فهو “الشكل العقليّ للدّولة… إذ هو الباقي وحده مهما تعاقب الأشخاص، ولا يتوقّف على شخص بعينه، بل يظلّ الغاية من كل قانون عام. ويتميّز النّظام الجمهوريّ بخاصّيّتين: الفصل بين السّلطات والتّمثيل النيابيّ. (بدوي، 1979، ص 124).
وتأكيدًا لما سبق نجد كانط يقول: “نستطيع إذًا أن نقرّر أنّه كلّما قلّ عدد الأشخاص المتولّين للسّلطة السّياسيّة (عدد الحكّام)، وكلّما عظم تمثيلهم، اقترب النّظام السّياسيّ من النّظام الجمهوريّ، وأصبح هناك أمل في أن يسمو إليه أخيرًا بإصلاحات متتابعة؛ فلهذا السّبب كان الوصول إلى ذلك النّظام التّشريعيّ، وهو وحده التّشريع الكامل، أصعب في الأرستقراطيّة منه في الملكيّة، أمّا في الدّيمقراطيّة فلا سبيل إلى بلوغه إلّا بثورة طاغية… ولكي يكون نظام الحكم مطابقًا لفكرة الحقّ، ينبغي أن يكون تمثيليًّا، لأنّ هذا النّظام وحده هو الذي يتيسّر أن تقوم في ظلّه حكومة جمهوريّة. (كانط، B2007، ص 29)، أي إنّ النّظام السّياسيّ، كلّما قلّ فيه عدد الحاكمين، وكَبُر تمثيلهم للشّعب، كان جمهوريًّا، بعد الأخذ بمبدأ فصل السّلطات.
ويستلزم فهم الفلسفة السّياسيّة عند كانط، فهم مبدأ إيثار الأغلبيّة “الذي يمكن به، عند الضّرورة، التّضحية بمصالح البعض من أجل مصالح الآخرين. وإذا كان لا بدّ أن تكون هناك أخلاق للحكومة، فغاية الحكومة تتحتم أن تكون واحدة، والغاية الوحيدة والفريدة المتوافقة مع العدالة هي خير الجماعة… فإذا فُسّر المبدأ على هذا النّحو، فيمكن اعتباره مُزوّدًا للدّيمقراطيّة بأساس أخلاقيّ. (رسل، 2011، ص 281). وذلك، ضِمنًا وصراحةً، تأييدٌ من كانط للنّظام الجمهوريّ وتفضيله، لأنّ تزويد الدّيمقراطيّة بالبعد الأخلاقيّ، القاضي باحترام الحرّيّة وفصل السّلطات، هو الذي يجعل الجمهوريّة متحقّقة.
– السّلام بوصفه غاية القانون الأخلاقيّ:
الإنسان بطبعه مدنيّ، وهو دائمًا عضو في مجتمع، وينبغي حسب كانط أن لا يكون هذا المجتمع همجيًّا أو على بداوته الأولى، ولذلك يجب أن يُنظِّم نفسه تنظيمًا يجعل كلّ فرد فيه قادرًا على ممارسة حرّيّته وتحقيق غاياته الأخلاقيّة، ومبادئ القانون والتّشريع هي الكفيلة بذلك التّنظيم. لكنّ الحرّيّة ستبقى مهدَّدة، مهما بلغ التنظيم مبلغه، لأنّ العالم ليس حكومة واحدة أو أُمّة واحدة، وبما أنّ بعض هذه الأمم ما زالت تستعمل الإكراه في العلاقات مع غيرها، فإنّ حال المجتمع المدنيّ، وديمومته، دائمًا ما يكون مُهدَّدًا، وعليه كانت قوانين الشّعوب ومعاهدات السّلام فَصلًا في تحديد استراتيجيات الأمن.
(مقدّمة عثمان أمين لكتاب: كانط، B2007، صفحة 11). ولذلك كلّه، نجد كانط يُقدّم مشروعًا بالضدّ من فكرة الحرب، أسماه “مشروع السّلام الدّائم”، فهو يعتقد أنّنا، إذا تماشينا وفقًا لمعطيات ومقتضيات العقل، يجب أن ندين الحرب إدانةً تامّةً، ولا يمكن أن نمنع الحرب إلّا بحكومة دوليّة فقط. وبهذا فهو يدعو إلى قيام اتحاد عالميّ، يضمّ دولًا حرّةً، ويربط بينها ميثاق ينصّ على تحريم الحرب. (كانط، B2007، ص 29). وينص مشروع كانط للسّلام الدّائم على عدة فقرات منها:
الفقرات السّلبيّة التي يجب سلبها عن فحوى المشروع، وهي: (كانط، B2007، ص19-20)
1. لا تُعدُّ أيّة معاهدة من معاهدات السّلام إذا انطوت نيّة عاقديها على إثارة الحرب من جديد.
2. لا يجوز تَملُّك دولة لدولة أُخرى، صغيرة كانت أم كبيرة، سواء عن طريقة الميراث، أو التّبادل، أو الشّراء، أو الهبة.
3. إلغاء الجيوش الدّائمة على مر الزّمان، لأنَّها تهدد السّلام الدّائم.
4. لا تُمنح قروضٌ وطنيّة من أجل منازعات خارجيّة – دوليّة، لأنَّها ستؤدي إلى تيسير أُمور الحرب وكذلك إلى الإفلاس.
5. لا يجوز لأيّة دولة أن تتدخّل بالقوة في نظام دولة أُخرى أو في حكومتها.
6. لا يسمح لأيّة دولة في حرب مع أُخرى أن ترتكب أعمالًا عدائيّة من شأنها امتناع الثقة المتبادلة بين الدّولتين، عند عودة السّلام بينهم، لأنَّنا يجب ألا ننسى أنَّ هدف الحرب يجب أن يكون إقامة السّلم.
أما الفقرات الإيجابيّة التي يجب توافرها في مشروع السّلام الدّائم، فهي: (كانط، B2007، ص26-33)
1. يجب أن يكون الدّستور المدنيّ لكل دولة دستورًا جمهوريًّا، بمعنى أنَّ من يقرّر الحرب هو السّلطة التّشريعيّة التي تمثل الشّعب، وهذا النوع من الحكومات أنسبها لمبدأ الحرّية والمساواة، وهو أيضًا أنسب لاستتباب السّلام.
2. يجب أن يقوم قانون الشّعوب، أو القانون الدّوليّ العام، على التّحالف بين دول حرّة، والمقصود منه جمع شمل الدّول الحرّة في تحالفٍ سلميّ.
3. يجب أن يكون حقّ النّزيل الأجنبيّ، من حيث التّشريع العالميّ، مقصورًا على إكرام مثواه. هذه هي شروط “السّلام الدّائم”، السّلبيّة منها والإيجابيّة، ويمكن أن نجد من الشّواهد التّاريخيّة ما يؤيد أو يبرهن على إمكانيّة مشروع السّلام الدّائم، أو الإشارة إلى الحلف السّلميّ الدّوليّ، وفي ذلك تنظيم وتهذيب لسلوك الأفراد والجماعات، لعله يوتوبيا التّصور، وإن كان كانط يحرص دومًا على أن يكون الفيلسوف هو من يقوم على مثل هذا التّهذيب والتّرشيد للمواطن، وذلك بالاستعمال العموميّ لعقله، مثلما يشّرع لذلك في مقاله (ما هي الأنوار؟) وهو ضرب من التّدبير لفضاء المواطنة الحديث” (بنشيخة، 2006، ص 197).
وإذا ما راجعنا كل الخُطاطة الكانطيّة في تأسيس الإتيقا السّياسية، إن صحت التّسميّة، فإنَّنا نجد قول كانط الآتي يلمّ مختلف قسماتها، إذ يعتقد أنَّ “الشّرط الصّوريّ الذي تحته وحده تستطيع الطبيعة أن تبلغ هدفها النهائيّ، هذا هو: أنَّ الدّستور الذي يُنظم علاقات الكائنات الإنسانيّة ببعضها والذي تقابل فيه السّلطة القانونيّة في الكلّ سوء الحريات التي تصطرع مع بعضها، يسمى بالمجتمع المدنيّ… يظل من الضروريّ وجود كلية منفتحة كونيًّا، أي منظومة من جميع الدّول التي تجازف بالتّأثير على بعضها إراديًّا. وفي غيابه … يصبح لا مناص من الحرب” (كانط، 2009، ص373). وهنا تتبيّن آفاق التّنظيم المسبق واللاحق للتّعاقد الأخلاقيّ- السّياسيّ وغايته المنشودة عبر الوضع المدنيّ (المحليّ والعالميّ- الكونيّ) متضمنًا في ثناياه كل سبل البحث عن الشّراكة ودروب التّضامن، وتحقيق السّلم، وهذا سيكون المحرك الأساس لِنفتح باب البحث فيما قدمه رولز في الشّروط القبليّة للتّعاقد كذلك وفي فهم كيفية سير العمل التّضامنيّ في التّشريعات ومن ثمّ كيف يمكن تحويل ذلك إلى خطاب كونيّ قد يُعيد الحضور الكانطيّ ويجعله راهنًا دومًا.
كانط راهنًا
كيف يمكن استحضار كانط بنوعية المثال والمقال في عالمٍ عربيّ لا يزال يترنَّح فلسفيًّا، ولعله لا يُقيم للفلسفة اعتبارًا كافيًا أو معقولًا بوصف مقولها قادرًا على التغيير أو التَّحرر أو العلاج والتَّشافي؟!
هذا إشكال يُخالج كلَّ تفكُّر أو تأمُّل فِي الأهوال والأحوال العربيّة، ولعلَّ مثاليات كانط وفرادته فِي مَنظومتهِ الأخلاقيّة هي المدخل التّسويغيّ لإمكان راهنيته؛ فالنظريّة الإسلاميّة، في أدبيتها، تكتنز ما يمكن أن يكون مُشتركًا بكمٍّ كبير مع أخلاقيات الواجب، والنّزوع نحو القانون العالميّ، والعمل على قاعدة العموميّة الخطابيّة فِي النَّصِّ الدّينيّ (يا أيّها النّاس) التي جاءت ملازمة لكثير من التوجيهات والتّشريعات الإسلاميّة. وهذا المُستوى النَّظريّ لا يمكن أن يكون هو الملتقى الوحيد! فيمكن للتطبيقات التَّاريخيّة أن تُعيد للأذهان تجارب حُكم فِي العَالم العربيّ، فِي الخلافات الإسلاميّة، استطاعت أن تُؤسس لبعض الحواضن السُّلوكيّة والفكريّة الّتي يُمكنها أن تضمن التَّعايش والسّلم، وهذا الأمر لا يعني أنَّ التَّاريخ العربيّ- الإسلاميّ مليء بهذه التّجارب، فهي قليلة، إن لم نقل فريدة، وعليه فمحاولة استعادة الخِطاب الكانطيّ تبقى مِن الصُّعوبة أن نُسلّم بإمكانها، ولكن ذلك لا يعني استحالتها.
العالم العربيّ اليوم، بما يمرّ به من أزمات سياسيّة، لا يزال حبيس قضية تأسيس الدَّولة، فالدُّول العربيّة، إلى الآن لا تستطيع أن تدّعي إمكانية تأسيسها بنوع من الاستقلال، ولا حتى ممارستها للحكم! فمشكلة الاستقلال والتأسيس ونوع النظام السّياسيّ العقلانيّ، هي مشكلات واقعية يمكننا أن نُعيد إنتاجها نظريًّا مع كانط:
1- مشكلة تأسيس الدولة والتعاقد الكانطي، وفيها نستطيع أن نقول إنّ حل مشكلة اختيار النظام يمكن أن يتماشى مع خيار كانط في أنّ حقوق الأفراد لهم، وهم من يقررون مصيرهم. وهذا يقودنا إلى مسألة لا تزال إلى اليوم موضوع شد وجذب، وهي قضية تقرير المصير للشعوب بمعزل عن إرادات الدُّول الكُبرى.
2- مشكلة النّظام الإصلاحيّ والخيار الكانطي، وفيها يمكن أن نستحضر كانط في جمهوريّة تفصل بين سلطاتها، وتحث على الابتعاد عن الاستبداد، لأنه خيار غير عقلاني.
3- مسألة التعايش والسّلم الكانطي، وفيه يجب أن يُرغم العقل العربيّ نفسه على أن التعدّد هو سمة البشرية، وأن النمط الأوحد هو خطاب إرهابي لا يمكن أن يُديم وجود المجتمعات، ولا يُقبل بتأسيس الدول، ولا ينتج بيئة لنظام سياسي عقلاني ديمقراطي، وعليه فالسلام المجتمعي هو المقدمة الضرورية للانتقال إلى سلم عالمي، وإن كان محدودًا.
الخاتمة
كان لكانط الفضل في التأسيس الخُلقيّ السابق لفلسفة الممارسة، كما له الفضل في إنجاز صورة تعاقديّة لما بين الشُّعوب والمجتمعات مِن حُلم التَّضامن والعيش بأمان، إلا أنَّ هذه التصورات، بمثاليتها وتجريدها الكبير، لم تستطع رؤية النور في واقع الممارسة السياسية والمجتمعية، واليوم نحن أمام مُنجز نظريّ كبير، يحاول استعادة الهموم الكانطية، ويعمل على تجاوز استحالة تحقيق غاياتها، وذلك ما قدمه جون رولز، وعلى الرغم من قدرته التنظيرية العالية إلا أننا نجده لم يزحزح حجر المثالية من تعاقدات الوضع الأصلي إلى السلام بين الشعوب وداخلها.
ولأجل ذلك بقي حبيس مثاليات أخرى، أحكمت الإغلاق على المشروع برمته، وكأنه لا يستطيع مُغادرة الطُّموح، وما ينبغي أن يكون، دون ما هو كائن. إنَّ كل كلام في إلزامٍ مُسبق يجب أن يكون شرطًا واقعيًّا، وخلاف ذلك فهو محض افتراض، أقصد: ما يُراد منه أن يؤسس للواقع، يلزم أن ينطلق من فهم الواقع، ومن الحركة في حدوده، لأنّنا لا يمكن أن ننسج خيالًا من الإجراءات اللاواقعيّة من أجل إتمام المخيال الأول، فالعيش المشترك والسّلم المجتمعيّ، بقدر ما يمثلان كونهما مَهام نبيلة، ومساعيَ إنسانيّة عالية الشّرفيّة، إلا أنَّ واقع العالم اليوم قلّما يمكنه أن يديم لحظات هذا المطلب حين تحققه، فكيف بأصل التحقق!
إنَّ السّلم المجتمعيّ في عالم تنخره الأصوليات الإرهابيّة المتطرفة، يُعد مطلبًا صعب المنال، إن لم يكن مستحيلًا، وإذا قلنا بصعوبته، فإنَّ سبل تحقيقه ستكون أبعد ما يمكن عن التّصورات الواجبيّة، والتّعاقديّة الشَّرطيّة، في حال مثاليّ، بل يلزمها أن تنطلق من شروط معياريّة، تراعي واقع العنف، والتّعدد، والاختلاف، والصّراعات الطبقيّة، والأحوال والأهوال المجتمعيّة.
:قائمة المصادر والمراجع
- إسماعيل مصدق، (2009): المهمة التّاريخيّة للفلسفة النّقديّة. تأليف مجموعة مؤلفين، التأصيل النقديّ للحداثة: قراءة في الفلسفة الكانطيّة. الرباط: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية.
- أم الزين بنشيخة، (2006): كانط راهنًا: أو الإنسان في حدود مجرد العقل. بيروت: المركز الثقافي العربي.
- إندرو فينسينت، (2017): الأيديولوجيات السّياسيّة الحديثة (المجلد 1)، ترجمة: خليل كلفت، القاهرة، المركز القومي للترجمة.
- إيمانويل كانط، (2007A): نقد العقل العلميّ، ترجمة: غانم هنا، بيروت، المنظمة العربيّة للترجمة.
- إيمانويل كانط، (2009): نقد ملكة الحكم، ترجمة: سعيد الغانمي، بيروت، منشورات الجمل.
- إيمانويل كانط، (2012): الدّين في حدود مجرد العقل، ترجمة: فتحي المسكيني، بيروت، دار جداول.
- إيمانويل كانط، (2007B): مشروع للسلام الدائم، ترجمة عثمان أمين، بيروت: دار المدى للثقافة والنشر.
- برتراند رسل، (2011): تاريخ الفلسفة الغربيّة، الكتاب الثالث: الفلسفة الحديثة، ترجمة: محمد فتحي الشنيطي، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- بيير هانسر، (2005): عمانوئيل كانط، تأليف مجموعة مؤلفين، تحرير: ليو شتراوس، وجوزيف كروسبي، تاريخ الفلسفة السّياسيّة، ترجمة محمود سيد أحمد، القاهرة: المركز القوميّ للترجمة.
- جاكلين روز، (2002): الفكر الأخلاقيّ المعاصر ترجمة: عادل العوا. بيروت: عويدات للنشر والطباعة.
- . ديفيد جونستون، (2012): مختصر تاريخ العدالة، ترجمة: مصطفى ناصر، الكويت: المجلس الوطنيّ للثقافة والفنون والآداب.
- عبد الحق منصف، (2009): ميتافيزيقا الحق والتّأصيل السّياسيّ داخل الحداثة، تأليف مجموعة مؤلفين، التأصيل النّقدي للحداثة وما بعدها: قراءة في الفلسفة الكانطيّة، الرباط، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية.
- عبد الرحمن بدوي، (1979): إيمانويل كانط: فلسفة القانون والسّياسة، الكويت، وكالة المطبوعات.
- علي المحمودي، (2007): فلسفة كانط السّياسيّة: الفكر السّياسيّ في حقلي الفلسفة النّظرية وفلسفة الأخلاق، ترجمة عبد الرحيم العلوي، بيروت، دار الهادي.
- غنار سكيربك، ونِلز غيلجي، (2012): تاريخ الفكر الغربيّ من اليونان القديمة إلى القرن العشرين، ترجمة: حيدر حاج إسماعيل، بيروت، المنظمة العربية للترجمة.
- مجموعة مؤلفين، (1987): تاريخ الفكر السّياسيّ (المجلد1)، تحرير: جان توشار وآخرون، ترجمة: علي مقلد، بيروت، الدار العالميّة للطباعة والنشر.
- Kant (1891): Kant’s principles of politics. Hastie W، London: T&T Clarck.
الأستاذ الدكتور علي عبود المحمداوي
أستاذ الفلسفة المُعاصرة والسّياسيّة في جامعة بغداد، العراق. له العديد من المؤلفات والأبحاث التي عالجت، في معظمها، قضايا الحداثة، والديمقراطية، والنظرية السيّاسية، وقضايا الثورة، والعنف، والإرهاب الفكري، وغيرها من إشكاليات الفلسفة المعاصرة. شغل منصب رئيس قسم الفلسفة من 2015 -2016 في جامعة بغداد. عضو الهيئة الاستشارية الفلسفية في بيت الحكمة – بغداد. عضو ومدير أكاديميّة: (International Marlinskaya Academy) في موسكو- روسيا. عضو في تحكيم عدة مجلات فلسفية وعلمية في عدة جامعات عربيّة. حصل عام 2014 على جائزة الإبداع من وزارة الثقافة العراقيّة، وعلى جائزة يوم العلم من وزارة التّعليم العاليّ لعام 2019.